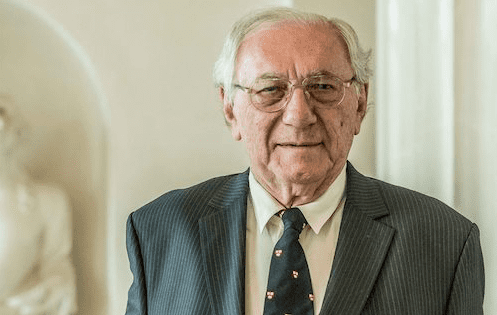وطالما نحن في أجواء حزيران، والهزيمة المروّعة التي لم تندمل جراحها بعد، فلنقل إن مشروع “النقد الذاتي بعد الهزيمة”، الذي أطلقه الراحل الكبير صادق جلال العظم، وكان لقسطنطين زريق شرف ريادته في “معنى النكبة“، يكتسب اليوم واقعية، وراهنية، وأهمية، وضرورة أكثر مما كان عليه الحال بعد هزيمتي 1967 و1948.
يجد هذا ما يبرره في سلسلة الهزائم التي لم تتوقف بعد، بل وتبدو نكبات الحاضر أكثر إيلاماً، وأشد فداحة، من هزائم سبقت، وتخيّلنا في حينها أن لا شيء يوازيها إيلاماً وفداحة. لذا، ما يرد في هذه المقالة، ومقالات لاحقة، من تأملات يندرج في الإطار العريض لمشروع “النقد الذاتي بعد الهزيمة”.

ولنقل، أيضاً، إن “معنى النكبة” و”النقد الذاتي بعد الهزيمة” انطلقا من فرضية رفض الهزيمة أولاً، والبحث عن، وتشخيص، مُسبباتها الذاتية ثانياً، واقتراح حلول عملية للرد عليها ثالثاً.
ولسنا، هنا، بصدد رصد التشخيص بل التذكير بأمرين:
الأوّل، لم تكن الثقافة التقليدية (وما يندرج بتعبيرات تلك الأيام، وهذه الأيام، في قائمة العادات والتقاليد، وقيم وأخلاق “مجتمعنا”)، ولا النظم السياسية السائدة، وعقودها الاجتماعية، جزءاً من مشروع للحل، أو خارطة للطريق. والثاني، أن اليمين الديني والوطنيات المحلية المحافظة في الحواضر، إضافة إلى يمين كل شيء الصحراوي (وهذا حالة فريدة في علم الاجتماع السياسي)، لم ير في تشخيص زريق والعظم خارطة طريق للمستقبل، بل رأى فيه ما يُقوّض سلطته، ودعاماته الأيديولوجية، وعلاقاته السياسية.
والشاهد: مُورس نوعان من النقد على مدار سبعة عقود مضت. تجلى الأوّل في دعوة للقتال بتأويلات ماركسية، وقومية راديكالية، للسياسة والمجتمع، بل وحتى في محاولة لمحاكاة لاهوت التحرير الكاثوليكي في أميركا اللاتينية، على طريقة حسن حنفي في “اليسار الإسلامي”)، هذا في الحواضر، خاصة في ما عرف في وقت مضى ببلدان الطوق، أو المواجهة، التي تشمل البلاد الشامية، والمصرية والعراقية.
أما النوع الثاني من النقد فتجلى في قناعة بأن الهزائم تنجم عن التغريب، والعلمنة، والغزو الثقافي، والابتعاد عن الدين والثقافة التقليدية (يعني الروافع الأيديولوجية لمشروع الأسلمة) ناهيك عن استحالة مجابهة الغرب، وتصديق خرافة قوّة ونفوذ اليهود في العالم. وهذا ما جسّدته سياسات دفاعية، تحوّلت إلى هجومية وذات نتائج كارثية، للتعاون مع الغرب (وإسرائيل، إن استدعى الأمر) في دحر موجة القومية الراديكالية، واليساريين العرب والفلسطينيين.
وفي كل لأحوال، تناسبَ الانتقال من الدفاع والاحتواء إلى الاختراق، والهجوم، واللعب على المكشوف، كما يحدث الآن، مع تقييم صحيح ودقيق للقوّة الذاتية، ومدى قوّة الخصوم في المراكز الحضرية والحضارية.
ولا مبرر، بالتأكيد، لتسويق، أو ابتلاع، وهم أن القوميين الراديكاليين واليساريين العرب والفلسطينيين، الذين استجابوا لمشروع الكفاح في خارطة الطريق الأولى، كانوا (تنظيمات وأنظمة) قادرين على ترجمة المشروع بطريقة عملية وناجحة، فقد ارتكبوا الفادح من الأخطاء والخطايا، وأسفرت محاولاتهم المُكلفة، والمُشبعة بالدماء والدموع، عن كوابيس مُفزعة، وإخفاقات مروّعة، كما في الحالات العراقية والسورية، واللبنانية، والفلسطينية، وعن كساد وغيبوبة في الحاضرة المصرية.
وإذا نزعنا عن هؤلاء كل ادعاء بالبراءة، ومزاعم سوء الحظ، عن حسن النيّة حيناً، ومؤامرات ودهاء الأعداء في حين آخر، فمن الهبل إعفاء اليمين الديني، ويمين كل شيء الصحراوي، من مسؤولية التآمر عليهم، وتسديد ضربات تحت الحزام، كلما سنحت الفرصة.
ولكن، لماذا نعيد التذكير بهذا الكلام في أجواء حزيران؟
لأن القوى (تنظيمات وأنظمة ومجتمعات وسياسات وأيديولوجيات) التي استجابت لمشروع الكفاح (كما شخّصه زريق والعظم) تكبدت هزيمة ساحقة. ولأن الوطنيات المحلية الانعزالية والمحافظة، واليمين الديني الحضري، والصحراوي (أنظمة وسياسات وأيديولوجيات وميليشيات) أي أصحاب وورثة خارطة الطريق المضادة لمشروع الكفاح، في معسكر المنتصرين الآن، ولأن النقد والنقد الذاتي على طريق استعادة مشروع الرد على الهزيمة، وخارطة الطريق الأولى، هما الآن، وأكثر من أي وقت مضى، خشبة الخلاص وما يلوح من ضوء في آخر ليل الحواضر الطويل.
ولكي لا يجهلن أحد على أحد: كانت هزيمة الحواضر بنيوية، والرد عليها، بلغة اليوم، لا يعني تجييش الجيوش، وخوض مجازفات ومغامرات دفاعاً عن الفلسطينيين، ولا يعني بالنسبة للفلسطينيين الانتحار الذاتي (كما يحدث الآن)، بل يعني إعادة الاعتبار إلى القيم، التي في غيابها ما يفسّر الهزيمة، ويجسّد معنى انهيار الحواضر من ناحية، وفي حضورها ما يثير ذعر “الوطنيات المحلية الانعزالية والمحافظة واليمين الديني ويمين كل شيء الصحراوي”، من ناحية ثانية.
أستخدم تعبيرات من نوع الوطنيات المحلية الانعزالية، واليمين الديني والصحراوي، وأعرف أنها لا تفي بالغرض، فالواقع يشهد تحالفات بين حكّام مراكز حضرية انهارت، وتمثيلات دولانية ودفيئات سياسية ومالية وأيديولوجية ليمين كل شيء في الهوامش الصحراوية، إضافة إلى نخب مالية حضرية وصحراوية وإسرائيلية وغربية معولمة. هذه خلطة متعددة الرؤوس، والأقنعة، وربما جازت تسمية كل هؤلاء بالإبراهيميين.
تتضح، بهذا المعنى، دلالة ألا نفرّط بقيم العلمانية، والديمقراطية، والدستور، والتعددية الحزبية والسياسية، والفصل بين السلطات، والانتخابات، وحرية الرأي والتعبير، والتداول السلمي للسلطة، وحقوق الإنسان، وقضايا النساء، كما نصّت عليها وثائق الأمم المتحدة. فهذه كلها من أولويات وأدوات النقد والنقد الذاتي وعدته.
وبهذا نستعيد عبارة سمعها جبرا إبراهيم جبرا من توينبي: قدركم أيها الفلسطينيون نشر العلم والمعرفة، في العالم العربي، كما فعل علماء القسطنطينية في الغرب، بعد سقوط بيزنطة. و”ربما فيه نجاتكم، أو حتفكم”.
في الرد على الهزيمة بالكفاح، أي بكل ما ذكرنا من قيم، لا بالاستسلام للإبراهيميين، يتجلى قدر الفلسطينيين.