رغم قلة النعاس، فإنّ نشاطًا عجيبًا دب في أوصالي. اتجهت مباشرة نحو الحمام. خلعت الروب والبيجاما، ووقفت في ألبستي الداخلية أحلقُ ذقني أمام الحوض، وشعري الأبيض ـ أو ما تبقى منه ـ منكوش بفعل نومتي المضطربة، ووجدتني أغني لأم كلثوم:
“تفيد بإيه يا زمن وتعمل إيه يا عذاب”
تحممت بعدها، ثم ارتديت ملابسي. وفي عجلة، شربت كوب شاي، وازدردت كسرة خبز، مدهون بالجبن الأبيض. خلال أقل من نصف ساعة كنت أجلس داخل سيارة أجرة متجهًا نحو بيت أمير.
كأن الزمن قد توقف، وجدت عم محمود جالسًا يتفحص الجريدة فوق المصطبة الخشبية، تمامًا كما عهدته يوم جئت لزيارة أمير فهيم كيرياكوس للمرة الأولى قبل خمس سنوات. ألقيت عليه التحية:
“سلام عليك يا عم محمود! الأستاذ أمير فهيم موجود؟”
فتطلع العجوز الأسمر نحوي متسائلًا، وقد زادت السنوات الخمس من بياض شعره الخشن. لم يبد كأنه تعرف عليَّ، ولكنّ نظرة عينيه الرماديتين أبدت تعجبه من أني ناديته باسمه. في صعوبة وقف مستندًا بمرفقيه إلى فخذيه، ثم قال بلكنته النوبية المعهودة:
“خير يا سعادة البك، من تكون حضرتك، وماذا تبغي من أمير بك؟”
أجبته مسرعًا، مستنكرًا أن يكون نسيني كلّية خلال تلك السنوات الوجيزة:
“ألا تتذكرني أيها العجوز؟ أنا عاطف عزيز.. كنت أزور أمير بانتظام وقت اندلاع الثورة.”
“أي ثورة؟”
“ما بالك يا عم محمود؟ ثورة يناير طبعًا!”
“نعم.. نعم.. ثورة يناير.. عفوًا، فمن هم في مثل سني ينسون مثل هذه الأشياء..”
تفكرت في أن تكون إجابته مشحونة بمعان مستترة، أو تلميحات بفشل الثورة عن تحقيق جل أهدافها. ولكني نحّيت تلك الفكرة جانبًا، إذ يبدو أنّ الشيخ قد أصابه فعلًا خرف الشيخوخة، فلم يعد يتذكر أي شيء. فعدت وسألته بحزم:
“هل تعلم إن كان أمير موجودًا؟”
“عفوًا يا سعادة البك، من قلت إنك تكون بالنسبة إليه؟”
“أنا.. اعتبرني صديقًا للعائلة..”
“أي عائلة؟ فأمير بك يعيش بمفرده. رحلت أمه، ثم مات أبوه الأستاذ فهيم كيرياكوس، ولم يبق سواه!”
“أعلم ذلك يا عم محمود.. أنا صديق خاله الدكتور رمزي!”
“أنا لا أعرف أحدًا يدعى الدكتور رمزي!!”
قالها باقتطاع وقد عقد ساعديه فوق صدره. بدأت أشعر بالضيق، إذ دام النقاش أطول مما توقعت. فقلت له وقد بدأ صبري ينفد:
“أصبت يا عم محمود، والحق معك. الدكتور رمزي ـ خال أمير ـ هاجر بالفعل إلى أمريكا منذ زمن بعيد. هل تود أن ترافقني الآن إلى شقة أمير، أم أصعد بفردي؟”
لم يجد الشيخ بدًا من أن يترك جريدته فوق المقعد الخشبي، ثم يهم ويتقدمني إلى داخل البناية متأففًا. فتح باب المصعد، وضغط زر الدور الثالث حيث شقة أمير.
فتح أمير باب الشقة، فإذا برجل آخر يطالعنا؛ مختلفًا تمامًا عن أمير كيرياكوس الذي فتح الباب ذاته قبل نحو خمس سنوات. كان حليق الذقن، مصفف الشعر، وإن كان قد صار أكثر سمنة عما كان عليه. في طرفة عين، مد يده مصافحًا، فانفرجت أسارير عم محمود أخيرًا، إذ أدرك أن أمير يعرفني. انصرف عم محمود نازلًا بالمصعد إلى الدور الأرضي من جديد.
لم تصدر رائحة كريهة من داخل الشقة هذه المرَّة، مما شجعني على الدخول.
لم أجد أثرًا للحمَام، ولا لأوراق الجرائد تغطي الأرضية، بل حتى اللوحات الزيتية، وجدتها معلقة فوق جدران الصالة وحجرة الطعام المفتوحة عليها.
ألحَّت عليَّ فكرة جهنمية؛ أن يكون أمير قد شفي من مرضه، لأبدأ أنا رحلتي مع عالم الخيالات والأوهام، من بعد ما حدث لي ليلة أمس.
كان أمير يرتدي قميصًا وسروالًا، وكأنه يستعد للخروج. لذا تعجبت حينما سألني إن كنت أريد أن أحسو شايًا أو قهوة.
“كنتَ متوقعًا مجيئي، أليس كذلك؟”
“بكل تأكيد.”
“وهل تعرف كيف تعدّ فنجان القهوة يا أمير؟”
“لا.. ولكني كنت أسألك عن القهوة (النسكافيه).”
“وهل يشرب مثلي (نسكافيه)؟ أفَضّل شايًا.. أم تؤثر أن ننزل فننحو إلى أحد المقاهي، كما كنا نفعل قبل سنوات؟”
“حسنٌ.. ذلك أرجح إذن.”
وفي لمحة عين أيضا، وضع معطفًا أنيقًا فوق قميصه، ثم اتجهنا خارجين. وجدنا عم محمود جالسًا فوق مصطبته الخشبية، يتفحص جريدته، فألقيت عليه التحية من جديد، ولكنّ ردة فعله المقتضبة أوحت بأنه نسي من أكون مرة أخرى، أو أنه لم يتذكر شيئًا عنِّي من الأصل.
في الطريق، علمت من أمير أنّ خاله الدكتور رمزي حضر إلى الإسكندرية قبل نحو عام، بعد أن ساءت أحوال أمير الصحية. اعترف لي بأنه أُجبر على دخول مصحة نفسية بالقاهرة، وإن كان العلاج الذي تلقاه بها قد أتى بالفعل بأفضل الثمار. تعجبت من أن رمزي لم يعلمني بأمر مجيئه، بل ولم يسع إلى لقائي أثناء وجوده في الإسكندرية، على غير عادته. لكنني لم أشارك أمير تلك الأفكار بالطبع.
سألته عن “رينا”، فالتفت نحوي بهدوء وقال:
“أنا أعلم أن ’رينا‘ خيال، وهمٌ يخترعه عقلي الباطن، يا أستاذ عاطف. أتفهّم الآن أعراض مرضي، وأتعاطى الدواء بانتظام لذلك أستطيع أن أحيا في سلام. تعلمت أيضًا أن أتجنب الأفكار الهدامة التي كانت تلاحقني باستمرار. ولكن رينا ما تزال تظهر لي، نعم، وأنا بدوري تعودت أن أتجاهل مجيئَها. لست أستبعد أن تظهر لي الآن بينما نتحدث. ولكن اطمئن يا أستاذ عاطف، سوف أتركها وشأنها. الأمر برمته تحت السيطرة.”
كان يتكلم ببطء وتأن، ويحرص ألا تظهر عاطفة ما في ما كان يتفوه به، كأن كلامه شريط مسجل، يصدر من ماكينة إجابة المكالمات الآلية. لم يبادلني النظرات إلى الآن، بينما جلسنا نحتسي مشروبين ساخنين بمقهى في ميدان كليوباترا، والمارة يعجّون في الطريق، والسيارات والحافلات تمر وتملأ الجو صخبًا وضجيجًا.
ثم نظر أمير نحوي فجأة، وعاد البريق يطل من عينيه. ذكّرني بسالف ما كان عليه يومًا، قبل نحو خمس سنوات، وهو يقص عليَّ حكايته، التي تبينت بعدها أنه اختلق معظمها. بل أدار جسمه بكليّته فصار يواجهني تمامًا، ثم قال:
“هل تعرف فولتير، يا أستاذ عاطف؟”
“الكاتب الفرنسي؟ نعم أسمع به.”
“إذن فلا بد أن تعرف كَانديد؟”
تفكرت للحظات وأنا أهرش شعيرات رأسي القليلات الباقية، ثم قلت:
“كانديد؟.. لا.. انتظر قليلًا.. أليس؟.. ألم يؤلف فولتير رواية بالاسم نفسه؟”
تحمّس أمير، ومال بجذعه فوق الطاولة بيننا، وخبط بكفه فوقها وهو يهتف:
“نعم.. نعم! رواية ’كانديد‘؛ أهم ما كتب فولتير!”
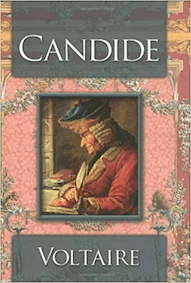
احتسيت آخر رشفة من فنجان القهوة، ثم ابتسمت وسألته:
“أهذا كل ما أردت أن تحدثني بشأنه؟ هل اتصلت بي بالأمس لتدعوني إلى هنا، لكي تختبر معلوماتي الثقافية يا أمير يا ابني؟”
“بالطبع لا، يا أستاذ عاطف.. لست أدري كيف أقول لك هذا؟.. كيف أصارحك؟”
سكت أمير بضعة لحظات، ثم قال بجدية، وقد صوب نظراته نحوي، وكأنه يفضي إلي بسر خطير:
“يجب أن تصحبني في مهمة خطيرة يا أستاذ عاطف؛ ينبغي أن نعثر على ’كانديد‘ سويًا! أنا متأكد أنني لن أستطيع أن أجده بمفردي..”
قال هذا وأطرق، ثم مال رأسه أمامه في يأس.
رفعتُ يدي مستدعيًا النادل، وطلبت فنجان قهوة آخر. ترددتُ برهة قبل أن أعقب على كلمات أمير. أنا لا أريد أن أجرح مشاعره بكل تأكيد، كما أني لا أريد أن أستثير غضبه، فهو مريض ولست أعلم كيف ستكون ردة فعله لو أني سخرت من كلامه. وعلى الجانب الآخر، فها أنا قد وقعت في الشرك قبلًا، ولن أقبل أن يخدعني من جديد. لذلك كنت حريصًا جدًا حين انتقيت كلماتي وأنا أجيبه:
“أنت تدرك بالطبع، أنّ فولتير كتب ما كتب في القرن الثامن عشر، قبل أن تقوم الثورة الفرنسية.”
رد أمير سريعًا:
“نعم.. نعم، أعلم ذلك بالطبع! فأنا خرّيج مدرسة ’سان مارك‘ الفرنسية كما تعرف، وقد درست كل هذا بالتفصيل!”
أجبت، وأنا أحاول أن أتمالك نفسي، لكي لا أبدو وكأنني أسخر منه:
“إذن، ماذا تريد أن تقول بالضبط، كيف تريد أن تعثر على كانديد هذا.. الآن”؟
جاوبني أمير بدوره ـ متأففًا ـ وكأن صبره قد نفد:
“أنا لم أقل إني أريد أن نبحث عن فولتير!”
فقاطعته على الفور:
“آه! لأن فولتير مات، أليس كذلك؟”
رد أمير بحماس:
“بالضبط! فولتير مات، ولكن كانديد لا يموت أبدًا!”
فأجبته، متحيّنًا فورة اللحظة:
“لأنه ليس حقيقيًّا!”
“لا.. بل حقيقي، وإلا فمن ذا الذي نتحدث عنه الآن؟”
“نتحدث عن شخصية في رواية كتبت منذ أكثر من مائتي عام!”
“وهل تموت شخصية في رواية؟ هل تموت سيمفونية ألّفها بيتهوفن أو موزارت؟ هل تموت لوحة رسمها مونيه أو حتى مايكل أنجلو؟”
سكت لحظات، ثم أكمل وهو يشير نحو المارة من حولنا:
“ثم ما الذي يجعلك موقنًا أنّ كل هؤلاء، بل أنت وأنا، حقيقيون، ولسنا مجرد شخصيات في رواية؟”
أدركت الفخ الذي أعده لي الرجل. ولكني اليوم صرت أكثر حنكة مما كنت عليه قبل خمس سنوات، فسألته في براءة ـ قد تكون مفتعلة بعض الشي:
“آه فهمت!”
ثم قررت تغيير دفة الحديث قليلًا، فسألته:
“ولكن لِمَ تريد أن تبحث عن كانديد هذا، يا أمير يا ابني؟”
ابتسم أمير لأول مرة، وارتخى جسمه المتشنج أخيرًا، ثم رفع كوب الشاي، ورشف منه ثم أجاب:
“كانديد هو البراءة، هو النقطة البيضاء الوحيدة فوق قماش أسود متسخ، هو هذا العالم من حولنا!”
ثم مد يده أمامه واستدار بجسمه نحو الطريق، وهو يلوّح بذراعه يمنة ويسرة، ويقول:
“انظر.. انظر يا أستاذ عاطف.. تأمل كل هذا الوسخ من حولنا، كل هذا الفساد والعطن، كل هؤلاء السارقين والمارقين والكذبة.. هل يرضيك هذا الحال؟”
خشيت أن يلمحنا أحد رواد المقهى، أو حتى واحد من المارة، فيظن أنّ أمير يسبّه أو يسخر منه، فتقوم معركة.
“حسن، حسن.. دعك منهم، وكلمني أنا يا أمير يا ابني! ماذا تريد أن نفعل؟”
سكت أمير للحظات وقد غابت نظراته بعيدًا، ثم عاد وقال:
“يجب أن نسافر.. ينبغي أن نذهب إلى تركيا؛ إلى الأناضول، وهناك سوف نجد المزرعة، حيث كانديد، وزوجه كوناجوند، والبروفيسور بانجلوس، صاحب المقولة الشهيرة ليس في الإمكان أبدع مما كان في هذا العالم البديع. إذا ما فعلنا، فسوف ننقذ هذا العالم القذر من الفساد المطلق الذي نحيا فيه. ألا ترى أننا نتجه بكل سرعة نحو هاوية سحيقة؟ ينبغي أن نفعلها سويًا، فأنا لا أقدر أن أنقذ العالم بمفردي، ولست أثق بأحد أن يفعلها معي سواك!”
قلتُ مستسلمًا:
“ننقذ العالم هكذا مرة واحدة! لو كنا نقدر أن ننقذ أنفسنا فحسب، لفعلنا!”
صمتُّ لوهلة، ثم أضفت:
“ولكنني مجرد موظف بالمعاش، يا أمير يا ابني. أنا لا أمتلك ما يؤهلني للسفر إلى تركيا، ولا حتى لشرم الشيخ!”
فأجاب بلهجة واثقة:
“لا عليك يا أستاذ عاطف، مصاريف الرحلة برمّتها سوف أتكفل أنا بها، ثم لا تنسى أني ورثت من أبي مبلغًا لا بأس به، كما أنني سافرت كثيرًا، وعملت، وادخرت نقودًا كذلك.”
تعجبت من إصراره في ما شرع فيه، كما تبينت لي جديّته، وأدركت أن المسألة تعدّت مجرد دردشة على مقهى، وأن أمير قد تفكر في المسألة كثيرًا قبل أن يهاتفني.
سكتُّ ولم أنبس. رحت أتأمل حياتي وما آلت إليه. يدور يومي ما بين مشاهدة التليفزيون، ومطالعة الصحف، أو إعداد الطعام البسيط. لقد زهدت فعلًا في كل هذا، وفقد كل شيء مذاقه لديَّ. ماذا سأخسر لو استجبت لدعوة أمير؟ بل لعلها فرصة أخيرة تلوح لي لأهرب من سجني المؤبد الذي قُضي عليَّ أن أحيا ما بين جنباته.
ثم إن الرحلة ذاتها قد تغدو استشفاءً لأمير من مرضه، كما حدث له حين سافر إلى أمريكا، على الأقل في سنوات ارتحاله الأولى. زد على ذلك أنّ تركيا أقرب كثيرًا من أمريكا تلك، ولن تستغرقنا هذه السَفرة سوى بضعة أيام، نعود بعدها وقد تحسنت أحوالنا معًا.
نعم كلٌّ منا يحتاج إلى تلك الرحلة.
لا، لستُ أشعر بأدنى ذنب تجاه أمير؛ فالفكرة تخصه برمّتها، وهو يرجوني أن أصحبه في رحلته، وما أنا فاعلٌ، إلا استجابة لمشيئته لا غير، ويشهد الله أني لا أنتظر من ورائها سوى أن تعم الفائدة حياتينا كِليهما.
****

*الدكتور شريف مليكة، شاعر وكاتب وطبيب مصري من مواليد 1958، يقيم في الولايات المتحدة. يكتب في الشعر والقصص القصيرة والروايات. وله حتى الآن أربع دواوين شعرية بالعامية المصرية، وثلاث مجموعات قصصية، وسبع روايات أحدثها رواية “دعوة فرح” الصادرة عن دار العين للنشر في عام 2019.

