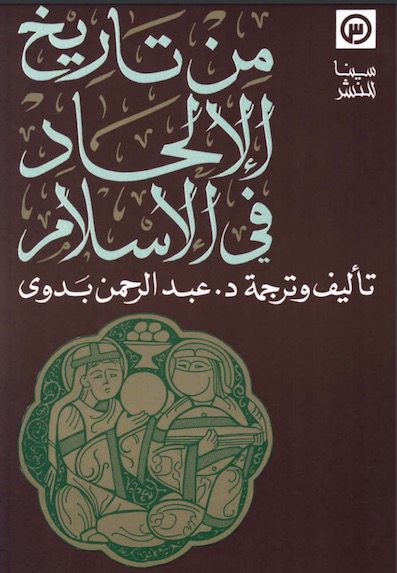ظاهرة الإلحاد من أخطر الظواهر في تطوّر الحياة الروحية، وهي أيضاً ظاهرة ضرورية النشأة في كل حضارة حينما تكون في دور المدنية؛ وإنما تختلف وفقاً لروح الحضارة التي انبثقت فيها. ذلك أن الإلحاد نتيجة لازمة لحالة النفس التي استنفدت كل إمكانياتها الدينية، فلم يعد بوسعها بعد أن تؤمن. وإذا كان الإلحاد الغربي بنزعته الديناميكية هو الذي عبّر عنه نيتشه حين قال: “لقد مات الله”؛ وإذا كان الإلحاد اليوناني هو الذي يقول: “إن الإلهة المقيمين في المكان المقدّس قد ماتت”، فإن الإلحاد العربي- وهو الذي يعنينا هنا في هذا الكتاب- هو الذي يقول: “لقد ماتت فكرة النبوّة والأنبياء”.

ولقد كانت الروحُ العربية في القرون الثاني والثالث والرابع للهجرة قد استنفدت كل قواها وإمكانياتها الدينية الخصبة التي كانت لها من قَبل خصوصاً في المسيحية واليهودية والمانوية والزرادشتية ثم الإسلام الذي توّج هذه الأديان كلها بأن أعطى أكمل صورةٍ للدين قُدِّرَ لهذه الحضارة العربية بلوغَها؛ فكان لا مناص لها بعد أن تنحدر من تلك القمة وتستفرغ إمكانياتها الدينية حتى تغيضَ عنها مواردُ التديّن جملةً، وهذا ما تم فعلاً في القرن الثالث والرابع للهجرة على وجه التخصيص. وكان هذا التطوّر ضرورياً يقتضيه المنطقُ العضوي للتطوّر الحضاري؛ أما العوامل الأخرى فعواملُ مساعدة فحسب، وليست هي العوامل الحاسمة.
وهذه العوامل المُساعِدة هي الإنتقامُ الشعوبي من جانبِ المغلوبين وما يستتبعُهُ من تعصّب لدينهم القديم، لأن العصبية في الحضارة العربية كانت تقوم دائماً على أسبابٍ من الدين بحِسبان الدين هو العامل الحاسم في تكوين القوميات والدول في بلاد تلك الحضارة؛ وهذا يفسّر لنا السرّ في ارتباط الشعوبية بالنزعة الدينية، إذ الدين هو المظهرُ الأكبر في التراث القومي والعصبية الشعوبية؛ أما في الحضارات الأخرى، فلم تكن الحال على هذا النحوِ من التوحيد بين الدين والدولة، بل قامت العصبيةُ القومية في تلك الحضارات بمعزلٍ عن كل عصبية دينية، وفقاً للروحِ الخاصة بكل حضارة وما نراه من قيمةٍ عليا لديها. وثاني العوامل هو نزعةُ التنوير التي نشأت في العالمِ العربي الإسلامي كنتيجة لانتشار الثقافة اليونانية في تلك الأصقاع؛ وهي نزعة بدأت من قبل عند نهاية دور الحضارة في الحضارة العربية، وذلك في بلاط كسرى أنو شروان مما يتمثّل خصوصاً عند بولس الفارسي وعند برزويه إن صحّ البابُ المنسوبُ إليه في كليلة ودمنة. وما كانت حركةُ إبن المقفّع وإبن الراوندي وإبن زكريا الرازي إلا امتداداً لنزعة التنوير الفارسية هاتيك- وكان شأنُها شأنَ كل نزعةِ تنوير تقوم دائماً على أساس تمجيدِ العقلِ وعبادتهِ بحِسبانِه الحاكمَ الأول والأخير والفيصلَ الذي لا رادَّ لحُكمهِ ولا مُعَقِّبَ لقضائه في كل شيء، مما يتمثّل في النزعةِ العقلية المتطرّفة التي نراها في كل أدوار نزعة التنوير في جميع الحضارات: فهي كانت كذلك عند نزعةِ التنوير اليونانية لدى السوفسطائيين، وفي نزعة التنوير الأوروبية في القرن الثامن عشر لدى النزعة المعروفة بهذا الإسم والتي كان على رأسها فولتير وكَنت؛ والأمر كذلك أيضاً كما سنرى خلال هذا الكتاب بالنسبة إلى كلّ ممثّلي نزعةِ التنوير من المُلحدين في الحضارة الإسلامية العربية، وبخاصةٍ عند إبن الراوندي وإبن زكريا الرازي.
وتقوم ثانياً على فكرة التقدّم المستمرِّ للإنسانية، وهي فكرة أكّدها خصوصاً جابر بن حيّان في الحضارة العربية وكانت تمثّل إتجاها مضاداً للإتجاه السنّي الخالص الذي يردّ كل شيءٍ من العلم إلى النبي ويرى في كلّ تباعدٍ عن النبي تقهقراً في العِلمِ وبالتالي في الحضارة والتمدّن، وهذا يفسّر لنا السرّ في ترتيب العِلم ترتيباً تنازلياً من عهد النبي فنازلاً من الصحابةِ إلى التابعين، وهكذا في طبقاتٍ تنازلية يقلُّ حظُّها من المكانة والعلم والتقدير كلما بَعُدَت عن عهد الرسول. وما هذا إلا كنتيجة للصورة التي وضعها أهلُ السنّة للتطوّر المتقهقِر ابتداءً من الرسول. فجاءت نزعةُ التنوير، وبخاصةً في اتجاهاتها الإسماعيلية وفي المذاهب الغُنوصيّة الإسلامية والمذاهب المستورة في الإسلام عامةً، تؤكّد عكسَ هذا الإتجاه وتنظر إلى الإنسانية على أنها تتقدّم باستمرار في خطٍّ يسير قُدماً بغض النظر عن البُعد أو القُربِ من الرُسُل والأنبياء.
وتتّصل بتلك الخاصية خاصّيةُ ثالثة هي النزعةُ الإنسانية التي ترمي إلى الإرتفاع بالقيمِ الإنسانية الخالصة في مقابل القِيَمِ الإلهيّة والنبويّة؛ وإنّا لَنَجدها واضحةً تماماً لدى الشعراء خصوصاً تلك الجماعة المعروفة “بعصابة المُجّان” على حدّ تعبير ماجِنِها الأكبر أبو نُوَاس. فما يُنسَبُ إليهم من عبثٍ وشكٍ إنما كان يُقصَدُ به إلى السموّ بكل ما هو إنساني أرضي حسّي يُشعرُ بمعنى الأرض، وإلى الحطّ من كلّ ما هو فوق أرضي، بوصفه وهماً زائفاً ينتزع الدمَ والحياةَ من الإنسان الحقيقي، الإنسان الحي المكوّن من لحمٍ ودم. ولم يكن عبثاً أن أكّد بشّار لصاحبته عبدة أنه “من لحمٍ ودم”، أي أنه كائن حي عيني يريد أن يعب من كأس الحياة ويلتصق بالأرض، أُمُّهُ الحنون الحقيقية، وليس خيالاً كاذباً أو هيكلاً نورانياً مزعوماً ينزعُ إلى الموت ويشيح بوجهه عن الحياة كما يدّعي المتديّنون. وإن كان من الملحدين مع ذلك مَن يئِسَ من الظفر بمعنى الأرض فلاذ بنوعٍ من الزُهد المذعنِ كأبي العتاهية، أو العُزوفِ الكظيم كابن زكريا الرازي.
وأخيراً، اتّصَفَ تنويرُهم بأنه يطلب الحرّية بكل ثمن دون أن يعبأ بما سيناله من جرّائها؛ فاندفع الزنادقةُ يُعلنون آراءهم الهدّامة بكلّ شجاعةٍ وصراحة، على الرغم مما كان يتوعّدهم به السلطان- أعني الخليفة- من عذاب، وما لقيه أكثرُهم من اضطهاد. وفضّل أغلبُهُم الإستشهادَ فقدّموا أرواحَهم فداءً لتلك الحرية الفكرية التي لم يرضوا بغيرها بديلاً، كما فعل إبن المقفّع وصالحُ بن عبد القدّوس ومئات غيرهم على النحوِ الذي فصّلناه؛ ويلوحُ أن الدولة قد آثرت أخيراً أن تحرِمَ هؤلاء من فخرِ الشهادة فتركتهم أخيراً في النصف الثاني من القرن الثالث، وطوال القرن الرابع يفعلون ما يشاؤون.
وكلُّ هذه الخصائصُ تكشف لنا عن تيّار روحيّ خطير في داخل الحياة الروحية في الحضارة الإسلامية، تيّار لم نحاول هنا في هذا الكتاب إلا أن نقدّم بعض موادّه، وسنتلوها بمواد أخرى في الأجزاء التالية من هذا الكتاب العام في الإلحاد في الإسلام. فإلى أن يتمّ جمعُ هذه الموادِّ كلها، سنرجئ الدراسةَ التحليلية العامة لتلك النزعة التي تُعدُّ من أخطر النزعاتِ التوجيهية في الإسلام ومن أطرف وأخصبِ تيارات الإلحادِ العالمي في تاريخ الإنسانية الروحي.
سبتمبر سنة 1945
عبد الرحمن بدوي