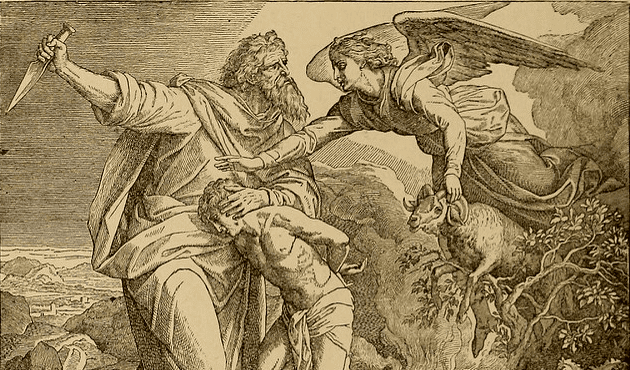لكن، وبعد ظهور وتوطين النماذج المتطرفة من العقائد الدينية والدنيوية في منطقتنا، عاد التساؤل القديم من جديد حول ما الأهم في الحياة؛ الإنسان أم ما يعتقده (عقيدته)، فالخطاب العاطفي الذي لا يقيم وزناً لآلام الناس أو الحد منها يميل إلى جانب استرخاص أرواح البشر مقابل تمجيد المبادئ والشعارات، ولا يتوقف عن المتاجرة بضجيج الانفعالات الشعبية لطمس المظالم واستمرار احتكار المجال السياسي، وهو ما تفعله الأنظمة العربية المستبدة وحليفها التاريخي، الإسلام السياسي، من أجل حشد رعاياهما لخدمتهما والتضحية من أجلهما، بينما تتمحور أنظمة الدول الديمقراطية الحديثة حول الإنسان وحقوقه وواجباته وحرياته، كغاية الغايات، وبدرجاتٍ تختلف بدرجة تطور الديمقراطية نفسها..
التساؤل ذاته حاضر في الجولة الأخيرة من القتال الإسرائيلي – الحمساوي، بعد أن دخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ صباح يوم الجمعة، 21/5/2021، بمبادرة مصرية ودعمٍ أميركي واضح. المحصلة، كالعادة، هي المزيد من الضحايا وتهجير عشرات آلاف المدنيين والتدمير الممنهج لمقومات الحياة في قطاع غزة أو ما بقي منها… وعمّت الاحتفالات ابتهاجاً. من غير المعروف من هم الذين يحتفلون وبماذا؛ هل هو الاحتفال بوقف إطلاق النار أم بالنصر الوهم؟ لكن من المؤكد أن لحماس الحق بالاحتفال بنصرها والنجاح في أداء دورها مرة أخرى، مع أن قضية سكان حيّ الشيخ جراح في القدس ما زالت معلقة ولم تتقدم قيد أنملة، وهي القضية التي قررت حماس مناصرتها بإطلاق الصواريخ!
كما لم تحقق الأنظمة العربية شيئاً ملموساً في الدفاع عن الفلسطينيين وقضيتهم، وربما العكس هو الصحيح، ففي غمرة شعاراتهم الداعية إلى نصرة القضية الفلسطينية، مُنيَت هذه الأنظمة بهزائم متتالية في الحروب التي خاضتها مع دولة إسرائيل منذ نشأتها رسمياً عام 1947، لا بل أن ما بقي من فلسطين وقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، علاوة على أراضٍ أخرى من دول الطوق، ولم تتم أي مراجعة شجاعة لسبب كل هذه الهزائم على مستوى الأنظمة والقيادات. كما مُنيت منظمة التحرير الفلسطينية بهزائم مشابهة في الأردن ولبنان على الأقل، وبقي الأثر التراكمي لنضالها المسلح محدوداً. ولم تكن حماس ومستنسخاتها خارج سياق هذه الهزائم، ولو أنها تطلق عليها، كعادة الأنظمة، انتصاراتٍ أيضاً.
في المقابل، حققت الانتفاضة الفلسطينية الأولى – السلمية أو انتفاضة الحجارة (1987 – 1993) نتائج سياسية تاريخية، أهمها اعتراف إسرائيل بوجود الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس وقطاع غزة والبحث عن حل سياسي في إطار الدولتين وانسحاب إسرائيل من مدينتي غزة وأريحا، كما جاء في اتفاقيات أوسلو (1993). بدورها، اعترفت منظمة التحرير بحق إسرائيل في الوجود، وتحولت إلى شبه دولة هي السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة والقطّاع.
أما الانتفاضة الثانية أو انتفاضة الأقصى (2000 – 2005)، فقد تسببت عسكرتها بخسائر فادحة في الأرواح، فضلاً عن تدمير مؤسسات السلطة الفلسطينية وبناء جدار الفصل العنصري الإسرائيلي، كما منحت عسكرة هذه الانتفاضة إسرائيل حجة للتراجع عن بعض جوانب اتفاقيات أوسلو واتهام الفلسطينيين بالإرهاب. وبالنتيجة، بدأ عصر حماس بأمواله الخليجية وصواريخه الإيرانية، والدور الوظيفي المنبثق من هذين المصدرين، حيث تحصل جولات من إطلاق الصواريخ والقصف والاجتياحات والدمار بين فترةٍ وأخرى، يليها اتفاق المتحاربين إلى إعادة الواقع إلى ما كان عليه، بمبادرات الأشقاء طبعاً.
في هذه المرة أيضاً، لم يفعل التضامن الصاروخي لحماس وأضرابها سوى التسبب بمقتل الأرواح وتدمير الممتلكات في غزة المحاصرة أصلاً، والتي تعتمد كلياً على المعابر الإسرائيلية والمال الخليجي، ووعود بتقديم الدعم من أجل إعادة إعمار غزة، بما في ذلك وعود الرئيس الأميركي، جو بايدن، بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية في كلمته حول اتفاق وقف إطلاق النار الأخير. أما إحراج إسرائيل بمدى الصواريخ الحمساوية فتستطيع التكنولوجيا التعامل معه، جزئياً على الأقل، وهو ميدان العدو الرئيس.
وفي هذه المرة أجهضت حماس انتفاضةً فلسطينية محتملة، كانت قد بدأت في حي الشيخ جراح في القدس ولاقت المزيد من التضامن، والأهم مشاركة عرب 1948 في الاحتجاجات. بالمحصلة، قد تكون إيران هي المستفيدة الوحيدة، ولا بد أنها ستستثمر في هذه المحنة في مفاوضاتها الحالية من أجل العودة إلى العمل في الاتفاق النووي مع الغرب، ولم تبخل حماس بتوجيه الشكر لإيران العقائدية والطموحة!
من ناحية ثانية، لم تقدم الحروب العربية – الإسرائيلية شيئاً يُذكر للفلسطينيين، وتمكنت مصر فقط، وعن طريق المفاوضات (اتفاقات كامب ديفيد 1978)، من استرجاع صحراء سيناء التي احتلتها إسرائيل في حرب حزيران عام 1967، بعد أن اعتبر الرئيس أنور السادات بأن حرب تشرين الأول/أكتوبر (1973) هي مجرد حرب “تحريك” للجمود السياسي من أجل الشروع بالمفاوضات. وما زالت باقي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 تحت نير الاحتلال.
يحتاج الفلسطيني والعربي للتمتع بحق الحياة في منظوماتٍ سياسية واجتماعية أكثر عدلاً، الحق الطبيعي الذي تبنى عليه كل القيم والحقوق والواجبات، فبما أن ثقافة الموت العقائدية سائدة لن يكون هناك أي انتصار حقيقي، إلا ما تدعيه حفنة من المتاجرين بالدم وقيادات الأمر الواقع، من ضمن واقع اعتبار الصراع عقائدياً أكثر من كونه وطنياً، وفي ذلك بعض التبرير لاستمرار الممارسات العنصرية الإسرائيلية.
كما لم يستفد العرب، ولا الفلسطينيين، من صراعهم مع العدو، ولم يدركوا أهمية المنافسة الحضارية لإسرائيل، ذلك أن محورية تفوق إسرائيل تتعلق باحترام حياة مواطنيها والحرص على عدم تقديمهم كأكباش فداء، فضلاً عن بناء القدرات ومستلزمات النصر، بما فيها العسكرية، من دون استعراضٍ وجعجعة. وبالرغم من نظام إسرائيل العنصري تجاه بعض مواطنيها وديمقراطيتها الناقصة، لكن ذلك يكفي لئلا يفكر عرب 1948 في العيش لا في الضفة الغربية ولا في قطاع غزة ولا في أي بلدٍ عربي آخر!.
*د. منير شحود أستاذ جامعي سابق، ممنوع من التعليم بتهمة ربيع دمشق