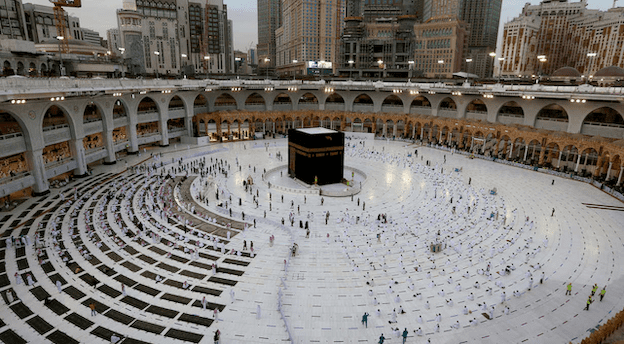أما مع هذا التمييز، فلا يضرّ المسلم المطمئن بإيمانه القول بأن التاريخ الإسلامي لا يستوفي، في فصول مهمة منه، ما تقتضيه المنهجية الوقائعية لتقرير صدق ما يسرده ، فصدق التاريخ الديني مقرر دون هذه المنهجية بالنسبة للمؤمن على أساس إيمانه، أو لربما قد يجد المؤمن حكمة ما، أي فعل إرادة إلهية، في افتقاد هذا التاريخ للتفاصيل التي يتحقق من خلالها ما يُجلي الاستقراء.
الإشكالية في موقف العديد من المفكرين الإسلاميين عند اعتبار التاريخ الإسلامي هي أنهم يمتنعون عن التمييز بين التاريخ الديني والتاريخ الوقائعي، بل يعمدون إلى طرح المقرّر دينيا على أنه ملزِم بالمطلق وللجميع، إما من خلال الإصرار، بيانا لا برهانا، على أن القراءة الدينية قائمة على قواعد عقلية لا يرفضها إلا المتعنت أو الضامر الأذى للدين، أو من خلال البناء على القول بأن ثمة توافق متواصل متواتر للأمة حول صواب هذا التاريخ، بالإجمال أو حتى بالتفاصيل، مع غياب البديل، ما ينفي إمكانية التواطؤ على الكذب أو الوقوع بالوهم. غير أن هذا التوافق بدوره مفترض تعسّفا من خلال الزعم لا الدليل.
وربما أن الإشكالية المقابلة، لدى العديد من المفكرين النقديين هي أنهم لا يواجهون التاريخ الديني بالإشارة إلى مواضع ضموره عن تطبيق المنهج الاستقرائي، بل يعتمدون روايات بديلة للتاريخ الديني قائمة على استجماع تفاصيل فيه، ومن خارجه، تتوافق مع قناعة مسبقة لديهم حول طبيعة هذا التاريخ ودوافعه. فمعروف الرصافي، مثلاً، مؤلف كتاب «الشخصية المحمدية»، انطلق من اعتبار رسول الإسلام قائدا قوميا يحاكي في سماته وصفاته، محاسنه وعيوبه، ما كان متوقعاً في منتصف القرن العشرين، وبنى على هذا الاعتبار غربلته لأخبار صدر الإسلام. پاتريشيا كرون ومايكل كوك، وسائر مدرسة لندن النقدية ومن ثم أصداء هذه المدرسة في ألمانيا وغيرها، اعتمدوا، ولو جدلا في حالة كرون، بعض التدوينات الهشّة من خارج الموروث الإسلامي لافتراض أن الدعوة لم تكن لدين جديد، بل ابتدأت انتظاما مع شكل من أشكال اليهودية، أو أنها لم تكن في الحجاز. والأب يوسف القزي والكاتب مصطفى جحا ركزا على دور ورقة بن نوفل نسيب خديجة زوجة الرسول، والذي قرأ الإنجيل بالعبرية، للتوجه إلى أن المسألة ابتدأت دعوة نصرانية. وغير هؤلاء الكثير ممن سعى إما إلى «عقلنة» التجربة المحمدية برمّتها أو إعادة قراءتها في سياق تاريخي يسقط الغيبي والخارج عن المألوف ويغطي الفراغات القائمة والمستجدة بما يرتضيه العقل.
ومشاريع البناء القائمة على معقولية القراءات البديلة عديدة، ولا تقتصر على المرحلة الإسلامية، بل أنشطها في المحيط العربي تلك التي تحاكي مغامرة المؤرخ اللبناني الراحل كمال صليبي في بحثه عن التوراة في جزيرة العرب. على أن هذه المحاولات، رغم زعم اعتماد العقل والمنطق، في معظمها ليست وقائعية، أي قائمة على استقراء المعطيات، بل هي وحسب مبنية على استحسان التصور والرؤية على أساس المعقول. أي أنها أهوائية في صلبها. أي أنها إيمانية بدورها، وإن اختلف أصل الإيمان.
قد تكون أسس جميع هذه المحاولات النقدية واهية. ولكنها تنطلق من أصل واحد، وهو أن التاريخ الديني الإسلامي، أي المرحلة التأسيسية للتاريخ الإسلامي العام، والذي يشهره المفكرون المسلمون على أنه سجل كامل مكتمل، يعاني من فجوات كبيرة.
الدعوة الإسلامية، من وجهة نظر دينية، هي المفصل التاريخي الأعظم، ورسول الإسلام هو الشخصية التاريخية المركزية الأولى. رغم ذلك، فإن العناية بسيرة الرسول، باستثناء بعض المغازي على ندرة ما تحويه حول شخصه، تركت لمؤلف واحد في القرن الثاني، جرّح به من تلاه من العلماء، ابن إسحق. وتدوين أقوال الرسول وأفعاله وما تركه أو سكت عنه، أي الحديث الذي تقصّد مطلق الشمول، ويبدو من أعداد الأحاديث المنقولة عن أئمة الحديث أن المادة لهذا الشمول كانت متوفرة، لم يتشكل منهجيا إلا في القرن الثالث للهجرة. وفي المجالين، السيرة والحديث، مع وفرة التفاصيل الدقيقة حول العَرَضيات، فإن خطب الرسول في مسجده في المدينة، مثلا، على مدى أكثر من عقد من السنين، لم تحظَ بأي تدوين، رغم أهميتها القاصمة للعلم الديني بكافة أوجهه.
وفيما يتعلق بالخطب، فإن صهر الرسول وابن عمّه علي بن أبي طالب، نال بعد بضع مئات من السنين مجموعا يضمّ خطبه وفصيح أقواله، بجمع من الشريف الرضي، من دون أن يكون قبلها لهذه الخطب وسائر ما حواه كتاب نهج البلاغة من أثر وافٍ في المنقول.
ومسار ظهور المزيد الجديد ينطبق كذلك على السيَر النبوية، والتي غدت شمائل ودلائل نبوة، إذ تكاثرت فيها مع العصور أخبار الرسول ومعجزاته وإرهاصات نبوته وكرامات من والاه، فيما اعترى أخبار خصومه البتر والتقطيع. مسيلمة، وهو ربما قبل التبخيس وتشنيع الاسم مسلمة رحمن اليمامة، يرِد لدى ابن هشام وفي أولى المصادر باقتضاب مع بعض البيان في قرآنه. في السيرة الحلبية، بعدها بقرون، استفاضة بذكر مثالبه، فيما تآكلت كلمات قرآنه لتمسي نثراً مشوّهاً.
وفي خضمّ المراجعة المبدئية التي تلت الميل إلى الأصولية السلفية، كظاهرة حداثية، تعرّض الموروث الإسلامي لاقتطاعات وتشذيب تحت شعار التهذيب والتصحيح، انطلاقاً من المنهجية التي يراد لها أن تكون صارمة وعلمية، أي منهجية الحديث. غير أن هذه المنهجية ليست علمية بالمعنى العقلي الصرف. فثراء المصطلح والاعتبارات في هذه المنهجية لا يرفع عنها الصفة الإيمانية، إذ هي تتوقف جرحا وتعديلاً عند الصحابة، انطلاقاً من تقرير عدلهم جميعاً، بآلافهم. بعشرات آلافهم، وما يزيد، ومهما كانت أعمارهم، ومنهم ابن عباس الذي توفي الرسول وله من العمر على ما يُذكر ثماني سنين، ومع ذلك فقد نقل عنه آلاف الأحاديث. ومهما خرج الفعل عن المألوف، كما لدى أبي هريرة الذي صاحب الرسول فترة وجيزة وكان أكثر من نقل عنه الأحاديث.
وعليه فإنه حيث لا حرج إيمانياً القول أن الحديث الصحيح سنداً ومتناً موجب للتصديق اليقيني، فإنه ليس كذلك عقلياً.
أن يتفرّد والد الرسول باسم العبودية للإله الذي دعا إليه الرسول في مرحلة لاحقة مشيئة إلهية لا يَسأل عنها المؤمن. أخبار الشق والإسراء إلى المسجد الأقصى والمعراج إلى السماوات حقيقة يقينية للمؤمن، وحق له برواياتها ودلالاتها. ولكن هذه الأخبار ليست كذلك لمن لا يعتبر الإيمان أصلاً من أصول المعرفة، أو لمن يُطالب النقل بدلائل تتجاوز تلك التي ترتضيها المنهجية الحديثية.
تستوي لدى المؤمن يقينية الأخبار الخارجة عن المألوف وما شابهها، والأخبار الداخلة في المألوف، كأن يكون أبا بكر قد خلف الرسول ثم عمر ثم عثمان وعلي. أما المنهج الوقائعي، فهو يقتصر على القبول بظنية الأخبار الداخلة في المألوف، ولا يأخذ بغيرها. ولا ترفع الظنية نحو التصديق ما لم تصاحب هذه الأخبار دلائل وقرائن خارجة عن النص، وهو قلّ ما يحدث بما يتعلق بفجر الإسلام وصدره، حيث وحدها المصادر الإسلامية، والتي تعود بسندها إلى قلّة من الأخباريين، تسرد دون لبس أخبار هؤلاء الخلفاء. ندرة المصادر لا تنفي وقائعية هذه الأخبار. ولكنها تجعل اعتمادها مقيّداً.
المواجهة اليوم هي بين فكر إسلامي يستهجن هذا التحفّظ ويطالب دون مبرر بتجاوزه، وبين منهجية وقائعية تقتضيه حكماً. لا بل من خلال «أسلمة العلوم» والتي توسّعت وتعمّقت في الربع الأخير من القرن الماضي، فإن الفكر الإسلامي المعاصر قد انتقل إلى اعتماد الإيمان أصلاً معرفياً فيما يتعدى النقل في كافة المجالات. أي أن العلوم العقلية والتجريبية بدورها أمست تحتاج تأصيلاً إيمانياً، فإن غاب كانت موقع نقد ونقض. نظرية النشوء والارتقاء هي الأساس الموضوعي للعلوم الحياتية اليوم. غير أن جهود المفكرين المسلمين منصبّة على تصيّد نواقص هذه النظرية، مهما تضاءلت، لأغراض تضخيمها والتهويل بها والحديث عن غباء الغرب وحقده على الإسلام لاعتمادها. ونظرية الانفجار الكبير هي الأساس الموضوعي للعلوم الكونية. غير أن نشاط المفكرين المسلمين يتركز على تطويع هذه النظرية لإلحاقها بما يحاكي أطرافها من الآيات القرآنية.
جهود المفكرين الإسلاميين في هذين الشأنين وغيرهما من الأمور العلمية تقحم الدين بما لا يدّعيه وتشتت انتباه الأجيال الصاعدة وطاقاته باتجاه تصادم حصتهم فيه خسارة الوقت وضياع إمكانية المساهمة البناءة.
وفي المقابل فإن السعي الحثيث إلى تقديم القراءات البديلة للتاريخ الإسلامي، سواء منها التي تعتمد المادية العلمية منطلقاً فكرياً، أو تلك المطروحة بلهجة توفيقية لا تنكر الغيب، صدقاً أو تدليساً، قد لا تحقق سوى تبديد الطاقة الفكرية للأجيال الصاعدة ولعموم المجتمع في دفعهم نحو استثمار القراءة البديلة إيمانياً، بما يحضّرهم للخيبة عند تهاوي هذه القراءة، أو لقبول الطرح بأن التاريخ الديني هو الأجدى بالتصديق اليقيني الإيماني.
ربما أن الأنجع بدلاً من السعي المرتبك إلى سردية كاملة بديلة، هو المرور على المادة التاريخية الدينية بالقراءة النقدية المنهجية، ليس بحثاً عن البدائل بل للكشف عن مواطن التعارض. ليس للمنهجية الوقائعية في كل حالة أن تصدّق أو أن تكذّب أخبار التاريخ الديني. شأنها وحسب أن تفيد الطالب أو القارئ أو المتابع بأن التاريخ الديني الإسلامي، وهو المستفيد طبعاً من التصديق اليقيني إيمانياً، يتراوح وفق المنهجية الوقائعية بين الظنية والمجهول.
الواقع الثقافي في المحيط العربي يعيش اتهامات متبادلة بالتجهيل، بين مفكرين إسلاميين يعتبرون أن المناهج الدراسية، في ميلها الخجول إلى الوقائعية هي مؤامرة لفصل المسلم عن دينه، وبين التوجهات التعليمية والتربوية التي تريد أن تقدّم لطلابها ما يمكّنهم من المشاركة بالحضارة العالمية. وبين هؤلاء وأولئك حشد يتحدّث عن أنه لا تعارض بين الدين والعلم. بل الواقع أن هذا التعارض قائم في أصول المعرفة والمنهجيات، والسبيل إلى تخفيفه دقيق وحرج، وبقدر ما اندفع المفكرون المسلمون باتجاه أسلمة العلوم، بقدر ما من شأنهم أن يجنوا الارتباك والسقوط للدين في طرحهم له على أنه منظومة شاملة.
والحالة معكوسة في موضوع التاريخ، أي كلما عمدت التوجهات النقدية إلى طرح البدائل على أساس المعقول، كلّما أوهنت المنهجية الاستقرائية. ربما الأصح لهذه المنهجية، ولتحقيق وقف إطلاق نار منتج ضمن البنية الذهنية القائمة اليوم، هي وضع فصول عديدة من تاريخ نشأة الإسلام خارج المنهجية الاستقرائية. ليس في الأمر قبول بالتاريخ الديني كتاريخ وقائعي، بل وحسب الإقرار بأن الظنية التي يمكن تقريرها له لا تشمله بالكامل. وفيما عدا القبول الظني لبعض الفصول تبقى بعض تفاصيل التاريخ الإسلامي الأول غائبة. ولا ضير أن يبقى في الكثير من معالمه مجهولاً.
Un