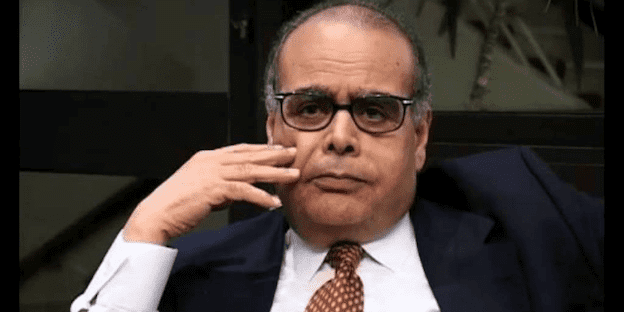نشر الباحث الإيراني « مهدي خلجي » مقالا بموقع “بي بي سي” تحت عنوان “ثورة في المعرفة القرآنية”، يشرح من خلاله وجهة نظر المفكر المصري الراحل نصر حامد أبو زيد حول ما أسماه بخطاب القرآن، أو الكلام الشفهي للقرآن، والذي جاء ضمن أبواب عدة في كتابه “التجدید والتحریم والتأویل، بین المعرفة العلمیة والخوف من التکفیر” (الذي صدر بعد رحيل أبو زيد) وكان تحت باب “مقاربة جديدة للقرآن: من النص إلى الخطاب، نحو تأويلية إنسانوية”.

يقول خلجي بأنه منذ زمن النبي محمد أدرك المسلمون أن فهم القرآن ليس أمرا يسيرا، حيث كان الصحابة يسألونه باستمرار عن معنى بعض الآيات. كسؤالهم عن معنى “أبّ” في آية “وفاكهة وأبّا” (سورة عبس الآية 31)، وعن معنى الظلم في آية “الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون” (سورة الأنعام الآية 82)، فيما كانت إجابة النبي محمد بأن معناها هو “الشرك”.
يضيف خلجي بأن ذلك أدى بالمسلمين، بالتدريج، وفي إطار حراك فهم النصوص، أن يضعوا فارقا بين التفسير والتأويل. فكان التفسير بمعنى ترجمة النص حسب ما هو متداول اليوم، بينما كان التأويل بمعنى اكتشاف ما يخفيه النص من معنى. حيث كان للتأويل صورة سلبية لدى علماء المسلمين، ما اعتُبر جزءا من الصراع السياسي والكلامي.
وفی العصر الراهن، وبعيدا عن الأبحاث الغربية الكلاسيكية حول القرآن، سعى المسلمون لـ”العودة” إلى القرآن لكي يجدّدوا فهم نصوصه ويجعلونه متوافقا مع الحياة الجديدة.
يقول خلجي أن معرفة القرآن تسير اليوم في مجالين مستقلَّين: معرفة تقليدية قائمة على تفسير القرآن وفق الأساليب الكلامية القديمة، وهي تتلقى الدعم والترويج من المؤسسات الدينية الرسمية، وينتمي إلى دائرتها بعض المثقفين الدينيين. ومعرفة حديثة، وأصبحت حقلا تعليميا في الجامعات، ويستطيع المسلم وغير المسلم أن يدرسها وأن يتخصص في بعض المجالات المتفرعة عنها.
ينقل خلجي عن ابو زيد قوله أن غالبية مفسّري القرآن التقليديين والحداثيين، باستثناء المفكر الجزائري الراحل محمد أركون، يغفلون نقطة مهمة: وهي أن القرآن الذي نزل على النبي محمد لم يكن “نصا”، وأن ما هو موجود بيننا اليوم، أي نص القرآن، لم ينزل مرة واحدة بل نزل على مراحل، مشيرا إلى أن القرآن هو حصيلة تجميع وتدوين تم في عهد الصحابة، وأن أول نسخة من القرآن، أو من “المصحف”، افتقد النقاط على حروفه ولم يكن بالإمكان إعرابه، وظهر في عصر الخليفة الثالث عثمان بن عفان، أما النسخة النهائية من القرآن، أو من “المصحف” الذي بين أيدينا اليوم، والذي اشتمل على النقاط والإعراب، فقد ظهر في مراحل لاحقة. لذا، لا يجوز في إطار تعاملنا مع القرآن، أي في إطار تعاملنا مع “المصحف”، الذي تم ترتيب آياته وتنظيمها وتدوينها بشكل خاص، أن نضيف إليه شيئا وأن نحدّد فيه أية عيوب.
أما القرآن المستند إلى الوحي، فهو، وفق « خلجي »، ليس كلاما شفهيا قيل لمرة واحدة، بل قاله النبي لصحابته في فترة زمنية امتدت لأكثر من عشرين عاما, وهو كلام قيل في سياق ظروف تاريخية متباينة ولأفراد مختلفين. لكن المسلمين تعاملوا مع القرآن بفرضية أنه “نص” أو “مصحف”، وسعوا إلى تفسيره وتأويله. والنتيجة أن الأساس الذي انبنت عليه التفسيرات كان ضعيفا.
یقول ابو زيد: تعاملت مع القرآن وفق هذه الفرضية لفترة طويلة من الزمن، وبحثت في معنى النص من خلال وسيلة التأويل، خاصة فی کتاب “مفهوم النص“. أما بعد ذلك، أدركت بأني أخطأت الطريق، ولا بد مجددا أن أنظر إلى القرآن بصورة مغايرة. ويضيف أبو زيد بأن أصالة “نص” القرآن، هي بمثابة نزع لروح النص، ولقابليته للحركة، وتبديل النص إلى هوية جامدة غير قابلة للتغيير، ومحاصرته وسط جدران سميكة من التأويلات النهائية، وجعل النص هدفا لألاعيب الجماعات السياسية التي ستفسر النص وفق مصالحها.
يؤكد خلجي على ضرورة التحرّر من فكرة أن القرآن “نصّ”. ويضيف بأنه في الوقت الذي يعزف الفقهاء والمفسرون التقليديون على وتر التأويل، يعتقدون بأنهم أمام نص قد يغوص في تفسيرات تؤدي إلى تناقضات في الفهم. وبما أن النص القرآني يجب أن لا يحتوي على تناقضات، بسبب أنه نص إلهي سماوي جاء عن طريق الوحي، سعى المفسرون إلى خلق أدوات للتفسير تعالج تلك التناقضات.
على سبيل المثال، بما أن الفقهاء يعتقدون بأن القرآن “نصّ”، فإنهم يعتبرونه منبعا للتشريع. وحينما يأتون بآيات تطرح أحكاما متباينة حول موضوع واحد، فبالضرورة يؤسسون لمفهوم “النسخ”. وفي إطار نظرتهم تلك فإن هناك آيات ناسخة وهناك آيات منسوخة. وفي الوقت الذي لم يكن لدى المفسرين التقليديين القدرة العلمية على اكتشاف الترتيب الدقيق لنزول الآيات، فإن تقییم الناسخ والمنسوخ كان محل خلاف بينهم. كذلك، حينما تم تقسيم الآيات إلى محكمة (ذات معنى واضح) ومتشابهة (التي تفتقد لوضوح المعنى وتحتاج إلى تأويل)، فإن ذلك أجّج النزاع بين المتكلمين في مختلف المذاهب. وكانت مفردات أصولية مثل “العام” و”الخاص” من الأدوات المفاهيمية التي ساهمت في معالجة التناقضات الظاهرة في فهم “النص” القرآني.
والقرآن بوصفه “نصّاً”، ساهم في اعتباره بناء لتشريع القوانين وإضفاء المشروعية على أحکام صالحة لکل زمان ومکان. أي أن أصالة “النص” القرآني أصبحت متعلقة بتجاهل الرؤية التاريخية للنص. في حين أن القرآن كان عبارة عن مجموعة من الكلام الشفهي الذي ظهر إلى الوجود في إطار سياق تاريخي. فطبيعته كانت حية، وأُرسل إلى شخص خاص، وقيل في ظروف خاصة، وأجاب عن أسئلة متعلقة بحاجات واقعية وإنسانية. لهذا، فإن “تفسير القرآن بالقرآن”، على سبيل المثال، يبدو لا معنى له وفق « خلجي ».
من هذا المنطلق، يشير خلجي إلى ظهور مفهوم “أصالة النص” القرآني، معتبرا ذلك مسعى لمنع أي إمكانية لتغيير معنى “النص”، ولجعل هوية القرآن جامدة، ومحاصرة القرآن وسط جدران سميكة من التأويلات الثابتة التي لن تتغير إلا حسب ما تقتضي المصالح. كذلك، تتحقق أدلجة القرآن من خلال فرضية أنه “نص”، فيما الوسيلة الوحيدة لمواجهة تلك الأدلجة ورفعها هي بمعرفة طبيعة القرآن الشفهية الخطابية.
يقول ابو زيد بأن القرآن لیس صوتا واحدا وإنما مجموعة مختلفة من الأصوات التي تصل إلى مسامعنا. فالذين تخیلوا أن القرآن “نصّ”، سعوا من خلال التحليل البنيوي إلى تصنيف الأشكال الأدبية من الآيات إلى: آيات القسم والشهادة وما يرتبط بها، الآيات بمعنى العلامات التي تدل على الشيء، الآيات بمعنى المعيار القرآني والقصص والأحكام والعبادات. أما إدراك الطبيعة الخطابية الشفهية للقرآن فهو بمعنى أن القرآن مثله مثل أي حديث شفهي أو خطاب، يستطيع أن يحتوي على حوار وجدل وإنكار وقبول واختيار. هو كلام شفهي وليس نصّا مكتوبا. ويجب إدراكه من خلال أداة تحليل الخطاب لا عن طريق فهم النص.