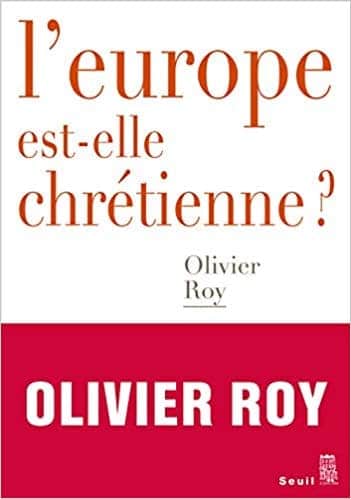![]()
في كنابه الجديد، “هل أوروبا مسيحية؟”، يقدّم « اوليفييه روا » وصفاً دقيقاً لاضمحلال المسيحية الأوروبية، ولإخفاقات حرب « الهويات » في خدمة « القِيَم المسيحية ». ولكنه يخلص (متأثّراً بالراهب اليسوعي “باولو داليليو” الذي اختطفته “داعش) إلى أن ما يسمّيه « طريق النبوّة » ربما يظل مفتوحاً!
شارل جيغو » (جريدة “الفيغارو”)– خاص بـ”الشفّاف
يحتمل أن « أوروبا » لم تعد مسيحية! يحدّثنا عن هذا الموضوع، بتوازن ورويّة، « الكالفيني » غير المؤمن « أوليفييه روا » الذي تأثر كثيراً » بـ»الشبيبة البروتستانتية » ثم استفاد كثيراً من الكاثوليكية الإيطالية التي يراقبها عن كَثَب منذ تولّيه التدريس في « المعهد الجامعي الأوروبي » في «فلورنسة ». وكنا، في الآونة الأخيرة، قد اعتدنا قراءة ما يكتبه عن المسلمين– وخصوصاً عبر سجالاته مع (الباحث الفرنسي) « جيل كيبيل » حول طبيعة الجهادية الجذرية (المقصود، ربما، « السلفية الجهادية »).
ولكن « أوليفييه روا » معروف منذ وقت طويل كمفكّر دقيق جداً حول آثار الفكرة الليبرالية على المسيحية وعلى الإسلام– وقد طوّر تلك الف كرة عبر كتابه « الجهل المقدّس » الصادر في سنة ٢٠٠٨.
كرة عبر كتابه « الجهل المقدّس » الصادر في سنة ٢٠٠٨.
« أوروبا » التي يتحدّث عنها « أوليفييه روا » في كتابه الجديد تحمل معنيين: أوروبا كحضارة، وأوروبا كمشروع سياسي.
ويُذَكِّر « أوليفييه روا » عن وجه حق بأن أوروبا كانت، أولاً، مشروعاً مُستوحى من المسيحية بصورة عضوية، وأن من حملوا المشروع الأوروبي (بعد الحرب العالمية الثانية) كانوا ثلاثة كاثوليك ملتزمين (هم «شومان »، و « كاسبيري » و »أديناور »)، ثم الأحزاب والتيارات « الديمقراطية المسيحية »، وأن المشروع الأوروبي كان صدىً لتطلّع حملته الكنيسة الكاثوليكية على مدى قرون عديدة، وحتى منذ ما قبل الإنشقاق البروتستاتني (٣١ أكتوبر ١٥١٧) لقيام « حيّز مسيحي » مستقل عن الملوك، أي حيّز « ما فوق قومي » بكلمات أخرى.
وكان اختراع السِلك « اليسوعي »، الكوني، وغير المرتبط ببقعة جغرافية، تعبيراً باهراً عن تلك الفكرة.
ويقول « « أوليفييه روا »، ردّاً على سؤال، أن « كبار الموظفين في الإتحاد الأوروبي في بروكسيل هم أبناء عمومتهم البعيدون، ولو أنهم أقل ثقافة من « اليسوعيين (الجزويت) ».
ومع ذلك، فقد رفضَ الإتحاد الأوروبي أن يشير في مشروع دستوره الصادر في سنة ٢٠٠٥ إلى دَينه تجاه المسيحية. وجاءت العقدة، وللأسف، من فرنسا، وربما كانت بمثابة اعتراف غير مقصود بنقطة صادمة: وهي أن الإتحاد المقدس الذي كان قائماً بين أوروبا والمسيح لم يعد، في عصرنا، سوى مجرّد تعايش وسط اللامبالاة. فالحقيقة هي أن أوروبا تدين بإسمها، وبهويتها الأولى، إلى تاريخٍ يوناني ووثني. وهنالك حقيقة أخرى هي أن المسيح لم يولد على أرض أوروبا، وأن أول من تعصّب لدينه كان شعوبَ البحر الأبيض المتوسط.
مع ذلك، لا مفرّ من ملاحظة أن أوروبا في القرون الوسطى أصبحت حاضنة مسيحية المقاومة أولاً، ثم مسيحية الغزو لاحقاً. إن ازدهار المسيحية، وتأليهها لاحقاً، يعود– وهذا ما لا ينكره أحد– إلى وجود “مرشّة الماء المقدّس” إلى جانب عروش كل أمراء أوروبا. لكن تلك الحقبة انتهت حينما التهمها قرنان من الحداثة.
ومنذ نصف قرن، فإننا نشاهد التسارع المذهل بين حيّزين– الإيمان المسيحي، وأوروبا– كانا موحّدين توحّداً مثالياً.
يمكننا أن نعتبر أن « قِيَمَ » الإنسانوية الحالية التي ننظر إليها بإعجاب بالغ هي منوّع علماني لمسيحية الأمس، وتلك هي فرضية « مارسيل غوشيه » Marcel Gauchet ومفادها أنها « الدين الوحيد للخروج من الدين ». ولكن « أوليفييه روا » يرفض تلك الفرضية التي تتعمّد إخفاء أن الرجل الأوروبي الجديد لا يمتّ بصلة إلى الرجل المسيحي القديم.
وهو يعترف بأن تطوّر المسيحية باتجاه الإنسانوية قد ولّدَ حتى سنوات الستيّنات من القرن الماضي تناسباً بين الدين القديم وأخلاقية مسيحية علمانية أطلقنا عليها في فرنسا تسمية « الأخلاق الجمهورية ». ولكن زمن الإنسانوية في حدود السلوك الحَسَن، الذي آل بـ»مجمع الفاتيكان ٢ » لأخذه بالإعتبار بعد نقاشٍ داخلي استغرق أكثر من قرن، (إقرأ مقالة العفيف الأخضر: فاتيكان 2 أصلح الأديان التوحيدية: بالانتقال من الحاكمية الإلهية إلى الحاكمية البشرية) سرعان ما كَنَسَتهُ نهائياً، بعد فترة قصيرة جداً، ثورة أنثروبولوجية جديدة، تمثّلتفي ظهور « الرغبة المَلِك » (إضافة منا: في المسيحية يُقال “المسيح الملك”). إن الهيمنة الشاملة لمذهب المتعة تتناقض تناقضا صارخاً مع المسيحية التي سعت دائماً إلى إذلال الإنسان أمام جبروت الله أو، بالإقل، إلى رسم حدود صارمة لحُكم الإنسان: حدود للتقدم التقني، وحدود لأشكال العائلة، وحدود للمطالبة بالمتعة، باعتبار أن الخلاص يأتي من العمل، العمل الذي هو، لغوياً، ألمٌ وعذاب، ومن منظور الإنجيل: عقابٌ وغفارة. وحيث أن تلك الثقافة « التحرّرية » قد اجتاحت كل ما يقف بطريقها، فقد وصلت الكنيسة إلى إعلان أن المجتمعات الأوروبية باتت « وثنية » و»معادية للمسيحية » (البابا بندكت السادس عشر). (النص الحرفي لخطاب البابا بندكتوس السادس عشر “إن الله لا يُسَرُّ بالدماء، وإن السلوك غير العقلاني يناقض طبيعة الله”)
فراغ روحي
هل ينبغي القول أن تلك الحركة غير قابلة للمقاومة؟ أم هل يمكن للأوروبيين أن يعودوا يوماً إلى الإيمان المفقود (البروتستانتي أو الكاثوليكي)؟
العودة إلى الإيمان تبدو احتمالاً ضعيفاً. يمكننا أن نتوقّع تحالف مصالح بين الأحزاب الشعبوية الحالية في أوروبا والفاتيكان. ولكن « أوليفييه روا » يعرض بصورة مقنعة أنه لا سبيل لردم الهوّة بين الأخلاق المسيحية التي يدعو لها الفاتيكان– وتدعو لها البروتستانتية كذلك– وبرامج « الشعبويين » الأوروبيينالذين لا يذكرون إلا لماماً المسيحية، تلك المسيحية التي يرفضون، بقوة عقيدتها الداعية إلى الترحيب باللاجئين والتعاطف معهم. إن « الصدام » بين « ماتيو سالفيني » (زعيم « رابطة الشمال »، ووزير داخلية ونائب رئيس حكومة إيطاليا) ومجلس الأساقفة الإيطاليين، حول مسألة « المهاجرين » هو مثل حديث. والواقع أن دعاة « الهويّات» (المقصود « الهوية الأوروبية » أو « الإيطالية » أو « الفرنسية » الخ.)، كما يسمّون أنفسهم،لا يستخدمون المسيحية إلا كعلامة حَشد وتعبئة ثقافية، وليس روحية، ضد الإسلام. ولكن، حتى في هذه الحالة، فإن القِيَم التي يرفضون أسلَمة المجتمعات الأوروبية بإسمها ليست قِيَم المسيحية وإنما « القِيَم الليبرالية المشتقة من « عصر الأنوار » مثل حرية التفكير والنقد، والحرية الجنسية، وحقوق الإنسان، أي باختصار « حرية المتعة في ما بيننا »، التي يمثّلها موقف بصورة جيدة موقف « رونو كامو » Renaud Camus الذي اخترع تعبير « الإحلال (أو الإستبدال) العظيم.
إن تلك المسيحية الموروثة بالمعنى الدقيق، وتلك بالمناسبة هي الحجة التي يتم استخدامها للدفاع عنها أمام المحاكم، تنسجم بسهولة مع فكرة أن لأوروبا « جذوراً مسيحية ». ولكن ذلك لا يكفي القساوسة أو الكهنة، الذين كانوا قد ندّوا بجماعة « العمل الفرنسي » Action Française في ثلاثينات وأربعينات القرن العشرين لذلك السبب بالذات.
وهكذا ينتهي « أوليفييه روا » إلى وجود فراغ روحي لم تعد تملأه أية « يوتوبيا ». وبدون شك فإن الواقعية التاريخية- وهذه تعادل التشاؤم- ينبغي أن تدفع المسيحية لإدارة ظهورهم وتشكيل مجتمعات معزولة أمام صعود موجات « البرابرة »، كما ينبغي أن تدفع « الرجل الأخير » الذي تحدّث عنه « نيتشه » للتحديق في العَدَم.
ويتبقى لهم حلّ آخر يتمثّل في الضغط السياسي على المشرّعين وعلى القضاة- والمَثَل الأخير، حتى الآن، هو « زواج المِثليين ». ولكن الحصيلة ليست حاسمة، سواءً في فرنسا أو في غيرها. وهنا لا يبقى سوى إعادة الفتح الروحي، التي تأخذ أشكالاً متنوعة، ومتعثرة في الغالب، عبر جماعات « المبشّرين » Evangilistes والجماعات « الكاريزمية » Charismatiques.
يقول « أوليفييه روا »: « يؤسفني أنه لا يوجد طريق وسطي بين العلمانية والأصولية المِعيارية التي تعتنقها الكنيسة في يومنا والتي تضعها في موقع جندرمة (دركي) الأخلاق الحسنة ». أي « طريق نبوّة » يجد أوروبا في مساره. ويخلص إلى أن « أوروبا هي الجسم الوحيد الذي يمكن، بعد، أن نبثّ فيه روحاً ما ».
 قبل خطفه في سوريا، الأب باولو داليليو: « لا ينبغي لنا أن نظهر كمشرّعين، بل ينبغي علينا أن نظهر كأنبياء »!
قبل خطفه في سوريا، الأب باولو داليليو: « لا ينبغي لنا أن نظهر كمشرّعين، بل ينبغي علينا أن نظهر كأنبياء »!
*
ملاحظتان: يعتبر « أوليفييه روا » أن « ثورات » ١٩٦٨ كانت النقطة الفاصلة للتحوّل الأنثروبولوجي الذي يشير إليه، أي إلى انفصال أوروبا عن المسيحية.أما عن إشارته إلى « طريق النبوّة » فالمقصود به شخصيات مثل « الأب داليليو » الذي اختطفته « داعش » في سوريا والذي لم يُعرف مصيره. ويقول: « أشير في كتابي الجديد إلى الأب « باولو داليليو »، الذي التقيته قبل شهرين من اختفائه، والذي تأثرت كثيرا به. وقال لي: « لا ينبغي لنا أن نظهر كمشرّعين، بل ينبغي علينا أن نظهر كأنبياء »!