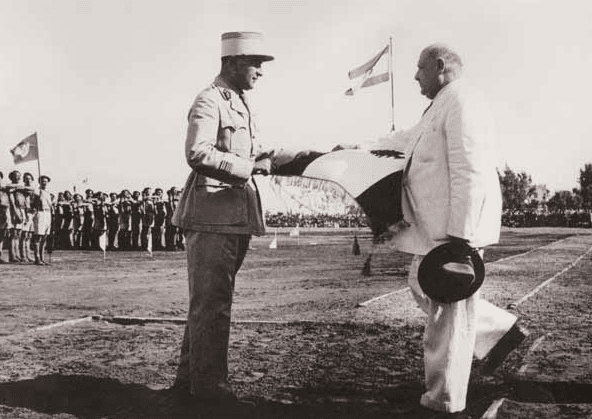محاضرة الدكتور فارس سعيد
تيار المستقبل – صيدا – 19 تشرين الثاني 2015
حدّدَ الفيلسوف ماكس فيبر الدولة بالآتي:
الدولةُ هي الجهة التي تحتكرُ لنفسِها شرعيةَ استخدامِ القوة؛
والدولةُ هي التي تنظمُ إدارةَ مجتمعٍ قرر بناء نظامِ عيشِهِ ومصالحِهِ وفق معاييرَ تاريخية وثقافية واقتصادية، وهي التي تحتكرُ استخدامَ القوة وفق القوانين والدستور والشرعية الدولية؛
وتنظمُ الدولة الحديثة اليوم علاقاتِها مع الدول الاخرى وفق القانون الدولي وشبكات مصالح مشتركة في إطار ما يُعرف بالنظام الدولي الجديد، وإذ نتكلّم اليوم عن “جديد” فهذا يعني أنه يحاول استبدال نظام قديم. استمرّ طوالَ فترة الحربِ الباردة التي انقسمَ العالم خلالها إلى معسكرين متواجهين، الرأسمالية في مواجهة الشيوعية.
يتميز النظام الدولي الجديد بالسعي لحل المشاكل العالقة والخلافات من أجل تغليب المصالح المالية والاقتصادية. وأكادُ أقول بأنه يسعى لأن يكون أكثرَ إنسانية من مرحلةِ الحرب الباردة، بارتكازه على معادلة واضحة: الاستقرار هو مفتاحُ المصالح الاقتصادية. هذا في ظلّ عولمة متسارعة تطاولُ ثلاث مستويات أساسية: اقتصادية، وثقافية، وتواصلية – معلوماتية، بحيث باتت العولمة مرادفة للسيولة الشديدة على هذه المستويات.
والواقع أن هذه السيولة ألغت مبدأ المجتمعات الصافية، إثنياً وعرقياً وثقافياً، مع الهجرة المتزايدة من الجنوب باتجاه الشمال ومن أفريقيا والشرق الأوسط باتجاه أوروبا، التي تحتضنُ اليوم حوالى 40 مليون مسلم يعيشون في بلدان الإتحاد الأوروبي. هذا عدا الأديان والإثنيات القادمة من الشرق الأدنى والأقصى أيضاً، والتي تعيش في “أوروبا مختلطة”. في الوقت نفسِه نلاحظُ عودة إلى التمسّك بالشخصية الوطنية بمرتكزاتها الأساسية.
وإذا أردنا قراءة واقعِ منطقتِنا العربية اليوم، علينا أن نحدّدَ ما هي المتغيرات الكبرى التي تتحكّمُ بنا والتي تتلخّصُ اليوم بالنقاط التالية:
- بلورة نظام عالمي جديد بزعامة الولايات المتحدة يرتكزُ على نظامٍ اقتصادي ومالي وسياسي وعسكري وقضائي في إطار عولمةٍ متسارعة. كما يعيشُ العالم اليوم ثورةَ اتصالاتٍ وتواصل غير مسبوقة تجعل منه قرية صغيرة على شبكات التواصل الإجتماعي.
- إنهيار النظام العربي القديم الذي أعقب مرحلة الإنتدابات الغربية، ثم نشوء دولة اسرائيل، والذي تميّزَ بقيامِ أنظمةٍ إستبدادية عسكرية حاربت شعوبها بجدارة وحاربت اسرائيل بأشكال ملتبسة، مع احترامي لتضحيات الجيوش العربية.
- بروز تيارات إسلامية متطرفة، تتراوح ما بين قيام دولة ولاية الفقيه ودولة الخلافة، مما شوّه صورةَ المنطقة وساهم في بروز تيار معادٍ للإسلام في الغرب أو ما يسمى بـ”الإسلاموفوبيا”، وبروز تيار آخر تكلّم عنه البابا فرنسيس خلال زيارته إلى تركيا مؤخراً، “الكريستيانوفوبيا” – وهو تيار معادٍ للمسيحية بوصفها حاضنة للنظام العالمي المعادي لقضايا العرب والمسلمين العادلة، مثل قضية فلسطين وقضية الشعب السوري.
- دخولُ الإسلام كمكوّن إجتماعي وسياسي وانتخابي إلى أوروبا، وهو عاملٌ مؤثّر على ديموقراطيات الغرب. وقد بدأت معالمُه تبرز مع توالي الإعتراف بدولة فلسطين من قبل البرلمانات الأوروبية بهدف تبريد العلاقات مع مسلمي أوروبا. هذا مع قناعة أوروبية متزايدة بأن مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط إنما يكمنُ في إنجاز “حلّ الدولتين”، مع رفضٍ لاقتصار الدور الأوروبي على التمويل من دون فعالية سياسية تقريرية في هذا الشأن.
- بروز تيار مدني تجلّى في تونس ومصر وسيبرز في سوريا والعراق وبلدانٍ أخرى.
- محاولة قوى إقليمية غير عربية التحكّم بقرار المنطقة: اسرائيل- التي تدّعي احتكار الديموقراطية في المنطقة وتحاولُ أن تكون امتداداً للغرب في أرض الشرق، تركيا- التي تقدّم نفسها قوة إقليمية إسلامية قادرة على التفاعل مع العرب وفي الوقت نفسه قادرة على التفاعل مع النظام العالمي الجديد، وايران- التي تمددت بنفوذِها حتى وصلت إلى البحر في غزة وبيروت مروراً بعواصم اليمن والعراق وسوريا.
- محاولة روسيا الدخول إلى المنطقة من باب الكنيسة الأورثودكسية التي تشدّد على تمايزها عن كنيسة الغرب بوصفها مشرقية وقادرة على التفاعل مع الإسلام ومدافعة عن الأقليات في المنطقة.
- محاولة المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون الخليجي الحفاظ على نظام المصلحة العربية بحيث لا يتحول العالم العربي الى ضواحي قوى اقليمية غير عربية. هذا إلى جانب بروز القوة المالية العربية كحاجة في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية (انضمام المملكة العربية السعودية لمنتدى العشرين).
- عودة الكلام على مسألة الأقليات في المنطقة. من مسيحيين ويهود وأيزيديين وعلويين ودروز وشيعة وغيرهم، والذين بغالبيتهم ينظرون إلى أحداث المنطقة بعين القلق، ويبحثون عن أشكالٍ مختلفة من الحماية. فهناك من يطرح “تحالف الأقليات” وهناك من حاول استجداء حماياتٍ أجنبية.
10.”داعش” وتوابعها، التي أسقطت الحدود المرسومة بين الدول وفرضت معادلة العنف مقابل العنف و”الخلافة” في مواجهة “ولاية الفقيه والدولة الوطنية” معاً.
أيها الإخوة،
هذه المعطيات العشرة تشكّل في تقديري مدخلاً لقراءة أحداث العالم والمنطقة مما قد يساعدُنا في تحديدِ معالمَ الدولة الوطنية الحديثة القابلة للحياة والنمو والإزدهار، في عالمٍ قَيْدَ تحولاتٍ نوعية، مع التركيز على الحالة اللبنانية بخصوصياتها المعلومة، واستناداً – بطبيعة الحال – إلى خياراتٍ لا بد من اتخاذها.
لذلك سأبدأ بتحديد بعض المبادىء والخيارات الأساسية المتعلّقة بمفهوم “الدولة الوطنية” في لبنان، وإلى حدّ بعيد في العالم العربي:
- رغم تأثُّر اللبنانيين بوجه عام، والمسيحيين منهم خصوصاً، بثقافة عصر الأنوار الإوروبي التي أفضت هناك إلى اعتماد مفهوم الدولة – الأمة État-Nation، أي الدولة الصافية دينياً وعرقياً ولغوياً، والتي تطلَّب قيامُها حروباً وتصفيات دينية مرعبة (بين الكاثوليك والبروتستانت بصورة خاصة)، إلا أنهم – إي اللبنانيين – اختاروا منذ البداية مفهوم الدولة الوطنية، لمجتمعٍ متنوّع، والقائمة على “وطنيّةٍ سياسية لا دينية”، أي على فكرة المواطنة، كما جاء في خطاب البطريرك الياس الحويّك أمام مؤتمر السلام في باريس عام 1919 الذي تَبِعَه قيامُ دولة لبنان الكبير عام 1920 – واسمحوا لي أن أنقل إليكم ترجمة الفقرة المتعلّقة بموضوعنا من هذا الخطاب الذي كُتب بالفرنسية والذي لم يُنشر في لبنان سوى العام الماضي. يقول البطريرك في معرض كلامه، مخاطباً رئيس الوزراء الفرنسي آنذاك جورج كليمنصو بخصوص مطلب دولة لبنان الكبير:
” اسمحوا لي، سيادة الرئيس، أن ألْفِتَ عنايتكم إلى ميزة يتفرَّد بها مطلبنا هذا؛ وهي أنه للمرة الأولى في الشرق هناك من يريد إحلال “الوطنية السياسية” محلَّ “الوطنية الدينية”. وهذا أمرٌ عظيم الشأن، سوف تترتّب عليه نتائجُ بالغةُ الأهمية، كما لا يخفى على جنابكم. وعليه فإن لبنان المنشود يمتلك ملامح خاصة، بل شخصية خاصة، لا يجوز – ومن منظار الحضارة نفسها – التضحيةُ بها لأية اعتبارات مادية” (1).
- وإذا كان مفهوم الدولة اللبنانية، القائمة على وطنيةٍ سياسية لا دينية، قد ظلّ ملتبساً على مدى عقود، رغم استقلال 1943 والميثاق الوطني – وذلك بفعل الممارسة المتمادية للطائفية السياسية (2)، حتى بدا المشروع اللبناني في عين أهله وعيون الآخرين وكأنه مشروع طائفي بالأصل – إلا أن اتفاق الطائف لعام 1989 جاء ليضع أساساً سليماً لدولة وطنية، مدنية غير طائفية. ومفهوم الدولة المدنية في الواقع اللبناني، وبحسب اتفاق الطائف، يقوم على التوفيق بين حقوق المواطنين الأفراد – ولا حقوق إلا للمواطنين الأفراد – وبين ضمانات الجماعات. وذلك بإنشاء مجلسين: مجلس نيابي محرّر من القيد الطائفي، مع تحرير كل مؤسسات الدولة والإدارات العامة من هذا القيد، ومجلس شيوخ مقيَّد بالتمثيل الطائفي من شأنه توفير ضمانات للجماعات بوصفها متَّحدات ثقافية لا غير. مشكلةُ هذا الاتفاق الأساسية أنه وُضع في يد وصايةٍ سورية عطَّلته واستبدلت به مفاهيم نظام بوليسي تعرفونه جيداً، وما زال هذا النظام – حتى فيما هو يتصدَّع وينهار – يمارس شتّى أشكال التهديم بالصيغة اللبنانية، ما استطاع إلى ذلك سبيلاً بواسطة أذرعه التي تعرفونها أيضاً.
- إن تجربة الدولة الوطنية في لبنان تزامنت مع صعود موجات سياسية ودينية في المنطقة حاولت نَقْضَ تلك التجربة:
- إذا تجاوزنا فترة الانتداب الفرنسي 1920-1943، وبلحاظ قيام دولة اسرائيل العنصرية عام 1948، تكون التجربة اللبنانية قد حظيت بخمس سنوات فقط من الظروف المؤاتية إقليمياً ودولياً. علماً أن فترة السنوات الخمس تلك شهدت تفاهماً عميقاً بين الحركتين الوطنيتين في لبنان وسوريا، ما جعلهما يدخلان مفاوضات الجلاء عام 1946 بوفد مشترك رئسه حميد فرنجية الماروني، متقدّماً على أقرانه في البلدين بفضل مصداقيته العربية وصلابته الاستقلالية. وفي تقديري، وتقدير أمثالي من المسيحيين والمسلمين اللبنانيين، فإن العامل الإسرائيلي كان على الدوام الناقض والنقيض الأول للنموذج اللبناني.
- مع قيام دولة اسرائيل وتوالي الحروب العربية – الاسرائيلية، صعدت موجةٌ راديكالية عروبية في المنطقة، نهضت على رافعة انقلابات عسكرية وحزبية ايديولوجية، ورأت إلى لبنان كياناً مصطنعاً بفعل “مؤامرة سايكس-بيكو”، وخاصرةً رخوة في جدار الصمود العربي بفعل نموذجه السياسي – الانساني غير المتطرّف. تلك كانت نظرة العروبيين إلى لبنان، من قومويين وبعثيين وسواهم، الذين فهموا العروبة على أنها مشروع سياسي فوريّ لأمة ناجزةِ التكوين والفكرةِ الناظمةِ، ولا ينقصه سوى زعامة ذات كاريزما طاغية تُلغي الكيانات على الطريقة البسماركية. بلحاظ هذه المفاهيم الرائجة نظرَ معظم اللبنانيين الكيانيين بعين القلق إلى التيار العروبي.
- مع تراجع حركة القومية العربية بعد 1967، صعدت منذ ثمانينيات القرن الماضي موجةُ الإسلام السياسي الذي دَرَج على طريقة القومويين في نظرتهم إلى الكيانات الوطنية، غيرَ مؤمنٍ بشرعية هذه الكيانات، وعاملاً في الفترة الراهنة على إلغاء الحدود الوطنية بقوة العنف المسلّح وحتى الإرهابي (الإخوان المسلمون في مصر، والعنف الجهادي القاعدي والخميني في سوريا والعراق ولبنان…). إن موجةَ الإسلام السياسي – أكانت بصيغة السلفية الإخوانية، أو السلفية الشيعية الدعوتية (نسبة إلى حزب الدعوة) والخمينية – بدت وتبدو، أكثر من سابقتها القومية، مناقضةً لمفهوم الدولة الوطنية، لا سيما في مجتمعات تعددية التكوين. وبلحاظ هذه الوقائع أيضاً نظر معظم اللبنانيين الكيانيين وينظرون بعين القلق إلى تيار الاسلام السياسي، لا سيما إلى القوى العنفيَّة فيه. وأنا هنا لا أعني مطلقاً بعضَ الأقلّويين “اللبنانيين الذين ينظرون بعين القلق إلى “الربيع العربي” باعتباره في تقديرهم ومنطوق دعايتهم مشروعَ إسلام سياسي عنفيّ.
فهذا الربيع جدير بإسمه في ما حققه من إصلاح في تونس، وتقويم في مصر، في إطار الدولة الوطنية المدنية، كما يدخلُ فيه – بحسب فهمي – كلُّ الإصلاحات الجارية من قِبَل الحكومات الرشيدة في عدد من البلدان العربية الأخرى، لا سيما المملكة العربية السعودية ودول الخلييج والأردن ومصر… إصلاحات تسير جنباً إلى جَنْبِ محاربةِ الإرهاب.
- بَيْدَ أن مشكلة الدولة الوطنية في لبنان، كما في معظم المنطقة العربية على ما أشرنا، مع تياري العروبة السياسية والإسلام السياسي، لا تعني (تلك المشكلة) أن هناك تناقضاً مبدئياً أو غائياً مع الإسلام والعروبة باعتبارهما معطيين حقيقيين وإيجابيين في تكوين شخصية المنطقة، كما في أي جهد لصياغة نظام المصلحة العربية الجامعة إلى جانب أنظمة المصالح الإقليمية والدولية المتباينة. كلُ ما في الأمر أن هناك حاجةً ماسَّة لإعادة تعريف العروبة والإسلام في ضوء تطورات العصر، وخصوصاً بلحاظ التشويهات القاتلة التي أصابت المفهومين جرَّاء ممارسات خاطئة متمادية على مدى عقود. وهو ما تنبّه إليه تفكيرٌ عربي تنويري في السنوات الأخيرة، مثلما يتنبّه إليه اليوم تفكيرٌ إسلامي في بعض مواقع المسؤولية الدينية والثقافية والسياسية:
- بخصوص إعادة تعريف العروبة، أو ما يسميه البعض تجديد معنى العروبة الحضارية، لعلَّ “إعلان الرياض” الصادر عقِب القمة العربية أواخر آذار 2007 يمثّل النصّ العربي الرسمي الأكثر أصالةً وتجدداً في هذا الصدد. فهو يعرّف العروبة بوصفها رابطة ثقافية حضارية، لا مشروعاً سياسياً، تشجّع كل معاني التوسُّط والاعتدال والانفتاح والحوار والتسامح والحرية والديموقراطية وحقوق الانسان… وهي بذلك إنما تؤسس لثقافة سلام دائم في المنطقة، كما تساهم في ترقية الحضارة الانسانية. إن دعوة هذا “الإعلان” تربط بأصالة مع تجربة العرب الحضارية في الأندلس على مدى قرون، مثلما تربط مع السؤال الراهن الذي بات يشكل التحديّ الأكبر في عالم اليوم، وهو: “كيف نعيش معاً بسلام، متساوين ومختلفين؟”. لقد قرأ اللبنانيون المتنوّرون في “إعلان الرياض” لغةَ عيشهم المشترك الأصليَّة، كما استذكروا دورهم المشهود في “النهضة العربية الحديثة” عندما كانت العروبة رابطةً ثقافية وسعياً للترقّي الحضاري. في جانب آخر، متعلّقٍ بمعنى العروبة، نلاحظ اليوم تنبُّهاً شديداً – ولو جاء متأخراً – لنظام المصلحة العربية الجامعة وسط أجندات إقليمية ودولية متصارعة في المنطقة وعليها. ولعلَّ مبادرات خادم الحرمين الشريفين المتلاحقة منذ سنوات لإجراء المصالحات العربية، ولا سيما مبادرته المستمرة منذ سنة ونصف لحماية الوطنية المصرية، تشكل المَعْلَم الأبرز لهذه اللحظة من منظور عربي سليم ورؤيةٍ استراتيجية.
- بخصوص إعادة تعريف الإسلام في وعي أبنائه كما في وعي الآخر غير المسلم لا سيما في الغرب، انطلقت – ولو متأخرةً جداً – ورشةُ عملٍ وتفكير على خطّ الأزهر – مكّة بصورة أساسية، من أجل إعادة الاعتبار إلى قيمة الاعتدال في صحيح العقيدة والثقافة الاسلاميين. ولنعترفْ بأن هذه الورشة إنما انطلقت مؤخراً تحت ضغط شديد لظواهر ثلاث مجتمعة: ظاهرة العنف الإرهابي المتلبّس بالعقيدة الاسلامية، والذي يزعم أنه يريد إحياء الإسلام بدولة الخلافة أو الإمامة؛ وظاهرة نجاح هذا العنف في خلق بؤرٍ اجتماعية حاضنة، من دون أن يكون لحضانتها هذه علاقة حقيقية بصحيح الاسلام؛ وظاهرة الإسلاموفوبيا في الغرب التي تقول جملة واحدة مفادُها أن الإرهاب من صُلب تعاليم الإسلام الذي لا يمكنه – والحالة هذه – أن يكون عامل استقرار في المنطقة والعالم. من الواضح إذاً أن تصحيح صورة الإسلام هي حاجة إسلامية وعربية في المقام الأول. ويبدو واضحاً أيضاً، من خلال الاجتماع الإسلامي – المسيحي الأخير في القاهرة لتلك الغاية، أن المسألة ليست مجرَّد جهد دعائي تجميلي، وإنما هي في العمق جهدٌ فقهيّ تثقيفي تربوي على مدى طويل. ولكنّ الإنصاف يدعونا أيضاً إلى القول بأن هذا الجهد الأخير ليس الأول في مجاله. فقد سبقته محاولات جادّة في بعض الدول العربية لتصحيح وضعية الدعوة والدعاة أسلوباً ومضموناً، لا سيما بعد حادثة 11 أيلول/ سبتمبر 2001 في نيويورك. كذلك أرى أن بعض المبادرات الإسلامية الكبرى التي انطلقت وما زالت عاملةً تحت عنوان “حوار الأديان والثقافات من أجل السلام” تندرج بقوة في إطار تصحيح صورة الإسلام؛ ولقد كان لها أثرٌ طيّب في هذا المجال. كما ولا يسعنا إلا التنويه بمراكز وهيئات الحوار الإسلامي – المسيحي في المنطقة العربية والشرق الأوسط التي تعمل منذ عقود بوتائر قد تتقطَّع أحياناً، ولكنها تؤمّن استمرارية محمودة.
- إذا كانت مشكلة الدولة الوطنية لا تلخّص مشكلات المنطقة العربية بأسرها، إلا أنها متصلة بكل تلك المشكلات. ولا أبالغُ إذا قلت أن هذه اللحظة التاريخية هي لحظة مصيرية على مستوى كل العالم العربي في إطارِ مخاضٍ إقليمي ودولي شديد الاحتدام. وأعتقد أن مصيرنا رهنٌ بقدرة الاعتدال العربي على التعاون والتناصر والتوحُّد في مواجهة كل أشكال التطرُّف. لذلك فإن دعوتي هي: يا معتدلي العالم العربي والإسلامي إتّحدوا!6
——
- وثائق البطريرك الحويّك السياسية، الوثيقة 108 بالفرنسية، ص 118، منشورات المركز الماروني للتوثيق والأبحاث، بعناية الخوري اسطفان ابراهيم الخوري، الطبعة الأولى بيروت 2013.
- لنتذكّر أن الطائفية السياسية اعتُمدت بدايةً كتدبير مؤقَّت، التماساً لطمأنة النفوس والتوازن في الكيان الجديد، على أن يتمَّ التخلص منها في أسرع ما يمكن، كما جاء في بيان الحكومة الاستقلالية الأولى عام 1943 برئاسة رياض الصلح.