ترجمة: بيار عقل
مقدمّة كتاب “إنتصار العقل: كيف أدّت المسيحية إلى الحرية، والرأسمالية، ونجاح الغرب
Rodney Stark
The Victory of Reason
How Christianity Led to Freedom, Capitalism and Western Success
العقل والتقدّم
حينما شرع الأوروبيون باستكشاف الكرة الأرضية، فإن أكثر ما فاجأهم لم يكن وجودَ نصف الكرة الغربي بل مدى تفوّقهم التكنولوجي على بقية العالم. فلم تكن أمم “المايا” و”الأزتك” و”الإنكا” الفخورة عاجزة في وجه الغزاة الغربيين فحسب؛ بل إن الصين، والهند، وحتى بلاد الإسلام، كانت متأخّرة بالمقارنة مع أوروبا القرن السادس عشر. كيف حدث ذلك؟ كيف حدث أن حضارات عديدة مارست “الخيمياء”، ولكن “الخيمياء” تحوّلت إلى “كيمياء” في أوروبا وحدها؟ كيف حدث أن الأوروبيين ظلّوا، طوال قرون، الوحيدين الذين يملكون النظّارات، أو المِدخنة المنزلية، أو الساعات الدقيقة، أو الخيّالة الثقيلة، أو نظام النوتة الموسيقية؟ ما الذي أتاح لأمم نشأت من البربرية ومن حطام روما الساقطة أن تتجاوز بقية العالم إلى هذه الدرجة؟
اكتشف عدد من الكتاب الحديثين سرّ الحضارة الغربية في الجغرافيا. ولكن الجغرافيا نفسها ظلّت لأمد طويل أساساً لثقافات كانت متأخرة جداً عن ثقافات آسيا. وعزا كتّاب آخرون نهوضَ الغرب إلى الفولاذ، والسفن الشراعية، وعزاهُ سواهم إلى الزراعة الأوروبية الأعلى إنتاجيةً. إن المشكلة هي أن تلك الإجابات هي، نفسها، جزء من الإسئلة التي تظل بحاجة لإجابات: فالسؤال هو لماذا تفوّق الأوروبيون في صناعة الفولاذ، أو بناء السفن، أو الزراعة؟ الجواب الأكثر إقناعاً عن الإسئلة السابقة يعزو السيطرة الغربية إلى نشوء الرأسمالية، الذي لم يحدث إلا في أوروبا وحدها. إن ألدّ أعداء الرأسمالية يقرّون لها بأنها خلقت مستوىً من الإنتاجية ومن التقدّم لم يحلم به البشر من قبل. وقد جاء في “المانيفستو الشيوعي” الذي حرّره كارل ماركس وفريدريك أنغلز أنه، قبل نشوء الرأسمالية، كان البشر يعيشون في “خُمولٍ لا حدودَ له” وأن النظام الرأسمالي كان “أول نظام يُظهر ما يمكن للنشاط الإنساني أن يحقّقه.. وقد خلق قوى إنتاجية أكبر وأعظم مما خلقته كل الأجيال السابقة مجتمعة”. وقد حقّقت الرأسمالية هذه “المعجزة” بواسطة إعادة التوظيف المنتظمة للرساميل من أجل زيادة الإنتاجية- إما بإيجاد قدرات جديدة أو عبر تحسين التكنولوجيا- وعبر إيجاد الحوافز للإدارة وللعمال معاً عبر الرواتب المتزايدة باستمرار.
إذا ما افترضنا أن الرأسمالية هي التي أنتجت قفزة أوروبا الكبرى إلى الأمام، فسيظلّ علينا أن نفسّر لماذا تطوّرت الرأسمالية في أوروبا وحدها. لقد اكتشف البعض جذور الرأسمالية في “الإصلاح البروتسنتي”. وأعادها سواهم إلى ظروف سياسية مختلفة. أما إذا تعمّقنا في البحث عن الأسباب، فسيتّضح لنا أن الأساس الجوهري الحقيقي الذي قامت عليه ليس الرأسمالية وحدها، بل ونهوض الغرب، هو الإيمان الإستثنائي بـ”العقل”.
يستكشفُ كتابُ “انتصار العقل” (The Victory of Reason) سلسلةً من التطوّرات التي انتصر فيها العقل، الأمر الذي اعطى الثقافة الغربية ومؤسسات الغرب شكلها الفريد. وقد حدث أهمّ تلك الإنتصارات ضمن المسيحية نفسها. ففي حين ألحّت أديان العالم الأخرى على المعنى الباطني والحَدس (mystery and intuition)، فإن المسيحية وحدها اعتنقت العقل والمنطق كدليل أوّلي للحقيقة الدينية. لقد تأثّر الإيمانُ المسيحي بالعقل بالفلسفة اليونانية. ولكن الحقيقة الأهم في هذا المجال هي أن الفلسفة اليونانية بالكاد أثّرت في الأديان اليونانية. فقد ظلت الأديان اليونانية طقوساً سرّية نموذجية، وكان يُنظَرُ إلى ما فيها من غموض وتناقضات منطقية كدليل قاطع على أصولها المقدّسة. وقد سادت فرضيات مشابهة حول تعذّر تعليل الآلهة وحول التفوّق الفكري للإستبطان (introspection) كلَّ أديان العالم الرئيسية الأخرى. ولكن آباء الكنسية علّموا، منذ البدايات الأولى، أن العقل كان أعظم هبات الله وأنه الوسيلة الناجعة لكي يحقّق البشر يتزايد أكثر فأكثر فهمُ البشر للكتاب المقدس والوحي. وتبعاً لذلك، كانت وُجهة المسيحية هي المستقبل، في حين أكّدت الأديان الأخرى تفوّقَ الماضي. وعلى الأقل من حيث المبدأ، وإن لم يتحقّق ذلك في الواقع دائماً، كان ممكناً على الدوام تعديل العقائد المسيحية بإسم التقدّم الذي يعبّر عنه العقل. لقد تشرّبت الثقافة الغربية الإيمان بقوة العقل الذي روّج له “السكولاستيون” وجسّدته الجامعات العظيمة التي أسّستها الكنيسة، وشكّل ذلك حافزاً قوياً للبحث العلمي ولتطوّر النظرية والممارسة الديمقراطية. وكان نشوء الرأسمالية، كذلك، إنتصاراً للعقلانية التي أوحت بها الكنيسة، لأن الرأسمالية هي، بالأساس، التطبيق المنهجي والدائم للعقل في ميدان التجارة- وهذا ما حدث تاريخياً لأول مرة في الإقطاعات الكبيرة التي كانت الأديرة تملكها.
إبان القرن الماضي، نزعَ المثقفون الغربيون بدون تحفّظ إلى ردّ الإمبريالية الغربية إلى أصولها المسيحية، ولكنهم ظلّوا يمانعون كلياً في الإقرار بأن المسيحية قدّمت أي إسهام (ما عدا عدم التسامح) لقدرة الغرب على السيطرة على العالم. بالأحرى، يزعم هؤلاء أن الغرب لم يحقّق قفزته الكبرى سوى حينما تخطّى الحواجز الدينية التي كانت تعيق التقدّم، وخصوصاً الحواجز الدينية التي كانت تعيق العِلم. وهذا هُراء. إن نجاح الغرب، بما فيه نهضة العلوم، قد قام كلّياً على أسس دينية، والذين حقّقوا النهضة العلمية كانوا مسيحيين أتقياء. ولسوء الحظ، فحتى العديد من المؤرّخين الذين قبِلوا بأن يعترفوا للمسيحية بدورٍ في صنع تقدّم الغرب، كانوا على العموم يقتصرون على التذرّع بالآثار الدينية النافعة لـ”الإصلاح البروتستنتي”. ومن وجهة النظر هذه، يبدو أن القرون الخمسة عشر الأولى من المسحية كانت إما غير مؤثّرة كثيراً أو حتى ضارّة. إن مثل هذه المواقف الأكاديمية المعادية للكاثوليكية هي التي أوحت بأشهر كتاب عن أصول الرأسمالية.
في مطلع القرن العشرين، نشر عالم الإجتماع الألماني “ماكس فيبر” ما أصبح، خلال فترة وجيزة، دراسة بالغة التأثير: “الأخلاق البروتسنتية وروح الرأسمالية” (The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism). وفي ذلك الكتاب، عرض أن الرأسمالية نشأت في أوروبا وحدها لأنه، من بين كل أديان العالم، فإن البروتستنتية وحدها وفّرت الرؤيا الأخلاقية التي دفعت البشر لكبح إستهلاكهم المادي مع السعي الحثيث لزيادة ثروتهم. وعرض “فيبر” أنه، قبل “الإصلاح البروتسنتي” كان الإمتناع عن الإستهلاك يرتبط بالزهد وبالتالي بإدانة التجارة. وعلى النقيض، كان السعي لتحقيقِ الثروات يرتبط بالإستهلاك المُسرَف. وكان كلا هذين النمطين مناوئاً لنشوء الرأسمالية. ويعتبر “فيبر” أن الأخلاقَ البروتستنتية حطّمت هذه الصلات التقليدية، وخلقت ثقافةً تقوم على رجال أعمال متقشّفين يكتفون بإعادة توظيف أرباحهم بصورة منتظمة سعياً لتحقيق ثروة أعظم، وفي ذلك يكمن المدخل لفهم الرأسمالية ولفهم تفوّق الغرب.
ربما كانت أناقة أطروحة “ماكس فيبر” هي التي أدّت لاعتناقها على على نطاق واسع جدّاً مع أنها أطروحة خاطئة بداهةً. وحتى في يومنا هذا، فإن كتاب “الأخلاق البروتسنتية” يتمتّع بمكانة مقدّسة بين علماء الإجتماع، مع أن المؤرّخين الإقتصاديين سرعان ما استخفّوا بمقالة “فيبر” (التي تفتقد إلى التوثيق بصورة تدعو إلى الدهشة) إنطلاقاً من أسُس لا سبيل لدحضها تتمثّل في أن نهوض الرأسمالية في أوروبا سبق “الإصلاح البروتستنتي” بعدة قرون. وكما كتب “هيو تريفور روبير (Hugh Trevor-Roper) ، فإن “فكرة أن الرأسمالية الصناعية على نطاق واسع كانت مستحيلة إيديولوجياً قبل الإصلاح البروتستنتي تُدحض لمجرّد أن تلك الرأسمالية قد وُجِدَت فعلاً”. وبعد عقدٍ واحد من ظهور كتاب “فيبر”، عرض الكاتب الأميركي الشهير “هنري بيرين” (Henri Pirenne) وثائق كثيرة “تثبت واقعة أن كل السمات الأساسية للرأسمالية– المشروع الفردي، التقدّم في القروض، الأرباح التجارية، المضاربة، إلخ.- كانت موجودة منذ القرن الثاني عشر، في الجمهوريات- المدن الإيطالية، أي البندقية، وجنوى، وفلورنسة”. وبعد جيل واحد، تذمّر المؤرّخ الفرنسي الشهير “فرنان بروديل” (Fernand Braudel) من أن “جميع المؤرّخين عارضوا تلك النظرية الواهية (حول الأخلاق البروتستنتية)، مع أنهم لم ينجحوا في القضاء عليها بصورة نهائية. إنها نظرية خاطئة بدون أدنى شك. فقد احتلت بلدان أوروبا الشمالية الموقع الذي كات المراكز الرأسمالية القديمة في المتوسّط قد شغلته لمدة طويلة وبصورة باهرة. وهي (أي بلدان أوروبا الشمالية) لم تخترع جديداً، سواءً في التكنولوجيا أو في إدارة الأعمال”. علاوة على ذلك، فإبان الفترة الحاسمة لنموّها الإقتصادي، كانت مراكز الرأسمالية في شمال أوروبا كاثوليكية، وليس بروتستنتية- فالإصلاح البروتستنتي جاء بعد ذلك بقرون.
من زاوية أخرى، أشار “جون غيلكريست” (John Gilchrist)، وهو مؤرّخ بارز للنشاطات الإقتصادية للكنيسة في القرون الوسطى، إلى أن النماذج الأولى للرأسمالية ظهرت في أديرة الرهبان المسيحيين الكبيرة. ثم أن من الثابت أنه حتى في القرن التاسع عشر، لم تكن المناطق والأمم البروتستنتية في أوروبا القارية متقدّمة إلى درجة محسوسة عن العديد من المناطق الكاثوليكية- وهذا رغم “تأخّر” إسبانيا.
لكن، مع أن “ماكس فيبر” كان مخطئاً، فإنه كان مصيباً حينما افترض أن الأفكار الدينية لعبت دوراً حيوياً في نهوض الرأسمالية في أوروبا. إن الشروط المادية التي كان لا بدّ منها لنشوء الرأسمالية كانت موجودة في عدة حضارات وفي حقبات مختلفة، بما فيها الصين، والإسلام، والهند، وبيزنطية، وربما روما القديمة وبلاد الإغريق كذلك. ولكن أياً من تلك المجتمعات لم يحقق الإختراق الذي سمح بنشوء الرأسمالية، تحديداً لأن أيا منها لم يطوّر رؤىً أخلاقية تتناسب مع هذا النظام الإقتصادي الدائم الحركة. بالعكس، كانت أبرز الأديان خارج الغرب تدعو إلى الزهد وتندّد بالأرباح، وذلك في حين كانت الثروات تُغتَصَبُ من الفلاحين ومن التجّار على أيدي نُخَبَ نهّابة جشعة كرّست حياتها لإظهار الثروات واستهلاكها. لماذا تطوّرت الأمور بصورة مختلفة في أوربا؟ بسبب الإلتزام المسيحي باللاهوت العقلاني- الأمر الذي ربما لعب دوراً في حدوث الإصلاح البروتستنتي ولكنه، بالتأكيد، سبق البروتستنتية بأكثر بكثير من ألف عام.
لكن، حتى مع ذلك، فالرأسمالية تطوّرت في بعض الأماكن فقط. لماذا لم تتطوّر في كل أنحاء أوروبا؟ لأنه في بعض المجتمعات الأوروبية، كما في معظم أنحاء العالم الأخرى، فقد حال طغاة جشعون دون حدوثها: فالحرية أيضاً كانت شرطاً لازماً لتطوّر الرأسمالية. ويثير ذلك موضوعاً آخر: لماذا نَدَرَ أن وُجِدَت الحرية في معظم أنحاء العالم، وكيف ترعرعت في بعض دول أوروبا في القرون الوسطى؟ ذلك، بدوره، كان إنتصاراً للعقل. فقبل أن تجرّب أي من دول أوروبا في القرون الوسطى الحكمَ بواسطة مجالسَ منتَخَبة، كان اللاهوتيون المسيحيون قد سبقوها منذ أزمنة بعيدة بالتنظير حول طبيعة المساواة وحقوق الأفراد- بل إن الأعمال للاحقة لمنظّري القرن الثامن عشر “العلمانيين”، مثل “جون لوك”، استندت صراحةً إلى المقدّمات الداعية للمساواة التي تعود أصولها إلى علماء الكنيسة.
لكي نوجز، قامت نهضة الغرب على أربعة إنتصارات للعقل. أولها كان تطوّر الإيمان بالتقدّم ضمن اللاهوت المسيحي. وكان الثاني ترجمة ذلك الإيمان بالتقدّم إلى إبتكارات تكنولوجية وتنظيمية، تطوّر العديد منها في إقطاعات الأديرة الكبيرة. أما الثالث فقد تمثّل في أنه، بفضل اللاهوت المسيحي، فقد شكّل العقل مرشداً للفلسفة السياسية وللممارسة السياسية، وذلك إلى درجة أن دولاً “مستجيبة” (responsive states)، تحتضن درجة مرتفعة من الحرية الشخصية، ظهرت في أوروبا القرون الوسطى. أما الإنتصار الأخير فتمثّل في اعتماد العقل في التجارة، الأمر الذي نجم عنه تطوّر الرأسمالية ضمن الملاذات الآمنة التي وفّرتها الدول المُستَجيبة. تلك كانت الإنتصارات التي سمحت للغرب بالفوز.
**
نِعَم اللاهوت العقلاني (الفصل الأول)
سمعة اللاهوت لدى معظم المثقفين الغربيين سيئة. فهذه الكلمة تُفهم كشكل ماضوي من أشكال التفكير الديني يعتنق اللاعقلانية والدوغمائية. وتعاني “السكولاستية” من نفس النظرة. وحسب قاموس “ويبستر” (الأميركي)، فإن “سكولاستي” تعني “متحذلق ودوغمائي”، في إشارة إلى عُقم الثقافة الكَنَسية في القرون الوسطى. وكان الحكم القاطع للفيلسوف الإنكليزي “جون لوك” في القرن الثامن عشر هو أن “السكولاستيين” هم “أعظم نُحّات” التعابير عديمة الفائدة التي لا تفيد سوى في “تغطية جهلهم”. ذلك ليس صحيحاً! فـ”السكولاستيون” كانوا أصحاب فكرٍ راقٍ أسّسوا الجامعات الكبرى في أوروبا واستهلّوا صعود العِلم الغربي. أما “اللاهوت”، فصلته، بشكل عام، ضئيلة بعظم الفكر الديني، حيث أنه نوع معرِفي متطوّر، وعقلاني جداً بَلَغَ ذُروة تطوّره ضمن المسيحية وحدها.
يوصفُ “اللاهوت” أحياناً بأنه “علم الإيمان”، وهو يقوم على “التفكير المنطقي الشكلي (أي المنهجي) في موضوع الله”. يركّز “اللاهوت” على إكتشاف طبيعة الله، ومقاصده، ومقتضياته، وعلى فهم دورها في تحديد العلاقة بين البشر والله. إن آلهة الأديان المتعددة الآلهة لا تصلح كأساس لـ”اللاهوت” لأنها غير منطقية وقليلة الأهمية. فـ”اللاهوت” يقتضي صورة لله ككائن واعٍ، وعقلاني، وفوق طبيعي يملك قدرة ونطاقاً غير محدودين يهتمُّ بالبشر ويفرض عليهم قواعد أخلاقية ومسؤوليات أخلاقية، الأمر الذي تتولّد عنه أسئلة فكرية أساسية من نوع: لماذا يسمح لنا الله بأن نرتكب الخطيئة؟ هل تحظر الوصيّة السادسة (من الوصايا العشر) الحرب؟ متى يصبح للجنين روح؟
لكي نفهم طبيعة اللاهوت بصورة وافية، من المفيد أن نتطرّق إلى مسألة عدم وجود مُشتَغِلين بـ”اللاهوت” في الشرق. في “التاوية” مثلاً. إن “التاو” يُعتَبَر جوهراً فوق طبيعي، ومبدأً أو قوة باطنية تحكم الحياة، سوى أنها غير شخصية، وبعيدة، ومفتقدة للوعي، وهي حتما ليست “كائناً”. إنه “الطريق الخارجية الأبدية”، القوة الكونية التي تنتج الإنسجام والتوازن. ووفقاً لـ”لاو تزو”، فإن “التاو” يكون “دائماً غير موجود” سوى أنه “موجود دائماً”، وهو “غير قابل للتسمية” و”الإسم الذي يمكن تسميته”. وهو، في آنٍ واحد، “بدون صوت وبدون شكل”، و”دائماً بدون رغبات”. يستطيع المرء أن يتأمّل إلى الأبد في مثل هذا الجوهر، ولكنه لا يتضمّن ما يسمح بإدراكه عقليا. وينطبق ما سبق على البوذية والكونفوشية. حقّاً أن النماذج الشعبية من هذين الدينين تقوم على تعدّد الآلهة وتشتمل على عدد كبير من الآلهة الصغيرة (وهذا يصحّ على “التاوية” الشعبية كذلك)، فإن الأشكال “الصافية” لهذه الأديان، كما تعتنقها النخبة الفكرية، تخلو من فكرة الإله وتقوم على جوهر إلهي غامض- وقد أنكر بوذا، بصورة واضحة، وجودَ إلهٍ واعٍ.
خلا الشرق من “اللاهوتيين” لأن الذين كان يمكن أن يشتغلوا بـ”اللاهوت” يرفضون مقدّمته الضرورية الأولى: وجود إلهٍ واعٍ، كلي القدرة.
على نقيضِ ما سبق، كرّس علماء اللاهوت المسحيون عدة قرون للتفكير المنهجي في ما كان الله يقصده فعلاً في مقاطع الكتاب المقدّس، ومع الوقت فإن التأويلات غالباً ما تطوّرت بطرق مثيرة وشاملة. وعلى سبيل المثال، الكتاب المقدس لا يدينُ التنجيم إطلاقاً، بل إن قصة المجوس الذين يتبعون النجم يمكن أن يُفهم منها أن التنجيم علم صحيح. ولكن القديس أغوسطينوس خَلَص منطقياً إلى أن التنجيم خاطئ لأن الإعتقاد بأن مصير الإنسان مُقدّر ومحتوم مسبقاً بالنجوم يتعارض مع هِبة الإرادة الحرّة التي أعطاها الله للإنسان. وعلى نحو مشابه، مع أن كثيرين من المسيحيين الأوائل، بما فيهم القديس بولس الرسول، كانوا يعتقدون بأنه كان ليسوع المسيح أخوة، وُلدوا من مريم وكان يوسف أباهم، فقد تعارضت وجهة النظر هذه بصورة متزايدة مع وجهات النظر اللاهوتية الناشئة حول مريم. وتمّ حسم هذه المسألة بصورة نهائية في القرن الثالث عشر، حينما قام القديس توما الأكويني يتحليل عقيدة ولادة المسيح من العذراء مريم ليخلصَ إلى أن مريم لم تَلِد أبناء آخرين: “وهكذا فإننا نجزم بدون أي تحفّظ بأن أم الله حَمَلت وهي عذراء، وولدت وهي عذراء، وظلّت عذراء بعد الولادة. وأن إخوة الرب لم يكونوا أشقاء طبيعيين، مولودين من الأم نفسها، بل أقارب بالدم”.
إن الخلاصات السابقة لا تشكّل مجرّد شروحات على هامش، أو تضخيم، لنصوص الكتاب المقدّس. فكل منها يمثّل نموذجاً للتفكير الاستنتاجي الجدي الذي يؤدي إلى عقائد جديدة: فبالنتيجة، حظرت الكنيسة التنجيم فعلاً، وما تزال عّذرية مريم الدائمة هي العقيدة الكاثوليكية الرسمية. وكما تظهر هذه الأمثلة، فقد كان بوسع عقول جبّارة، وقد فعلت ذلك فعلاً، أن تحدث تحوّلاً كبيراً جداً في عقائد الكنيسة أو حتى أن تغيّرها إلى نقيضها استناداً إلى مجرد التفكير المنطقي المُقنِع. إن أحداً لم يفعل ذلك أفضل من أغوسطينوس والأكويني، اللذين كان لهما تأثير لا يُضاهى. بالطبع، فقد سعى ألوف علماء اللاهوت الآخرون للتأثير في عقائد الكنيسة. فنجح بعضهم، وتعرّضت وجهات نظر معظمهم للإهمال، بل وتم نبذُ وجهات نظر البعض ووُصموا بالهرطقة: والفكرة هنا هي أن أي عرض دقيق لأي جانب من جوانب “اللاهوت” المسيحي ينبغي أن يستند إلى أقوال شخصيات رئيسية تمثّل مرجعاً. فمن السهل أن يجمع المرء عدداً من الإستشهادات ليثبت وجود كل أنواع المواقف الغريبة، ويكفي لذلك أن ننتقي بعضاً من أعمال ألوف علماء اللاهوت المسيحيين الصغار الذين كتبوا خلال الألفي عامين الماضيين. أن مثل هذا المنحى شائع جداً. ولكنه ليس المنحى الذي سأعتمده. فسأستشهد باللاهوتيين الصغار فقط حينما عبّروا عن وجهات نظر صادقَ عليها كبار علماء اللاهوت، ومع مراعاة أن موقف الكنيسة المُعتَمَد من العديد من المسائل قد تطوّر غالباً، وأحياناً إلى حد نقض تعاليمٍ سابقة.

القديس أغسطينوس بريشة فيليب دي دي شامباني، القرن 17. (13 نوفمبر 354 – 28 أغسطس 430) كاتب وفيلسوف من أصل نوميدي-لاتيني ولد في طاغاست (حاليا سوق أهراس، الجزائر) . يعد أحد أهم الشخصيات المؤثرة في المسيحية الغربية. تعتبره الكنيستان الكاثوليكية والأنغليكانية قديسا وأحد آباء الكنيسة البارزين وشفيع المسلك الرهباني الأوغسطيني. يعتبره العديد من البروتستانت، وخاصة الكالفنيون أحد المنابع اللاهوتية لتعاليم الإصلاح البروتستانتي حول النعمة والخلاص. وتعتبره بعض الكنائس الأورثوذكسية مثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قديسا.
ولد في مملكة نوميديا التي كانت مقاطعة رومانية من أمه الأمازيغية القديسة مونيكا وأبيه الوثني باتريسيوس الأفريقي-اللاتيني. تلقّى تعليمه في روما وتعمّد في ميلانو. مؤلفاته – بما فيها الاعترافات، التي تعتبر أول سيرة ذاتية في الغرب – لا تزال مقروءة في شتى أنحاء العالم.
لم يكن اللاهوتيون المسيحيون البارزون مثل أغوسطينوس والأكويني من مركّبي المعاني (التركيبية constructionism تعني جمع المعلومات حول قضية معينة من مجالات معرفية مختلفة وضبطها بمعنى واحد) بالمعنى الدقيق للكلمة. بالأحرى، فقد مجّدوا العقل كوسيلةٍ لادراك افضل للنوايا الإلهية. وكما أعلن “كوينتوس تيرتوليان” في القرن الثاني للميلاد: “العقل هو شيء من الله، بقدر ما أنه ليس هنالك شيء لم يوفّره الله، وهو صانع كل شيء، ولم يأمر به سوى بالعقل- وليس هنالك شيء أراد الله أن نتعامل معه وأن نفهمه بغير العقل”. وبالروحية نفسها، حذّر “كليمنت الإسكندراني” في القرن الثالث قائلاً: “لا تظنّ أننا نقول أن هذه الأمور ينبغي تلقّيها بالإيمان وحده، بل إنه ينبغي تأكيدها بواسطة العقل ايضاً. فالحق أنه ليس سليماً أن نعهد بهذه الأمور إلى الإيمان المجرّد من العقل، لأنه من المؤكّد أن الحقيقة لا يمكن أن تتجرّد من العقل”.
![من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة توما الأكويني (راهب دومينيكاني) (بالإيطالية: Tommaso d'Aquino) (1225 - 1274) قسيس وقديس كاثوليكي إيطالي من الرهبانية الدومينيكانية، وفيلسوف ولاهوتي مؤثر ضمن تقليد الفلسفة المدرسية. أحد معلمي الكنيسة الثلاثة والثلاثين، ويعرف بالعالم الملائكي (Doctor Angelicus) والعالم المحيط (Doctor Universalis). عادة ما يُشار إليه باسم توما، والأكويني نسبته إلى محل إقامته في أكوين. كان أحد الشخصيات المؤثرة في مذهب اللاهوت الطبيعي، وهو أبو المدرسة التوماوية في الفلسفة واللاهوت. تأثيره واسع على الفلسفة الغربية، وكثيرٌ من أفكار الفلسفة الغربية الحديثة إما ثورة ضد أفكاره أو اتفاقٌ معها، خصوصاً في مسائل الأخلاق والقانون الطبيعي ونظرية السياسة. يعتبر الأكويني المدرس المثالي لمن يدرسون ليكونوا قسساً في الكنيسة الكاثوليكية.[1] ويُعرف بعمليه خلاصة اللاهوت والخلق والخالق. يعتبره العديد من المسيحيين فيلسوف الكنيسة الأعظم لذلك تُسمى باسمه العديد من المؤسسات التعليمية.](http://middleeasttransparent.com/news/wp-content/uploads/2015/05/800px-St-thomas-aquinas.jpg)
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
توما الأكويني (راهب دومينيكاني) (بالإيطالية: Tommaso d’Aquino) (1225 – 1274) قسيس وقديس كاثوليكي إيطالي من الرهبانية الدومينيكانية، وفيلسوف ولاهوتي مؤثر ضمن تقليد الفلسفة المدرسية. أحد معلمي الكنيسة الثلاثة والثلاثين، ويعرف بالعالم الملائكي (Doctor Angelicus) والعالم المحيط (Doctor Universalis). عادة ما يُشار إليه باسم توما، والأكويني نسبته إلى محل إقامته في أكوين. كان أحد الشخصيات المؤثرة في مذهب اللاهوت الطبيعي، وهو أبو المدرسة التوماوية في الفلسفة واللاهوت. تأثيره واسع على الفلسفة الغربية، وكثيرٌ من أفكار الفلسفة الغربية الحديثة إما ثورة ضد أفكاره أو اتفاقٌ معها، خصوصاً في مسائل الأخلاق والقانون الطبيعي ونظرية السياسة. يعتبر الأكويني المدرس المثالي لمن يدرسون ليكونوا قسساً في الكنيسة الكاثوليكية.[1] ويُعرف بعمليه خلاصة اللاهوت والخلق والخالق. يعتبره العديد من المسيحيين فيلسوف الكنيسة الأعظم لذلك تُسمى باسمه العديد من المؤسسات التعليمية.
بناءً عليه، فلم يعبّر أغوسطينوس سوى عن الحكمة السائدة حينما أكّد أن العقل ضرورة لا غنى عنها للإيمان: “حاشا للسماء أن يكره الله فينا الشيء الذي جعلنا بواسطته أرفع من البهائم! حاشا للسماء أن نؤمن على نحو يجعلنا لا نقبل الأسباب أو لا نسعى لمعرفتها، فنحن لن نكون حتى قادرين على الإيمان لو لم نكن نملك أرواحاً عقلانية“. وأقرّ أغوسطينوس بأن “الإيمان ينبغي أن يسبق العقل وأن يطهّر القلب ويجعله أهلاً لتلقّي وتحمّل نور العقل العظيم”. ثم أضاف أنه مع أن من الضروري “أن يسبقَ الإيمانُ العقلَ في عدد من المسائل ذات الأهمية القصوى التي لا يمكن اكتناهها بعد، فمن المؤكّد أن الجزء الصغير من العقل الذي يقنعنا بصحّة ذلك ينبغي أن يسبق الإيمان”. إن إيمان اللاهوتيين السكولاستيين بالعقل كان أكبر من إيمان معظم الفلاسفة المعاصرين به.
بالطبع، عارض بعضُ رجال الكنيسة المؤثّرون الأولوية الممنوحة للعقل وطرحوا أن الإيمان ينبغي أن يتغذى من التجارب الصوفية والروحية. ومن سخرية الأمور أن أعظم داعية لهذا الموقف عبّر عن وجهات نظره في كتابات لاهوتية استندت إلى تبريرات عقلانية بارعة. لقد كانت معارضة الأولوية الممنوحة للعقل شائعة جداً، بالطبع، في بعض الرهبانيات، وخصوصاً بين “الفرنسيسكان” و”البندكتيين”. ولكن وجهات النظر تلك لم تتغلّب- لأسباب عدة قد بينها أن اللاهوت الكَنَسي الرسمي كان يملك قاعدة آمنة في العديد من الجامعات التي انبثقت وازدهرت تحت شعار العقل.
الإيمان المسيحي بالتقدّم
تعتنق اليهودية والإسلام بدورهما صورة لله تسمح بنشوء “لاهوت”، ولكن علماء اليهودية والإسلام لم ينزعوا باتجاه البحث في هذه المسائل. بالأحرى، ينزع اليهود والمسلمون التقليديون إلى التركيبية الضيقة وينظران إلى الكتب المقدّسة بصفتها شريعة ينبغي فهمها وتطبيقها، وليس كمنطلق لطرح أسئلة حول المغازي الجوهرية. وذلك هو السبب في أن الدارسين غالباً ما يشيرون إلى اليهودية والإسلام كدينين معنيين بـ”التطبيق السليم” (“orthoprax”) للشريعة، أي أن “تركيزهما الأساسي هو على الشريعة وعلى تنظيم حياة الأمة”. وبالعكس، يصف الدارسون المسيحية بأنها دين “أرثوذكسي” (orthodox)، لأنها تركّز على “الرأي” (doxa) “السليم” (ortho)، موليةً اهمية كبرى للايمان وللبنية الفكرية التي تنظمه في مجالات العقيدة والتعليم الديني واللاهوت. إن سجالاً نموذجياً بين المفكرين الدينيين اليهود او والمسلمين سيتخذ، مثلاً، شكل التساؤل حول ما إذا كان نشاط ما أو اختراع ما (مثل طباعة الكتب المقدّسة بواسطة “المطبعة”) مسموحاً بموجب الشريعة. بينما السجالات المسيحية النموذجية تكون غالباً عقائدية، وتدور حول مسائل مثل “الثالوث الأقدس” أو “عذرية مريم السرمدية”.
طبعا، بعض المفكّرين المسيحيين البارزين ركّزوا على أمور الشريعة وبعض علماء الدين اليهود او المسلمون كرّسوا جهودهم لمسائل لاهوتية. ولكن التوجّه العام للأديان الثلاثة كان مختلفاً بالنسبة لهذا الموضوع الأمر الذي كانت له عواقب بالغة الأهمية. إن التفسير القانوني يستند إلى السوابق وبالتالي فمرتكزه هو الماضي، في حين يقوم الجهدُ المبذول لتحقيق فهم أفضل لطبيعة الله على إمكانية “التقدّم”. إن فرضية التقدّم هذه قد تمثّل الفارق الأكثر خطورة في ما بين المسيحية وجميع الأديان الأخرى. فباستثناء اليهودية، فقد نظرت جميع الأديان الأخرى إلى التاريخ إما كدورة تتكرّر إلى ما لانهاية أو كانحدارْ محتّم- هنالك حديث نبوي جاء فيه أن “خير الناس قرني، ثم الذين يَلونَهُم، ثم الذين يَلونَهُم”. بالمقابل، حملت اليهودية والمسيحية تصوّرا “إتجاهياً” للتاريخ يصل إلى ذروته في نهاية الزمان الذي سيملك فيه المسيح على الأرض (Millenium). غير أن الفكرة اليهودية عن التاريخ تشدّد، ليس على التقدّم، بل على المسار، في حين أن فكرة التقدّم ظاهرة تظهر كسمة أساسية للمسيحية. وكما قال “جون ماكموراي” (John Macmurray)، “إن مجرّد نزوعنا إلى التفكير بالتقدم يظهر مدى تأثير المسيحية فينا“.
ربما كانت الأمور قد اتّخذت منحىً آخر لو أن المسيح ترك كتاباً مقدّساً مكتوباً. ولكن المسيح لم يكتب شيئاً، بعكس محمد أو موسى اللذين اعتُبِرَت نصوصهما وحياً إلهياً، الأمر الذي شجّع التمسّك بالمعنى الحرفي. ومنذ البداية الأولى، اضطر آباء الكنيسة للتفكير في مغازي مجموعة من الأقوال المنسوبة للمسيح- فالعهد الجديد ليس كتاباً مقدّساً موحدّاً بل هو “مجموعة من المقتطفات” (Anthology). وبناءً عليه، فإن سابقة اللاهوت القائم على الإستدلال والإستنتاج، ومثلها فكرة التقدّم اللاهوتي، بدأت مع القدّيس بولس: “لأن معرفتنا ناقصة، ونبؤتنا ناقصة”. قارن هذا الكلام بالسورة الثانية من القرآن: “ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.(البقرة،٢).
منذ البدايات الأولى، افترض اللاهوتيون المسيحيون أن اعتماد العقل سوف يؤدّي إلى “فهم متزايد الدقةّ” لإرادة الله. ولاحظ القديس أغسطينوس أن هنالك “مسائل معينة تتصّل بالعقيدة لا نستطيع إدراكها بعد… ولكننا سوف ندركها في يوم ما”. إن أغوسطينوس لم يمجّد التقدم اللاهوتي فحسب، بل والتقدم الدنيوي، المادي، كذلك. وقد تساءل، وهو كان يكتب في القرن الخامس للميلاد: “ألم تبتكر عبقرية الإنسان وتطبّق فنوناً (بمعنى “حِرَفاً”) مدهشة لا تُحصى، بحكم الحاجة من جهة، وبفعل الإبداع الفيّاض أيضاً، بحيث أن حيوية الذهن هذه.. تُنذِرُ بثراء لا ينضب في الطبيعة القادرة على اختراع مثل هذه الفنون، أو تعلّمها، أو استخدامها. كم هو رائع- ويجوز أن نقول كم هو مذهل- التقدّم الذي أحرزته الصنائع البشرية في مجالات الحياكة والبناء، والزراعة والملاحة!” ثم يستطرد ليبدي إعجابه بـ”المهارة التي تمّ إحرازها في القياسات والأرقام! وبالحصافة التي سمحت باكتشاف حركات الكواكب والعلاقات في ما بينها”. وذلك كله كان بفضل “الهبة التي تجلّ عن الوصف” التي منحها الله لخلقه، وهي “الطبيعة العاقلة”.
كان تفاؤل القديس أغوسطينوس نموذجياً؛ فالتقدّم كان يومئ. وكما كتب “جيلبير دو تورناي” Gilbert de Tournai في القرن الثالث عشر: “لن نعثر على الحقيقة أبداً إذا ما اكتفينا بما هو معلوم… إن الامور التي كُتِبَت من قَبلنا ليست شرائع بل مَعالِم على الطريق. إن الحقيقة متاحة للجميع، لأنه لم يتم إدراكها كلياً بعد”. وكانت معبّرة بصورة خاصة العظة التي ألقاها “الراهب غيوردانو” (Fra Giordano) في فلورنسة في العام 1306: “لم يتم التعرّف إلى كل الفنون بعد، ولن نصل يوماً إلى النهاية في العثور عليها. وفي كل يوم يمكن للمرء أن يعثر على فنّ جديد”. قارن هذا الكلام بوجهة النظر التي كانت سائدة في الصين خلال الحقبة نفسها، كما عبّر عنها “لي ين- تشانغ: “لو أمكن إقناع العلماء بتركيز إنتباههم على الادب الكلاسيكي وحده ومنعهم من الإنزلاق إلى دراسة المهن والمزاولات المنحطّة للأجيال اللاحقة، فإن الإمبراطورية ستكون محظوظة فعلاً!”
ووصل الإلتزام المسيحي بالتقدم عبر العقلانية إلى ذروته في “الخلاصة اللاهوتية” Summa Theologica، للقديس “توما الأكويني”، التي نُشِرت في مدينة باريس في أواخر القرن الثالث عشر. إن هذاالصرح الهائل المشيّد للاهوت العقلاني يتألف من “براهين” منطقية على صحة العقيدة المسيحية وقد وضع المعايير التي اتبعها جميع اللاهوتيين المسيحيين لاحقاً. وقد عرض “الأكويني” أنه بِقَدَر تقصير الفهم البشري بادراك جوهر الأشياء، بقدر ما هو ضروري التقدم على طريق المعرفة خطوةً خطوة مستعينين بالعقل. وتبعاً لذلك، ومع أن “الأكويني” كان يعتبر اللاهوت أعلى العلوم، حيث أنه يتطرق مباشرة للوحي الإلهي، فقد دعا إلى استخدام أدوات الفلسفة، وخصوصاً مبادئ المنطق، من أجل بناء اللاهوت. وبالنتيجة، استخدم “الأكويني” قدراته المنطقية لكي بجد أعمق فلسفة إنسانية في الخلق الإلهي.
إن “الأكويني” وزملاءه الموهوبين الكُثُر ما كان ليحققوا ما أحرزوه من تفوّق إستثنائي في بناء لاهوت عقلاني لو أنهم انطلقوا من تصوّر لـ”يهوه” يعتبره “جوهراً غير قابل للتفسير”. ولم يكن بوسعهم أن يبرّروا مجهوداتهم إلا لأنهم اعتبروا الله الذروة المطلقة للعقل. وأكثر من ذلك، فالتزامهم بالتفكير العقلاني لادراك إرادة الله تدريجيا فَرَضَ عليهم القبول بفكرة أن الكتاب المقدس لا ينبغي أن يُفهم فقط، أو لا ينبغي أن يُفهَمَ دائماً، بصورة حَرفية. وكانت تلك، أيضاً، هي وجهة النظر المسيحية التقليدية لأنه، بكلمات القديس أغوسطينوس، “أشياء متعددة يُمكن أن تُفهَم من تلك الكلمات وهي جميعها صحيحة”. بل إن أغوسطينوس أقرّ بوضوح أنه باستطاعة قارئ لاحق، بعون من الله، أن يدرك معنىً للنص المقدّس “لم يفهمه حتى الشخص الذي كتب النص اصلا”. ثم يستطرد أنه، تبعاً لذلك، فمن الضروري أن “نتساءل… عما كان موسى، ذلك الخادم الرائع لإيمانك، يقصد أن يفهم قارئُه من تلك الكلمات… لنتمعّن معاً في مفردات كتابك، ولنبحث فيها عن معنى كلمتك يا رب، عبر اقوال خادمك، التي نشرها بواسطة قلمه”. وبما أن الله منزّه عن الخطأ أو الضلال، فإذا ما بدا أن الكتاب المقدس يُناقَض نفسه، فإن السبب يعود إلى نقص الفهم من جانب “الخادم” الذي سجّل كلمات الله.
تنسجم وجهات نظر أغوسطينوس مع فرضية مسيحية أساسية مفادها أن الوحي الإلهي يكون دائماً محدوداً بقدرة البشر على الفهم في عصرهم. وفي القرن الرابع، كتب القديس يوحنا فم الذهب (St John Chrysostom) أنه حتى “الساروفيم” (ملائكة الطبقة الأولى الحارسين لعرش الله حسب المعتقد اليهودي القديم) لا يرون الله كما هو. بل إنهم يرون “تنازلاً يتلاءم مع طبيعتهم. ما هو هذا التنازل؟ أنه ما يحصل حينما يظهر الله ويعرّف بنفسه، ليس كما هو، بل بطريقة تسمح لشخص لا يستطيع أن يدركه أن ينظر إليه. وعلى هذا النحو، يكشف الله نفسه بصورة تتناسب مع ضعف الناظرين إليه”. ونظراً لهذا التراث المديد، فلم يكن هنالك أية هرطقة على الإطلاق في تأكيد “كالفين” بأن الله يلائم وَحيَهُ مع حدود الفهم الإنساني، وأن مؤلّف “سِفر التكوين” مثلاً “كان مقدّراً عليه أن يكون معلّم الجَهَلة والبدائيين، ومعلّم العلماء كذلك. ولذا تعذّر عليه أن يحقق غايته إلا بالهبوط إلى مثل وسائل الإقناع الفجّة هذه”. أي أن الله “يكشف نفسه لنا تبعاً لبساطتنا وضعفنا”.
إن الصورة المسيحية لله هي صورة كائن عقلاني يؤمن بالتقدم الإنساني، ويكشف نفسه بصورة أوفى بقدر ما يكتسب البشر القدرة على إحراز مزيد من الفهم. وأبعد من ذلك، حيث أن الله كائن عقلاني وحيث أن الكون هو خليقته الشخصية، فإن الكون بالضرورة هو نظام عقلاني، خاضع لقوانين (أو “سِنَن”، بالتعبير القرآني- المترجم)، وثابت، ينتظر تزايدَ الفهم الإنساني. وكان ذلك المفتاح للعديد من الإنجازات الفكرية، وبينها نشوء العلم.


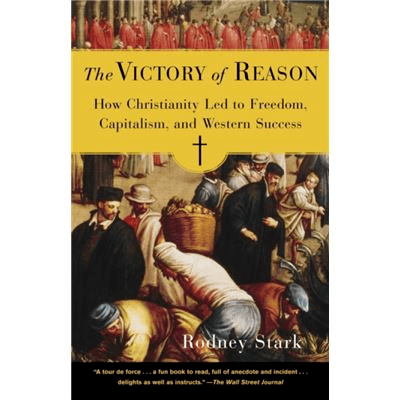
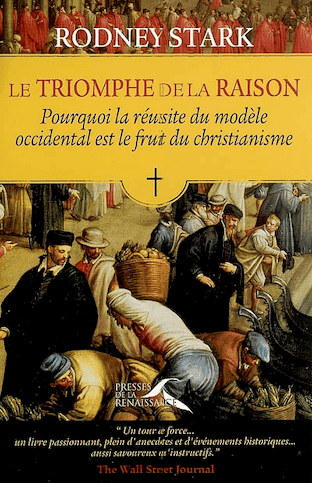
التقدم الغربي جاء بعد ١٧٠٠ سنة من نشاة المسيحية وجاء نتيجة العلم والبحث العلمي والبعد عن الأديان وليس نتيجة المسيحية المسيحية أتت بمذابح إضطهاد ضد اليهود ومذابح الصليبييون ومذابح بين الكاثوليك والبروتستانت مثلها مثل المذابح التي أتى بها الإسلام من قبل ومن بعد ملايين الناس تم قتلهم عبر التاريخ بسبب الأديان جاليليو العالم العظيم كان سوف يتم قتله على يد الكنيسة الكاثوليكية في القرن السابع عشر لولا ان تراجع عن ارائه العلمية الصحيحة حفاظا على حياته … اثينا وفكر أرسطو وأفلاطون واقليدس وارشميدس هولاء من وضعوا أسس التقدم الغربي وليس المسيحية ثم جاءت الثورة الفرنسية والدستور الأمريكي للتمهيد للحرية التي… قراءة المزيد ..