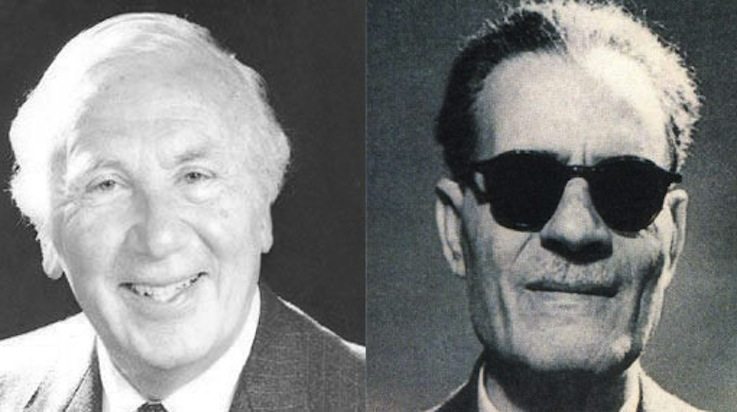خالد الدخيل أكاديمي، ومثقف سعودي، لن يجد الوهابيون في بلاده صعوبة في وضعه على قائمة “الليبراليين”، الصفة التي لا يعرف أحد ماذا تعني، بالضبط. فهو يكتب بلغة سياسية “مُعلمَنة”، ويتناول قضايا “شائكة” من نوع التحرر الثقافي، والاجتماعي، والمواطنة، والحريات الفردية والعامة، ويستعين للتدليل عليها “بالمنطق”.
ولنلاحظ أننا وضعنا عدداً لا بأس به من الصفات بين مزدوجين، للإيحاء بحقيقة أنها تقبل التفسير بطرق مختلفة، وغالباً ما تكون غير مفهومة تماماً من جانب دعاتها ونقّادهم. ولنلاحظ، أيضاً، أن ما يكتبه عن “العرب” و”المسلمين”، وإن اتسم بالعمومية، إلا أنه يمثل، في حقيقة الأمر، جزءاً من سجال ممتد في بلاده نفسها، وهذا ما لا يفشل الوهابيون في اكتشافه، والرد عليه، على الرغم من حقيقة أنه ينتقد أيديولوجيات، وأنظمة، وشخصيات، في العالم العربي، تحظى بكراهية هؤلاء.
ولنقل، مرّة أخرى، أن الغالبية العظمى من العاملين العرب في الحقل الثقافي، حتى وإن استعانوا بالعموميات، إلا أن ما يصدر عنهم يمثل جزءاً من سجال ممتد في هذا البلد، أو ذاك. لذا، لا ينجو من انتقائية، ومن شبهة خصومات محلية تماماً.
فعندما يكتب سعودي، في عشرية ثانية في ألفية ثالثة، عن حقوق النساء، تكتسب الكتابة خصوصية محلية تضع صاحبها في قائمة الراديكاليين (الليبراليين، إن شئت)، ويصعب العثور على ما يماثلها في بلد كمصر، مثلاً، ظهر فيها قاسم أمين وهدى شعراوي، قبل عقود طويلة. فهذا لا يبدو راديكالياً (أو ليبرالياً، إذا شئت) بقدر ما يبدو وفياً لتقاليد الوطنية المصرية في النصف الأوّل من القرن العشرين، المُستعادة بقدر فصيح وصريح من النوستالجيا، بما فيها الحنين إلى زمن مضى، والبكاء عليه.
المهم، تناول الدخيل في مقالة نشرها، في الحياة اللندنية ، أواخر الشهر الماضي، مسألة “شائكة”، هي تفوّق الغرب وإنكاره من جانب العرب والمسلمين. فهؤلاء اعترفوا للغرب بالتفوّق التقني والتكنولوجي، لكنهم أنكروا تفوّقه الثقافي والأخلاقي. وهذا الموقف: ” يكشف استمرار ارتهان الرؤية العربية الإسلامية (ربما باستثناء ماليزيا وإندونيسيا) لماضٍ لم يعد من الممكن إعادة صياغته إلا بشكل مدمر”.
نسمع وراء الكلام عن الشكل “المُدمّر” فحيح الدواعش، ونحيب سباياهم. ومع ذلك، وبعد الاعتراف بشجاعة الدخيل، حيث هو (ففي مصر وبلاد الشام، وشمال أفريقيا، تُقال أشياء كهذه منذ عقود طويلة) فلنقل إن طريقته في التعميم ـ وإن كانت كافية لإقناع سعودي آخر يدعى سعيد الغامدي، كتب بضعة آلاف من الصفحات عن “الانحراف العقدي في أدب الحداثة” بأن الدخيل وأمثاله يهددون القلعة من الداخل ـ غير مُقنعة، ويصعب التدليل عليها.
فلنتأمل الفقرة الأولى في مقالته: “غالبية العرب والمسلمين لا يقرون للغرب بتفوقه الحضاري. هم يقرون له بتفوقه التكنولوجي أو المادي، لكنهم ينكرون أنه حقق أي تقدم أو تفوق ثقافي وأخلاقي”. ما معنى غالبية العرب والمسلمين؟
فلنقل إن الكلام عن “غالبية العرب والمسلمين” يشطب حقائق تاريخية، وثقافية، وسياسية، من نوع أن شمال أفريقيا، ومصر، وبلاد الشام، عاشت وما تزال تجربة مغايرة للسعودية، وبلدان الخليج. ولنقل إن هذا التعميم يشطب حقائق تاريخية، وثقافية، وسياسية، من نوع اختلاف تجارب المسلمين الهنود، والصينيين، والأميركيين، والعرب، والأفارقة، والإيرانيين، فلكل من هؤلاء تجربة مغايرة. ومصدر الاختلاف في حالة العرب والمسلمين، ومصدر اختلاف العرب عن المسلمين، غياب السلطة المركزية، والتمثيل السياسي، على مدار قرون.
بمعنى آخر، لا يصح الكلام عن “غالبية العرب والمسلمين”، وحكاية “ماليزيا وأندونيسيا” لا تعني شيئاً، إلا صدّقنا أردوغان، وما لا يحصى من “الخبراء” في الأكاديميا الغربية، الذين يحاولون إقناعنا بضرورة، وإمكانية، وجود نموذج “إسلامي” يقوم بدور القاطرة الثقافية والسياسية على طريق الديمقراطية، والتحديث، والدولة الحديثة.
وإذا استطردنا في دحض مسألة التعميم، فلنقل إن الكلام عن “غالبية العرب والمسلمين” وطالما سقط في شرك شطب الفروقات التاريخية، والثقافية، والسياسية بين عرب وعرب ومسلمين ومسلمين، لا يجد غضاضة (علمية، أو موضوعية) في القول: ” أعد النظر، وتأمل معي المشهد الذي يمتد عمره الآن لأكثر من قرن من الزمن: زعماء سياسيون، ورجال دين، ومثقفون، ومدارس فكرية وإعلامية، وفنية، ودينية، يمتهنون هجاء الغرب، وتبخيس تفوقه الحضاري”.
هذه المسألة مغلوطة، ولا تستقيم إلا إذا شطبنا تاريخ الماركسية العربية، والحركة القومية العربية، وتاريخ الوجودية، والسوريالية، والنسوية، وتواريخ السينما والمسرح، والفنون التشكيلية، والتصوير، والنحت، والعمارة، والصحافة، والرواية، والقصيدة الحديثة، والجامعة، والمدرسة، والتعليم المُختلط، والنقابة، والحزب. كل هذه الأشياء وليدة الغرب.
وإذا جاز الحديث عن العداء السياسي للغرب، لأسباب تتعلّق بالكولونيالية وتاريخها، فلا يجوز سحبه على الثقافة والحضارة والأخلاق. طه حسين، عميد الأدب العربي، قلل من أهمية عروبة مصر، واهتم باللغوس الأغريقي باعتباره القاسم المشترك بين مصر والغرب. وإذا عدنا إلى المنوّرين العرب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر سنكتشف أن الأمر لم يكن بالأبيض والأسود، كما يُراد له، على سبيل التعميم، أن يكون.
مرّة أخرى، هذه المسألة مغلوطة، ولا تستقيم إلا إذا شطبنا حقيقة أن نقد الثقافة والمجتمع والسياسة والأخلاق مكوّن رئيس في بنية الثقافة الغربية نفسها. المشكلة ليست في الاعتراف بالتفوّق الأخلاقي والحضاري، بل في الاعتراف بوحدة التجربة الإنسانية، وبأن في الغرب فينا أكثر مما نعترف، وفي الغرب منّا، أكثر مما يعترف الغرب نفسه. أما ما هو الغرب، وما هو ضمير الجماعة، هنا، فموضوع آخر.
khaderhas1@hotmail.com