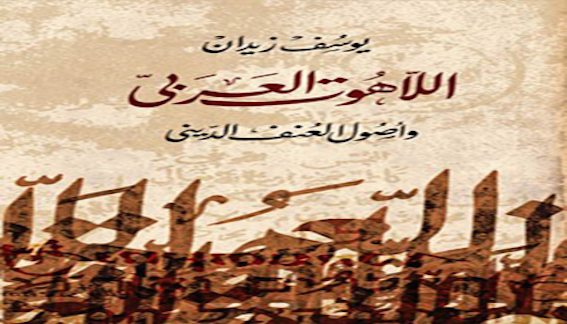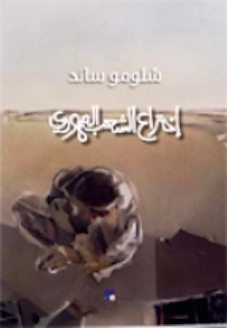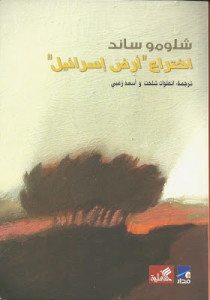هل يمكن لشخص أن يُورّط نفسه في صدام مع “المسيحيين”، و”المسلمين”، والقوميين، والفلسطينيين؟ إذا حدث، وكان روائياً وباحثاً سلاحه العقل، ووسيلته الكلمة، فإن في ورطتهِ الشخصية ما يُورّط هؤلاء كلهم. وهذه هي حكاية يوسف زيدان الآن. وهذا يحسب له لا عليه، ويحسب عليهم لا لهم. وإذا شئنا الدقة فلنقل إنه ليس في ورطة مع هؤلاء بل مع أشخاص يحاولون النطق باسمهم، ويتجلى في محاولاتهم منطق يسود عالم هؤلاء كلهم.
لذا، يصيب الأشخاص المعنيون عصفورين بحجر: ما تُولّد العصبية من رأس المال الرمزي، وما توفر تهمة المس بالمُقدّس من بلاغة تجعل السجال، في أمر ما، ملاكمة بين شخص مقيّد اليدين بأغلال المُحرّم، وآخر يضرب باسم المُحرّم وقبضته فوق وتحت الحزام، وفي كل مكان طالته يداه. ولا يندر أن نرى بين الضاربين مُضاربين في سوق الدين والدنيا من طراز “الجزيرة” وأصحابها، الذين حاولوا صب الزيت على نار الحريق الصغير، الذي أشعله تأويل زيدان لجغرافيا المُقدّس.
فلنعد إلى أوّل الخيط: أغضبت “عزازيل” الأقباط، على الأقل، من حاولوا تمثيلهم بدعوى التطاول على تاريخ الكنيسة. وقد شهدتُ جانباً من تجليات المشاعر الملتهبة، قبل سنوات،
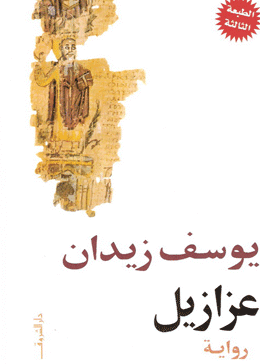 عندما شاركتُ زيدان في فعالية من فعاليات مهرجان برلين الدولي للآداب، وانبرى يومها شخص صارخاً بالعربية: “هذه رواية حقيرة” فانعقدت ألسنة الحاضرين. وفي اليوم التالي تطوّع الشخص نفسه، مشكوراً، بإهدائي ثلاثة كتب سميكة كرّسها أصحابها لفضح “عزازيل” وصاحبها.
عندما شاركتُ زيدان في فعالية من فعاليات مهرجان برلين الدولي للآداب، وانبرى يومها شخص صارخاً بالعربية: “هذه رواية حقيرة” فانعقدت ألسنة الحاضرين. وفي اليوم التالي تطوّع الشخص نفسه، مشكوراً، بإهدائي ثلاثة كتب سميكة كرّسها أصحابها لفضح “عزازيل” وصاحبها.
هذا عن “المسيحيين”، أما عن “المسلمين” فالخيط طويل وقد نعثر على عقدة فيه مع صدور “اللاهوت العربي وأصول العنف الديني“، وعلى الرغم من تنويه زيدان أنه ليس أكثر من كتاب “قد لا يُقدّم ولا يؤخر” إلا أنه أغضب من تطوّعوا لتمثيل “المسلمين” بدعوى أن كلام زيدان عن أن علم الكلام لم يكن إسلامياً خالصاً، بقدر ما كان امتداداً للاهوت العربي، الذي سبق الإسلام، ينال من الإسلام وعلومه.
والآن، أضيفت عقدة جديدة وغليظة في خيط زيدان الطويل. فالمذكور يجتهد في تأويل جغرافيا المُقدّس بالقول إن المسجد الأقصى لم يكن منتهى الإسراء، ومبتدأ المعراج، إذ وقع هذا الحدث الديني المُؤسس في الجزيرة العربية. وهذا القول، الذي يضرب على أكثر من عصب لاهوتي وقومي وتاريخي وسياسي وأيديولوجي نافر، أغضب الكثيرين، فانبرى البعض لاتهامه بالزندقة والكفر، وانخرط قوميون وفلسطينيون، في النحيب ورثاء العروبة، واستدعاء مفردات الجحود والتخوين، طالما أن المنطوق والمسكوت عنه، في خلاصة كهذه، ينزعان عن القدس قداستها في دين ودنيا المسلمين، ويمنحان اليهود أولوية الحق التاريخي.
ولكي لا يجهلن أحد على أحد، فلنقل إن ما أوصل العالم العربي إلى هاوية الانهيار الإنساني والحضاري والأخلاقي، الذي يمثل الدواعش، اليوم، الرأس في جبل جليده العائم، لم يكن الكتب التي “قد لا تقدم ولا تؤخر”، بل كان على مدار قرون، أصبحت طويلة، القتل المادي والمعنوي لها ولمنتجيها، فتصحّر عالم بأكمله، حتى استولت الصحراء الوهابية عليه.
فظاهرة الإيمان الديني لست هشّة وواهنة الجذور، في تاريخ الإنسان، لتنال منها كتب “قد لا تقدّم ولا تؤخر”، بل أن وجود الكتب، ومنتجيها ومستهلكيها، يسهم في إغناء الفضاء 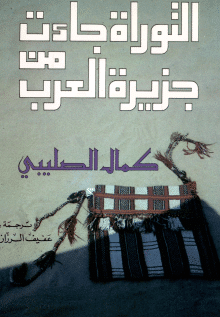 الروحي والثقافي والإنساني للظاهرة الدينية نفسها. ففي تجربة التفوّق الحضاري للغرب، مثلاً، ثمة أكثر من صلة للوصل بينها وبين فضاء اغتنى، بعد كارثة الحروب الدينية، بالتعددية والاجتهاد والتسامح.
الروحي والثقافي والإنساني للظاهرة الدينية نفسها. ففي تجربة التفوّق الحضاري للغرب، مثلاً، ثمة أكثر من صلة للوصل بينها وبين فضاء اغتنى، بعد كارثة الحروب الدينية، بالتعددية والاجتهاد والتسامح.
ولكي لا يجهلن أحد على أحد، ثمة ما يبرر التحفّظ على مؤهلات زيدان في حقل البحث التاريخي، فهو روائي ومحقق محترف للمخطوطات التراثية، وحقل تخصصه الرئيس في الفلسفة والتصوّف الإسلاميين، أما مؤهلاته في حقل التاريخ والتأريخ فتبدو أقل مقارنة بمؤرخ محترف من طراز كمال الصليبي، مثلاً، الذي حاول رسم خارطة جديدة لجغرافيا المُقدّس في “التوراة جاءت من جزيرة العرب”. والطريف أن بعض مهاجميه، من السعوديين، اتهموه، في حينها، بإيجاد مبررات تسوّغ لليهود الإسرائيليين احتلال السعودية، ناهيك طبعاً عن التذكير بأنه مسيحي وصليبي.
أين يأخذنا الخيط الطويل؟ من الواضح، في جانب المنطوق والمسكوت عنه في خلاصة تمنح اليهود، مباشرة أو مداورة، أولوية الحق التاريخي، في “جبل الهيكل” (الحرم الشريف) أن زيدان غير مطلع، بما يكفي على كتابات المؤرخين وعلماء الآثار الإسرائيليين المحترفين من أمثال إسرائيل فنكلشتاين، في ما يخص ممالك اليهود القديمة، وتاريخ الهيكل، والقدس، والأساطير التوراتية عن مملكتي داود وسليمان.
وينبغي أن نذكر، هنا، توماس طومسن، وكيث ويتلام، ونيل بيتر ليمخي، الذين قوّضت أبحاثهم الجديدة أركان أساسية في العمارة التقليدية للأساطير التوراتية. فلا يمكن لأحد أن يتكلّم في موضوع كهذا قبل العودة إلى هؤلاء، أما مردخاي كيدار الذي استشهد به محمد عمارة في سياق رده على زيدان، فقد يمكّن ممثل الادعاء، في بازار التكفير والتخوين، من تدبيج لائحة اتهام عنوانها تبني رواية العدو، ولكنه لا يساوى الكثير في سوق عتاولة الدراسات التاريخية وأركيولوجيا الكتاب المُقدّس، فلن يضعه أحد منهم في قائمة المراجع المعتمدة في دراسة محترمة.
وربما ثمة ضرورة لتذكير زيدان وخصومه، على حد سواء، بكتابي شلومو ساند، أستاذ التاريخ في جامعة تل أبيب “اختراع الشعب اليهودي” و” اختراع أرض إسرائيل“. أذكر ساند، هنا، لتذكير زيدان، دون إنكار حقه وشجاعته، بحقيقة أن توسيع أفق الرؤية يستدعي معرفة أوسع، فلا خلاصات نهائية في حقل العلوم الإنسانية. ولتذكير خصومه بأن المعرفة لا يُرد عليها إلا بالمعرفة لا بالإهانة والتكفير والتخوين. ماذا لو كان “ساند” عربياً، وكتب “اختراع الأمة العربية” مثلاً؟ في كل الأحوال المعرفة ورطة كبيرة في عالم عربي تصحر، ولم يعد فيه متسع حتى لكتب “قد لا تقدم ولا تؤخر”.