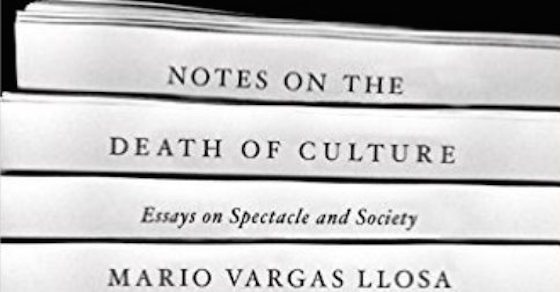ينعى البيروفي ماريو فارغاس يوسا موت الثقافة في عالم اليوم. وللتدليل على أمر كهذا، جمع، وأعاد صياغة، سلسلة مقالات نشرها حول الموضوع، على مدار العقدين الماضيين، في كتاب بعنوان: “ملاحظات حول موت الثقافة: مقالات عن الفرجة والمجتمع” (2015). أثار الكتاب ردود فعل واسعة في كبريات الصحف الغربية، فصاحبه نال جائزة نوبل للآداب، في العام 2010، ويجلس في مقاعد الصف الأوّل لصانعي نهضة أميركا اللاتينية الأدبية، في النصف الثاني من القرن العشرين، من أمثال ميغيل أستورياس، وبابلو نيرودا، وأوكتافيو باز، وماركيز (طبعاً).
والواقع أن “موت”، و”حياة”، الثقافة، كما مفهوم “الثقافة” نفسه، أشياء تُحرّض ما لا يحصى من الناس على الإدلاء بدلوهم في موضوع كهذا، اعتقاداً منهم أن لديهم ما يقولونه في هذا الشأن. ويصعب أن يلام أحد في حالة كهذه، فالديمقراطية تعني امتلاك الناس لحقوق متساوية في التعبير عن آرائهم، وتمنحهم، أيضاً، حق التفكير في أنفسهم كأعضاء طبيعيين في “نادي المثقفين”.
وتحضر، في هذا السياق، ملاحظة لإدوارد سعيد في مقالة طويلة عن المثقفين، ذكر فيها أن عدداً من زملائه دعا لاجتماع للمثقفين في نيويورك لمناقشة أمر ما، وفوجئ المنظمون بأعداد غفيرة من الحاضرين، الذين غصت بهم القاعة الصغيرة، ويعتقد كل واحد منهم أن الدعوة تعنيه بشكل شخصي. فكل شخص يعتقد بطريقة ما أنه “مثقف”. كتب إدوارد ما كتب وفي ذهنه أورتيغا غاسيت، وجوليان بندا. وكلاهما انتقد “ديمقراطية” الثقافة في أوروبا القرن العشرين. فلا أحد يكتب، أو يفكر، في موضوع ما، خارج ما عرفه الحقل الثقافي لهذه الثقافة أو تلك من سجالات.
وهذا، في الواقع، ما فعله يوسا، الذي لا يمكن اتهامه بالتطفل على شيء لا يعنيه. فالثقافة، وموتها، وحياتها، تحيل، في نظره، إلى الثقافة الغربية، وإلى سجال ممتد في حقل الثقافة المعنية. ولا يملك أحد، في كل علوم الإنسانيات، إلا أن يكون انتقائياً (ولماذا يفعل ذلك، فهذا موضوع آخر). لذا، تتبلور فرضيات يوسا الرئيسة، بشأن موث الثقافة، في سياق سجال يحضر فيه تعريف ت. س. إليوت للثقافة، ورد جورج شتاينر، ورد غي ديبور على سابقيه، الذي قوّض فيه فكرة الثقافة في المجتمع الصناعي الغربي المعاصر. وهناك ترجمة عربية لكتاب ديبور بعنوان “مجتمع الفرجة: الإنسان المعاصر في مجتمع الاستعراض“.
ويبدو أن ديبور مارس تأثيراً قوياً على يوسا، الذي أقام فرضيته الرئيسة بشأن موت الثقافة استناداً، ومنذ أواسط القرن العشرين كما يرى، إلى شطب الحد الفاصل بين الثقافة والتسلية. فالمعرفة الجادة، أصبحت محصورة في نطاق ضيّق، وعديمة التأثير، كما فقد المثقف، مكانته ووظيفته الاجتماعية، و”الثقافة” نفسها سلّعتها واستولت عليها صناعة الإعلان، ومهارات رأس المال، وقانون العرض والطلب، لتصبح جزءاً من آليات السوق والاستهلاك ووسائل التسلية.
ولنقل، في البداية، إن موت الثقافة، وموت الغرب نفسه، من الأفكار الشائعة في الثقافة الغربية، بل وربما يعيدها البعض إلى التصوّرات القيامية المُفزعة في الكتاب المُقدّس، وما طرأ عليها في وقت لاحق من علمنة وتحوير لا يغيّر شيئاً مما تنطوي عليه من سوداوية، ويأس من احتمال الخلاص. وكلنا نذكر كتاب الألماني شبنغلر “أفول الغرب“، الذي تُرجم إلى العربية، وأضافه ماركسيون وقوميون عرب إلى لائحة اتهام طويلة ضد الغرب.
ومع ذلك، وعلى الرغم من كل تلك السوداوية، إلا أن الغرب لم يأفل، ولم يمت، بل ازدهر وتفوّق وتسيّد على العالم منذ خرج من ظلام القرون الوسطى. وقد نجح في ذلك، لأنه لم يتوقف عن ممارسة النقد الذاتي. وبهذا المعنى، يمكن لكتاب يوسا عن موت الثقافة أن يُقرأ باعتباره ممارسة للنقد الذاتي، واستمرارا لتقليد عريق في الثقافة الغربية.
وبقدر ما أرى الأمر، أعتقد أن فرضية مجتمع الفرجة صحيحة، ولكنها لا تقود، بالضرورة، إلى موت الثقافة. ففي كل كلام عن موت الثقافة، أو حتى موت الإنسان، في النسق الثقافي الغربي المعاصر، نعثر على ذعر من زمن جديد، خلقته الثورة التكنولوجية، وبسطت العولمة ظلاله في أربعة أركان الأرض، ولم تتضح ملامحه بعد. ولعل في ذعر كهذا ما يعيد التذكير بما أثارته الثورة الصناعية من ذعر في حينها، وردة الفعل الرومانسية على انهيار عالم أوروبا الإقطاعية، ونشوء القوميات، وصعود الطبقة الوسطى، والطبقة العاملة الحديثة، وشبحها الذي يقض مضاجع الحكّام الأوروبيين، كما ذهب طيب الذكر ماركس، في أواسط القرن التاسع عشر.
وبما أن القراءة محكومة، دائماً، بحقول وهموم ثقافية مختلفة. استوقفتني بشكل خاص، ملاحظة رئيسة في نقد شتناير لإليوت، ومفادها أن أحداً لن يتمكن من التفكير في معنى الثقافة الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، دون التوقّف أمام الهولوكوست.
وبهذا نختم: لن يعثر أحد في الغرب، أو غيره، على شروط جامعة ومانعة لعضوية “نادي المثقفين”، ولن يتمكن أحد من اختزال الثقافة، كائنا ما كان تعريفها، في تعريف جامع ومانع، فالثقافة، كما الإنسان، لا تُختزل، ولا تكف عن الحراك، ولا تموت.
وبقدر ما يتعلّق الأمر بالثقافة العربية فإن العجز عن ممارسة النقد الذاتي، وعدم وجود تقليد كهذا، يفسّر فشل العرب في الالتحاق بالأزمنة الحديثة. ولن يتمكن أحد، على الأرجح، من ممارسة النقد، ما لم يفكر في فرضيات من نوع ظهور داعش (على اختلاف راياتها وتسمياتها)، فكما كان الهولوكوست فضيحة الثقافة الغربية، فإن داعش هي فضيحة الثقافة العربية، وبها انقسم تاريخ العالم العربي، وثقافته، إلى ما قبل وما بعد. ما قبلها (بعقود أو قرون) أنجبتها، وما بعدها في عالم عربي لن يصلح للعيش ما لم يقوّض المثقفون العرب، بمعول النقد، بنية ثقافية تحجّرت في الزمان والمكان. فقشة الثقافة قد تنقذ الغريق.
khaderhas1@hotmail.com