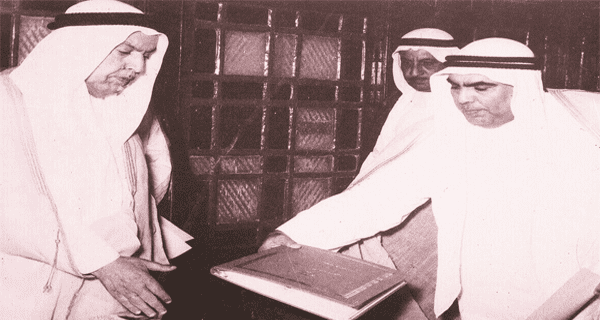هل يمكن لمفردة “الطاعة” أن تجد لها موقع قدم في الحياة الديمقراطية؟ ما هي دلالات الكلمة، وأين يمكن لها أن تعيش؟
حينما يصبح الدستور أو القانون سببا في عرقلة عمل الديمقراطية وآلياتها، يجب حينها معالجة ذلك لكي تسير عربة الديمقراطية في سكّتها. وقد أثبتت التجربة البرلمانية الطويلة نسبيا في الكويت (أكثر من 60 عاما) أن العربة لا تزال تسير خارج السكة. وما تَسْمِية التجربة بــ”الديمقراطية” إلا محاولة ترقيع، إن صح التعبير. فالمؤشر العالمي الخاص بقياس الديمقراطية لا يزال يعتبر الكويت دولة غير ديمقراطية.
إن نفوذ مفهوم الطاعة في مواد وروح الدستور الكويتي، وفي مفاصل الحياة السياسية في الكويت، يعد من أسباب عدم ارتقاء الكويت إلى مصاف الدول المسماة بالديمقراطية. فهناك جهة واحدة، وهي “السلطة”، من لها الحق القانوني/ الدستوري في الهيمنة على القرار السياسي، ومن ثم في الموافقة على أي تعديل على الدستور. في حين لا يملك المنافس السياسي للسلطة أو معارضو السلطة هذا الحق. والمنافس لا يستطيع، وفق الدستور، إلا أن يطيع السلطة ويخضع لقرارها. وقد ترسّخ هذا السيناريو الدستوري في الواقع السياسي والبرلماني على مدى عشرات السنين، وأصبح يعيش حالة من التناقض بين تطبيق مفهوم الديمقراطية الذي يعني حكم الشعب لنفسه، وبين نفوذ مفهوم الطاعة الذي يعني الهيمنة على القرار السياسي من قِبَل السلطة. وقد استطاع أنصار الطاعة أن يحقّقوا أهدافا عدّة في محطات سياسية مختلفة، فيما سعت المعارضة السياسية – ولا تزال – لتغيير الواقع السياسي لجعله أقرب إلى مفهوم الديمقراطية.
لمفهوم الطاعة، جذور دينية تاريخية، وأخرى تنطلق من الثقافة القَبَلية أو العشائرية. ومهما زعم أنصار المفهوم بأنه لم يكن سببا في فشل ارتقاء الكويت ديمقراطيا، غير أن المفهوم لا يستطيع أن يتصالح مع فكرة حكم الشعب لنفسه. القرار المطلق والنهائي الذي تفرضه السلطة على المجتمع نابع من سيطرة ثقافة الطاعة على مجريات الأمور. فهذه الثقافة تهيئ الأرضية لـ “تخفيف” النقد والاعتراض و”رفض” الاحتجاج والتغيير. نجد نماذج لذلك في ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ الفردية، ﻭﺍلعشائرية، ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، ﻭفي ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ الدينية المنطلقة من رؤى تاريخية مطلقة ترفع من شأن ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ باعتباره ﻇﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ.
يعتقد البعض أن مفهوم ﺍﻟﻄﺎعة لا ينظّم إلّا ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭربّه ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺣﺎﻟﺔ من “ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ” تحتاجها ﺍلحالة الإيمانية. بمعنى أنه ينظّم ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﺭض ﻻ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ. ووفق هذا البعض، فإن الطاعة تنتظم من خلال آلية “ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ”، فتجعل الحياة ﺃﺷﺒﻪ بنظام ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻳسجن إﺭﺍﺩﺓ الإنسان. “ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ” آلية ﻣﺸﺘﺮكة ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ، ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، من شأنها أن تحقّق هدف ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻀﺔ، ولا يمكن أن تتّسق مع ﻣﻔﻬﻮﻡ “ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ”، الفردية والجماعية، كالحق ﻓﻲ ﺍﻻحتجاج، ﻭﻓﻲ نقد ﻭتغيير ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠّﻤﺎت ﻭﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ، فيما لا وجود لحق الاعتراض والنقد في منظومة “ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ”، ولا يُسمح بالتغيير إلا عن طريق آلية السلطة الواجبة الطاعة. في حين أن أحد تعريفات الديمقراطية هو حق الفرد والشعب في الاحتجاج على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسعي لتغييرها بصورة سلمية.
يسعى ﺃﻧﺼﺎﺭ مفهوم ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻹﻋﺎﺩﺗﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﺇﻟﻰ ﺣﻴﺎﺓ “ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ”، ﺩﻭﻥ إدراك ﺑﺄﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺑﺎﺗﺖ ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ، ﻭﺩﻭﻥ وعي ﺃﻥ هذه ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭمفاهيمها، ﻭبأنها لا تستطيع ﺃﻥ ﺗﻌﻴﺶ ﻣﻊ ﺍﻟﺪيمقرﺍﻃﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ حق الانتخاب واللاإنتخاب والنقد والسؤال والاحتجاج والتغيير، فنجدهم ﻳﺘﻔﺎﺧﺮﻭﻥ ﺑﺄﻥ ﺣﺎﻛﻤﺎ ﺃﻭ ﺯﻋﻴﻤﺎ ومن خلال نداء ﻭﺍﺣﺪ منه منطلق من آلية “التكليف” استطاع ﺗﺤﺮﻳﻚ عشرات الآلاف أو حتى الملايين ﻣﻊ ﺃﻭ ﺿﺪ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ، وﻳﺘﻌﻤّﺪﻭن ﺃﻥ ﻳﺘﺠﺎﻫﻠﻮﺍ ﺑﺄﻥ ثقافة الطاعة “ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ” ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺗﺸﺮﻋﻦ ﻟﻮﺿﻊ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻛﺎنت القاعدة وداعش وولاية الفقيه وجمال عبدالناصر وصدام حسين في طليعة ﺻﻮﺭها.
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺬﺍﺕ الطاعة المطلقة المستبدّة، يؤسس للفساد. ﻟﻨﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ جرى ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ تمرّد أفرادها ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ، ﻛﻴﻒ ﺳﺎﻫﻢ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ تسلّط ﺍﻟﺤﻜّﺎﻡ ﻭﺑﺮﻭﺯ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺍﻟﻐﺒﻦ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ انطلاقا من ضرورة أن ينصاع ﺍﻟﻤﺤﻜﻮمون ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ الفرد، ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ نفاد ﺻﺒﺮ ﺍلشعوب وانفجارها ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻫﺪﺍﺭ ﺣﻘﻮقهم ﻭﻛﺮﺍﻣﺎتهم، ﻭﺇﻟﻰ ﻋﻨﺎﺩ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩﺍ ﻭﺗﺸﺪّﺩﺍ ﻭﻋﻨﻔﺎ، ﻟﻈﻨّﻪ بضرورة ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻻﻧﺼﻴﺎﻉ وعدم الطاعة، ﻭﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ويرفض ﻃﺎعته وطاعة ﻧﻈﺎﻣﻪ.
لا ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﻻ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﺤﻜّﺎﻡ ﻓﻲ ﻇﻞ هيمنة ﺛﻘﺎﻓﺔ الطاعة والخضوع. ﻟﺬا نشاهد اختفاء آلية مراقبة الحاكم ونقده ﻓﻲ المجتمعات التي ﺗﺴﻮﺩ فيها ﻃﺎﻋﺔ الحكّام وأنظمتهم، وصعوبة تخطئته، بل واستحالة ﺗﻐﻴﻴﺮ قراراته أو تغييره ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﺇﻻ بولادة تحرك شعبي مناهض قد ﻻ يخلو ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ.
ﻭﻷﻥ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﺼﺎﺩﻡ ﻣﻊ واقعيّة الحياة ﺍﻟﻘﺎئمة ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ بالعلمانية وﺍﻟﻤﺪنية ﻭما يتعلّق بهما من ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻭﻗﻮﺍنين تقف ضد الإﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﺍلسياسي والديني ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻭﺍﻟﻌﺮﻗﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺇﻃﺎﻋﺘﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻻ ﺃﻥ يشكّل ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮّر ﻭمضادة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ.
من ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺭﺩّﻩ، ﻫﻮ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻭﺍﻟﺴُّﻠُﻄﺎﺕ ﻓﻲ شخص ﻭﺍﺣﺪ أو في جهة واحدة خاضعة لهذا الشخص، ﻭﻓﻘﺪﺍﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺃﺧﺮﻯ. ﻭﻫﺬﺍ ﻻ يشمل ﺍﻟﺤﻜّﺎم فحسب ﻭﺇﻧﻤﺎ يشمل ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍلتجمّعات ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺯﻋﺎﻣﺎﺗﻬﺎ، ﻭﺃﻳﻀﺎ يشمل ﺍلمشهد ﺍﻻﺟﺘﻤﺎعي ﺩﺍﺧﻞ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﻭﺍﻷﺳﺮ. اﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺗﺒﺮﻫﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻭﺍﻟﺴُّﻠُﻄﺎﺕ التي ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺘﺮكّز ﻓﻲ يد ﺍﻟﺮﺟﻞ (مقابل زوجته وأبنائه) ﺃﻭ في يد ﻛﺒﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ (مقابل بقية أفراد الأسرة) أو في يد ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺰﺏ (مقابل بقية الأعضاء) ﺃﻭ في يد ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ (مقابل الشعب)، هي البذرة الأساسية التي ينمو الاستبداد في تربتها. ترﺍﻛﻢ السُّلُطات ﻭتمركز ﺍﻟﻘﻮى ﻭﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ، حينما تتمركز ﻓﻲ ﺷﺨﺺ ﻭﺍﺣﺪ، يكفل انتشار الفساد.
من أبرز صور هذا ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻷﻣﻦ، ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺨﻮﻑ، والتعدّي على الحريات والكرامات، ما يعكس ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ. ونتيجة كل ذلك هي هيمنة ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩية على الواقع ﻭﻟﻮ تم الزعم ﺑﺄن الديمقراطية هي التي تنظّم هذا الواقع. وعليه، تصبح ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ المطلقة ومعالجتها، مسؤولية سياسية ودستورية تحتّمها مساعي الدفاع عن الديمقراطية، ويأتي على رأس العلاجات الضرورية، إعادة توﺯﻳﻊ خريطة القوى في المجتمع تماشيا ومفهوم حكم الشعب لنفسه.