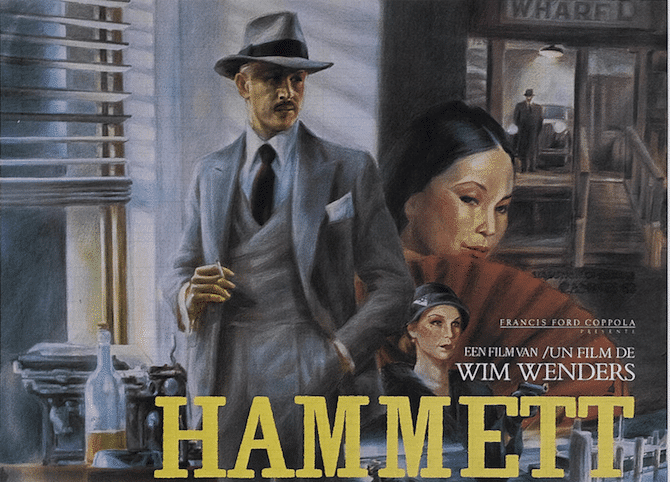سأل عبده وازن، في “الحياة” اللندنية، يوم أمس: “متى يُولد في عالمنا العربي أدب بوليسي؟ هل تكون الثورات، وما أعقبها من تحوّلات جسيمة حافزاً على نشوء هذا الأدب غير المألوف لدينا؟”.
ومع التسليم بحقيقة غياب الرواية البوليسية في الأدب العربي، وإذا شئنا الكلام على طريقة ما قل ودل، يمكن أن نقترح الجواب التالي على السؤال الأوّل: سيُولد الأدب البوليسي “في عالمنا العربي” عندما تصبح الحقيقة نسبية.
ومع ذلك، فلنعترف بأن ما قل ودل لا يُسهم في تفسير مسألتين شائكتين هما النسبية والحقيقة، وكلتاهما وثيقة الصلة بالأخرى، بقدر ما يتعلّق الأمر بما يمكن تسميته بالرواية البوليسية. والصحيح، أيضاً، أنهما على صلة لا تنفصم بكل ما يُسهم في تفسير الحداثة والأزمنة الحديثة، وكل ما أدى إليهما، ونجم عنهما، من معارف وآداب وعلوم.
بيد أن أمراً كهذا لا يفسر كل شيء. فالماركسية، مثلاً ـ وهي ابنة الحداثة، والأزمنة الحديثة ـ أنجبت أنظمة اجتماعية وسياسية لم تزدهر في ظلها الرواية البوليسية. ففي الصين، وجمهوريات الاتحاد السوفياتي، والكتلة الاشتراكية، لم تزدهر الرواية البوليسية، وكذلك علوم النفس والسياسة والاجتماع.
وهذه الملاحظة ضرورية، على نحو خاص، للتفكير بطريقة أفضل في مفهوم النسبية والحقيقة، وفي علاقة لا تنفصم بين الاثنتين. فالنسبية نقيض المطلق، وطالما أن المطلق الدنيوي، أو الميتافيزيقي، يتجلى في شكل حقيقة كاملة، لا تقبل النقد والنقض، يُولد احتمال النسبية إذا أصبحت الحقيقة نفسها مجرد احتمال، أو مجرد تفصيل في شيء أكبر وأكثر تعقيداً، وقد تكون قناعاً لحقيقة مغايرة.
وفي هذا ما يأخذنا إلى أمرين: أن حقيقة الأزمنة الحديثة نسبية تماماً، فلا هي نهائية، ولا كاملة، بالضرورة، وأن البحث عنها شأن فردي، أيضاً. ولن يصبح الأمر الأوّل مفهوماً تماماً ما لم نضع في الحسبان عملية تسليعها، وقيمتها التبادلية والاستعمالية وعلاقتها بسوق القوّة والسلطة والمعرفة والإنشاء منذ بداية المستوطنات الزراعية الأولى، على الأرض، قبل عشرة آلاف عام، وحتى استيطان نجوم ومجرّات بعيدة، بعد قرون قد تطول أو تقصر. ولن يصبح الثاني مفهوماً ما لم نضع في الحسبان ولادة الفرد في التاريخ، وحقيقة أنه ظاهرة تاريخية جديدة، وفريدة، لا يزيد عمرها عن بضعة قرون.
هل ابتعدنا عن “الأدب”؟ ليس تماماً، بل أصبحنا في صلبه، إذا كنّا نتكلّم عن الرواية عموماً، فلم يكن لجنس الرواية أن يرى النور خارج مركزية المدينة، التي أطاحت بطمـأنينة ورتابة وحقائق المجتمعات الرعوية والريفية، ومع هذا وذاك أنجبت الفرد والفردانية.
ولم يكن للرواية أن ترى النور خارج أزمنة الكشوفات والفتوحات الكولونيالية، التي افترضت الإفلات من قيد الطبيعة، وقابلية العالم للامتلاك، وإمكانية سبر أغواره، وفك ألغازه، عن طريق المنطق والعلم التجريبي والإرادة. ولم يكن لها أن تكون ممكنة خارج المدينة، والمطبعة، والجريدة، ودون وجود البرجوازية، الطبقة الاجتماعية الجديدة الصاعدة في التاريخ.
كل ما تكلمنا عنه حتى الآن يمكن صياغته بطريقة جديدة، وفي جملة واحدة هي: علمنة العالم. لم تكن أشياء كثيرة، ومن بينها الرواية بكل أطيافها، ممكنة دون علمنة العالم.
على خلفية كهذه يمكن الكلام عن غياب الرواية البوليسية في الأدب العربي. فالأنظمة السلطانية والمملوكية والعثمانية، التي ورثت دولة وبيروقراطية، وجامعات، الحقبة الكولونيالية، وتبنت أيديولوجيات راديكالية، في الغالب، كانت وما تزال شمولية، وحامية لمطلقات دنيوية وميتافيزيقية تنتمي إلى ما قبل الدولة الحديثة.
وفي ظل علاقة نفعية وتبادلية بين المطلقين الدنيوي والميتافيزيقي يمثل كل احتمال للنسبية تهديداً لطرفي العلاقة. وفي ظل علاقة كهذه تُرى الفردانية، أيضاً، باعتبارها نوعاً من التهديد. لذا، لجأ الروائيون، والروائيات، العرب إلى تشفير أعمالهم الروائية، بطريقة تجعل تأويلها أقرب إلى لعبة حل الكلمات المتقاطعة، وقد أسهم هذا العمل الشاق في توليد أعمال من طراز رفيع، لكنها لم تشفع لأصاحبها.
فنجيب محفوظ، مثلاً، العربي الوحيد الفائز بنوبل للآداب، تعرّض لمحاولة اغتيال، ومُنعت بعض رواياته في أكثر من بلد عربي. وفي حالات بعينها يكون التشفير رديئاً إلى حد تصبح معه الرواية نفسها مجرد استيهامات وخيالات فارغة، عن الكبت الجنسي، وخيبة أمل الريفي في المدينة، والمناضل في الثورة المهزومة، والحالم بعد الإفاقة من النوم، وفي العالم العربي من هذا الكثير.
الواقع الذي لا يحظى بكثير من الاهتمام النقدي في العالم العربي يتمثل في حقيقة أن فكرة الرواية، كما يكتبها ويتداولها العرب تعاني من مشاكل بنيوية ومفهومية كثيرة. وفي هذه النقطة، بالذات، ما يأخذنا إلى حقيقة إضافية غالباً ما تُحال بفضل التجاهل إلى هامش النسيان، وأعني أن التشفير، أو التظاهر بالتشفير في الأدب الروائي العربي، كما في قصيدة الشعر الحديث، يخفي قصوراً في معرفة القواعد والمهارات والأدوات الضرورية، التي ينبغي امتلاكها وتوظيفها في هذا النوع من الكتابة. والمهم، أن شروط الرواية البوليسية أكثر صعوبة من الرواية “الأدبية”، وهي أقرب إلى الشروط التقليدية للرواية، قبل قرن مضى.
فلنحوصل: الشمولية، والعلاقة النفعية والتبادلية بين المطلقات الدنيوية والميتافزيقية، في ظل أنظمة سلطانية، ومملوكية، وعثمانية، تحمي الجانبين وتعتاش عليهما، الذعر من علمنة العالم، ومكافحة الفردانية، وصعوبة شرط الرواية البوليسية، من الأسباب القابلة للتوظيف في كل محاولة لتفسير لماذا لا يكتب العرب روايات بوليسية.
khaderhas1@hotmail.com
برلين