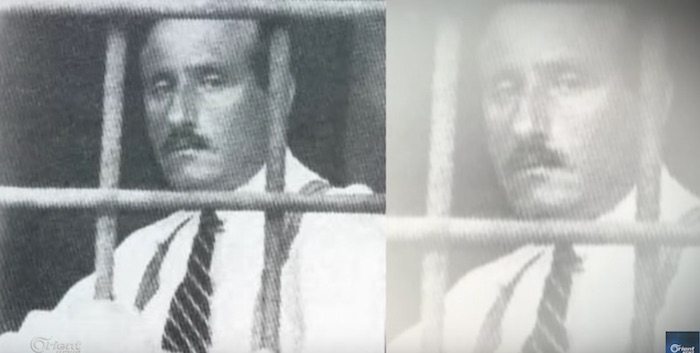(اختار “الشفاف” لهذا المقال الصورة أعلاه للدكتور عبد الرحمن الشهبندر. القارئ الذي لا يعرف تاريخ الشهبندر العظيم.. “إلى غوغيل”!)
يهدف هذا المقال إلى فتح باب النقاش حول الطريقة التي يمكن أن تُتَّبع في المرحلة المقبلة لضبط عملية إنتاج السياسة في سورية، وذلك بوصفه إنتاجًا فوقيًا لهيئات المجتمع المدني الجمعيات والأحزاب وغيرها)، عوضًا عن كونها تجليات فوقية للمجتمع الأهلي (الأديان والطوائف والعشائر … إلخ).
قبل ذلك وبعده، نعتقد بأنّ على النخب الديمقراطية العمل في أكثر من جبهة؛ بهدف فضح ثقافتنا المتخلفة والمنافقة، إلى درجة تجعل الشخص ذاته يعيش في عدة شخصيات؛ ليتمكّن من التكيُّف الاجتماعي، وأحيانًا، ليأمن على حياته. كذلك لا بدّ من سبر ثقافة القاع الاجتماعي التي تنتج أو تحابي الظواهر السياسية الفوقية، والنهوض بها نحو آفاقٍ جديدة. يعدُّ نقد ذات المجتمع خطوة مهمة لنقل ثقافتنا باتجاه عصر التنوير، والتأسيس لأخلاق اجتماعية جديدة، تلحق بمجريات العصر المتسارعة، والبدء بردم الهوة بين نمط التفكير التقليدي والعقل العلمي المُنتج للحضارة التي نلهث وراء استهلاك منتجاتها المادية بلا تردّد أو خجل!
إنّ البدء بإنتاج السياسة ووسائل الحكم، من المستويات الاجتماعية الأدنى إلى الأعلى، وتدريب الناس على تنظيم أنفسهم بصورة ديمقراطية، يشكل رافعة وعيٍ مهمة تحرم الانتهازيين من ادّعاء تمثيل المجتمع سياسيًا، كالسائد في سورية الآن، إضافة إلى أنّ تحسين أحوال العيش يعدّ مكافأة للمجتمعات المحلية؛ وتشجيعًا لها على تفهُّم العملية الديمقراطية وتعلُّمها.
العملية طويلة وشاقّة، لكنها شبه مضمونة النتائج، وتحتاج، من أجل انطلاقتها، إلى رفع وصاية قوى الأمر الواقع عن المجتمع، وستكون ممكنة فور تجلّي ملامح الحل السياسي ووقف الحرب. يؤسس ذلك أيضًا للامركزية واسعة ومتباينة في طريقة الحكم، وهو أكثر ما يمكن الوصول إليه في المدى المنظور؛ بسبب التشرذم الاجتماعي الحاصل، وتنوع قوى التأثير في الواقع.
لقد عملت الأجهزة الوصائية في مرحلة الاستبداد، ومازالت، للتحكم بالتعبير السياسي للمجتمع الأهلي من خلال انتقاء ممثليه من العناصر المضمون ولاؤها للنظام. فانقلبت عملية التمثيل ذاتها لتصبح وكأنها تمثيل للسلطة في المجتمع الأهلي، أكثر من كونها تمثيلًا للمجتمع الأهلي في السلطة، فربحت السلطة وخسر المجتمع كله. وتمثلت المكافأة التي منحتها السلطة للمجتمع الأهلي بحظر هيئات المجتمع المدني، كمستوى أرقى في التمثيل، إذ تعدُّ هذه الهيئات عدوّة الطرفين في آنٍ معًا. تعد الطريقة التي كانت، ومازالت، تجري فيها الانتخابات التشريعية، أو ما يسمى بانتخابات مجلس الشعب، مثالًا حيًا للتواطؤ بين سلطة مستبدة ومجتمع أهلي متخلف، ما أعاق، بالفعل، تنامي الوعي السياسي عند السوريين وحجر عليه.
وهكذا، بنتيجة غياب المجتمع المدني، لم يكن ثمة تمثيل سياسي بالمعنى الحقيقي، بل امتدادات فوقية -فحسب- للمجتمع الأهلي في هيئات السلطة. أما الأحزاب السياسية فلم تكُ أحزابًا فعلية، إنما إطارات للحشد الشعبي، كما بالنسبة إلى حزب البعث، وذلك لتسهيل عملية حظر السياسة والحيلولة دون تحولُّها إلى فعالية اجتماعية مقوننة؛ أو أنها كانت إطارات فارغة فحسب، مثلما في أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، للإيهام بوجود حال سياسية. وفي الحالتين، انحصرت وظيفة هذه الأحزاب في تأمين الشرعية السياسية لنظام الاستبداد.
من جهة أخرى، لا يُخفى على أي مراقب محايد المنحى الذي اتخذته التحولات الاجتماعية بعد تحكم العسكرة المتأسلمة بواقع كان يضجّ بالأمل؛ إذ ما إنْ زال الغطاء الاستبدادي عن المجتمع الأهلي في بعض المناطق، حتى بدأ هذا المجتمع بالتعبير عن ذاته في حاله الخام، مستظلًا بالجماعات الدينية التي قدمت نفسها منقذة، فكانت وبالًا، وقد شرعنت نفسها بقوة السلاح والفتاوى؛ ما كرّس المظالم الاجتماعية أكثر، وأهمها التمييز ضد المرأة (على سبيل المثال، جرى حرمان المرأة من الترشُّح لانتخابات المجلس البلدي في إدلب أخيرًا).
الدين والعلمانية
يفترض الانتقال من مستوى المجتمع الأهلي إلى مستوى المجتمع المدني تحييدًا تلقائيًا لدور الدين، بوصفه مؤثرًا فاعلًا في السياسة، من دون أن يمس ذلك دوره في البنية التنظيمية للمجتمعات الأهلية. يساعد في ذلك تنامي الشعور المناهض للتطرف الديني الذي يمكن تلمسه في الشارع بوضوح. في هذا الصدد، يعمل التنوع الاجتماعي السوري على الدفع باتجاه النظام الديمقراطي العلماني، فهو يلائم الأقليات القومية والدينية، ويزيل أي مبرر لمخاوفها في المستقبل، مثلما يعيد المكانة للأكثرية بوصفها حاضنة اجتماعية، ومن ثم؛ يعمل نظام المواطنة على صهر الجميع في بوتقته، ويؤسس لسلام وأمن اجتماعيين على المدى البعيد، ومن أجل الجميع.
الخليج وروسيا وإيران
إذا انتقلنا إلى مجريات الصراع الحالي على الأرض السورية، نجد أن الدور السياسي الروسي، وهو، على الأرجح، بضوء أخضر من المجتمع الدولي، ومهما كانت ملاحظاتنا عليه، فقد عمل على استغلال الحدود الفاصلة بين القوى الخارجية والداخلية في كلٍّ من جبهتي الحرب في سورية، فوجَّه ضربة مهمة إلى العنصر المذهبي في هذا الصراع، ويمثله الدور الإيراني في جبهة النظام والدور الخليجي في جبهة المعارضة المسلحة. انعكس ذلك في التنافس بين الروس والإيرانيين من جهة، وفي المحاولة المستمرة لرسم حدود فاصلة بين المسلحين “المعتدلين” والمتطرفين من جهة ثانية. ينتهي الدور الروسي هنا، لأنّ البنيان السياسي في روسيا ذاتها غير مؤهّل لإعطاء دروس في الديمقراطية!
ثمة عاملان مهمان قد يسرعان من عملية الانتقال السياسي؛ الأول، إعادة هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية، ما يحيِّد القوى المقاتلة الخارجية، والثاني توقُّع أن تتحوّل معظم القوى المستظلة بالنظام إلى المساهمة الفاعلة في عملية التغيير الديمقراطية، فكأنها بذلك “تكفِّر” عن تقاعسها في الانضمام إلى الثورة من خلال هذه المساهمة المنتظرة!
يتمثّل الخطر الأكبر، الذي قد نرتكبه في المرحلة الانتقالية، بالاستعجال في بناء النظام السياسي الجديد، وعموده الفقري- الدستور، بحيث يتحقق إنتاج البنى السياسة قبل اكتمال تشكل هيئات المجتمع المدني، فتكون هذه البنى انعكاسًا لرغبات مجتمعية أهلية لم تتخلص بعدُ من تأثير وهيمنة قوى الاستبداد في هذا الجانب أو ذاك، ما قد يكرس دور القوى السياسية الانتهازية المدعومة من الخارج.
mshahhoud@yahoo.com
د. منير شحود، كاتب وأستاذ جامعي سوري
اللاذقية- سوريا
المصدر: جيرون