اقترحتُ، قبل عقدٍ من الزمن، وبعد صدور كتابي الوحيد، فكرةً اعتقدت أنها قد تكون مثيرة للاهتمام ومتابِعةً لمضمون الكتاب. فقد خطر لي القيام برحلة تمتدّ أشهرًا عدة، وتنطلق من بيروت، مرورًا بنيقوسيا وإزمير وسالونيك وموستار وساراييفو، ووصولًا إلى فيينا، والكتابة عمّا جرى هناك على صعيد العلاقات بين الطوائف – وبين المسيحيين والمسلمين على وجه الخصوص لا الحصر. وكان منطقيًا اختيار فيينا محطةً نهائية لأن فيها توقّف توسّع الإمبراطورية العثمانية في العام 1683.
لم أكن واثقًا من الخلاصات التي سيتضمّنها الكتاب، ولكن هذا الأمر كان متروكًا لرحلة الاستكشاف. في نهاية المطاف، لم أتمكّن من إتمام هذه الفكرة، ولكن بعد زيارة معظم هذه المدن، تكوّن لديّ انطباعٌ بأنها فقدت شيئًا أساسيًا في شخصيتها حين أصبح طابعها أكثر أُحاديةً في القرن العشرين.
على سبيل المثال، ماذا يبقى من سالونيك من دون مسلميها أو يهودها؟ فقد شكّل اليهود في ما مضى أكثرية في المدينة، إذ بلغ عددهم نحو 46,000 نسمة، قبل أن يتعرّضوا للإبادة على أيدي النازيين في أوشفيتز-بيركيناو في العام 1943، ولم ينجُ منهم سوى 2,000 شخص. وماذا يتبقى من نيقوسيا الخاضعة لسيطرة الأتراك من دون اليونانيين؟ زرتُ ذلك الجزء من المدينة في العام 1993، واختبرت انتقالًا زمنيًا محبِطًا للمعنويات. فقد بدا المكان وكأنه تجمّد في العام 1974، تاريخ الاجتياح التركي، وكان الجنود الأتراك المتجوّلون المستهلكين الأساسيين في المنطقة التجارية التي كانت متهالكة إلى حدٍّ ما آنذاك.
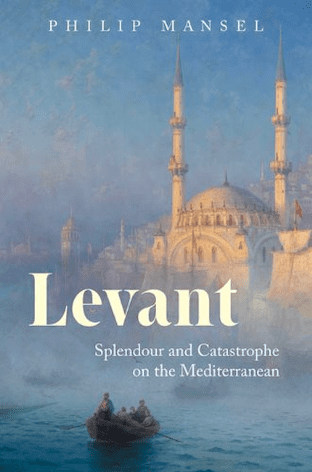
كل الذين كتبوا عن المدن المشرقية – أي مدن شرق المتوسط التي كانت تتّسم سابقًا بمزيج مشوّق من الشعوب واللغات والثقافات – توصّلوا إلى استنتاج مشابه. فقد كانت هذه الأماكن بمعظمها نابضة بالحياة ومزدهرة لأنها كانت مختلطة ومتنوّعة، ولكنها فقدت تلك الخصائص حين حلّت النزعة القومية على المشهد لتفرض هويات أكثر تماثلًا أو غلبةً. ولكن القومية لم تكن دومًا عاملًا مُهلِكًا، وبيروت شاهدة على ذلك. لقد كانت القومية اللبنانية على الدوام مسألة فوضوية بشكل كبير، وربما لهذا السبب تحتفظ المدينة بالكثير من الخصائص التعدّدية التي تمتّعت بها سابقًا خلال ماضيها الذي يُضفى عليه طابع مثالي إلى حدٍّ ما.
تقصّى فيليب مانسيل، في كتابٍ نُشِر في العام 2011 بعنوان Levant: Splendor and Catastrophe on the Mediterranean (ثلاث مدن مشرقية: سواحل البحر الأبيض المتوسط بين التألق والهاوية)، عن ثلاث مدن استفادت من التعايش بين الطوائف، وهي سميرنا، أو إزمير كما تُعرف اليوم؛ والإسكندرية؛ وبيروت. أشار مانسيل متحسّرًا إلى أن جميع هذه المدن فقدت بريقها الكوزموبوليتاني، علمًا بأن الفصل المخصّص لبيروت في كتابه جاء منقوصًا لأنه لم يتطرّق إلى الالتباسات التي لا تزال قائمة فيها حتى اليوم.
اعتبر مانسيل أن جوهر المدن المشرقية كان “تنوّعها ومرونتها”، إذ “أمكنها أن تشكّل ملاذات من سجون القومية والدين”. ولاحظ أن “الناس في هذه المدن الواقعة بين عوالم عدّة، كانوا يبدّلون الهويات بالسهولة نفسها التي ينتقلون فيها من لغة إلى أخرى”. وكان هدفه رؤية ما إذا كانت المدن المشرقية “مدنًا عالمية قبل العولمة”، وما إذا كانت “كوزموبوليتانية بكل ما للكلمة من معنى، وتمتلك إكسير التعايش الذي يتوق إليه العالم بين المسلمين والمسيحيين واليهود”. لقد طرح كتاب مانسيل، على الرغم من التباين الذي يشوبه، جميع الأسئلة المناسبة.
الصعوبة التي واجهها مانسيل هي أنه لم يستطع أن يخفي، عند النظر إلى تاريخ المدن المشرقية الثلاث، أن جزءًا أساسيًا من حمضها النووي تمثَّل في العداوة الطائفية. من الأسباب التي أدّت إلى ازدهار المدن المشرقية أن النظم التي وضعتها الإمبراطورية العثمانية أفسحت المجال أمام التنوّع، وفي نهاية المطاف كانت ثمة سلطة نهائية واحدة فرضت النظام. لقد منح نظام الملّة كل طائفة استقلالًا ذاتيًا واسعًا في إدارة الشؤون الطائفية، وحتى لو واجه العثمانيون أحيانًا صعوبة في فرض سلطتهم، كانوا قادرين على التصرف بقسوة شديدة إذا عقدوا العزم على ذلك، مثلما حدث بعد المجازر بحق المسيحيين في دمشق في العام 1860.
ما هي الرسالة إذًا؟ هل علينا النظر إلى طبيعة المدن المشرقية بأنها مثالٌ أعلى يجدر بنا أن نحاول محاكاته، أم علينا الإقرار بأن ما كان قائمًا آنذاك تحقّق فقط بسبب خصوصيات الحكم العثماني؟ حاولتُ، عند مراجعة كتاب مانسيل، تدوير الزوايا من خلال الإشارة، بطريقة تنطوي على مفارقة نوعًا ما، إلى أن ما منح مدنه الثلاث حيويتها الشديدة ربما هو تحديدًا أنها بدت وكأنها أماكن مستحيلة، تتأرجح باستمرار عند حافّة الهاوية، وأن لعبة التوازن الأزلية هذه كانت بمثابة “مخدِّر متقلّب”.
لكن بعيدًا عن هذه الصورة الحيوية، ثمة فائدة عملية جدًّا من الاطّلاع على ماضي هذه الأماكن، وهي على ارتباط بأوجه قصور القومية في زمن يتطلّب تجاوزها. بعبارة أخرى، لقد اتّسع نطاق المشاكل الإقليمية أو العالمية بحيث لم تعد الديناميات الأنانية والانطوائية التي أطلقتها القومية مناسبة لمعالجتها. وخير مثال على ذلك الأزمات البيئية، إضافةً إلى الهجرة غير الشرعية والنزوح السكاني الضخم والصدمات الاقتصادية العالمية.
لكننا لا نتحدث هنا عن تعدّدية الأطراف، التي تُعدّ إطارًا مشتركًا تتخبّط فيه الدول لمواجهة مشاكلها الكثيرة. والسبب في ذلك هو أن هذه التعدّدية ترتكز بصورة جوهرية على أُسس قومية، لأن الدول تساوم وتتفاوض مع بعضها البعض من منطلق مصالحها الوطنية الخاصة. فعلى سبيل المثال، اصطدم اتفاق باريس بشأن تغيّر المناخ للعام 2015 (بغض النظر عن محاسنه أو نقائصه) الذي سعى إلى خفض انبعاثات الكربون، برفض الكثير من الدول اتّخاذ تدابير من شأنها تقويض نموها الاقتصادي، إذ إن ذلك قد يثير سخطًا شعبيًا أو أسوأ من ذلك.
بل ثمة سؤال أعمق يتمثّل في ما إذا كانت الدولة-الأمة اليوم تواصل أداء الدور الذي من المفترض أن تؤديه. قد يبدو هذا السؤال غريبًا لسكان الدول المتقدمّة، حيث يبقى نظام الدولة الإطار المرجعي للعلاقات الدولية. لكن في أجزاء كبيرة من الشرق الأوسط، وفي مناطق من أفريقيا وآسيا، فإن دولًا متزايدة تشوبها حالة من الاختلال المزمن، هذا عندما لا تكون متداعية بالكامل. وفي أماكن كثيرة، خلّفت الدول فراغات ملأتها قوى غير دولتية أنشأت شبكات من المصالح والجرائم، حارمةً الدول من القدرة على تحقيق أبسط أهدافها حتى.
لذا، يجدر بنا أن نسأل إن كان بإمكان النموذج المشرقي، على الرغم من أنه أفرز بيئات خصبة للهويات المتصارعة، أن يشكّل محطةً للمضي قدمًا نحو سلوكيات مُتجاوِزة للقومية، ولا سيما في أجزاء من الشرق الأوسط؟ بعبارة أخرى، هل بإمكانه أن يقدّم مسارًا نحو التجديد؟ قد يرى البعض في ذلك محاولةً للعودة إلى نزعات كانت سائدة في السابق، على غرار القومية العربية والقومية السورية والشيوعية، ما قد يثير صيحات الاحتجاج، ولا سيما أن الكثير من هذه الإيديولوجيات (ومناصريها) كان توتاليتاريًا في نواياه، وفقد مصداقيته إلى حدٍّ كبير في السياق العربي.
المشكلة أن نظام الدولة-الأمة الإقليمي ليس أفضل حالًا. ففي كلٍّ من سورية ولبنان والعراق واليمن والسودان وليبيا، عمدت أشكال أخرى من الهويات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية إلى الحطّ من قدر القومية وتهميشها، فنجمت عن ذلك كيانات عالقة في مراحل مختلفة من التداعي أو التفكّك. وحدها دول الخليج الغنية بالنفط، إضافةً إلى المغرب ومصر وبدرجة أقل تونس، تشكّل استثناءً في قائمة الانهيار القاتمة هذه.
قد يتساءل المرء: كيف يمكن لدول مُتشرذمة أن تكون قادرة على تبني هياكل حكم أوسع مُتجاوِزة للقومية؟ لا أدّعي أن لديّ إجابة على هذا السؤال. مع ذلك، وفي ظل غياب دول فعّالة، وغياب أي رغبة لدى مجتمعاتها المحلية بالتعايش في الكثير من الأحيان، ينبغي ربما التفكير قريبًا في أُطر مرجعية أخرى في منطقتنا. قد يقتضي ذلك التوجّه نحو كيانات أكبر تجمع بين عدد من الدول القائمة، إذ إن التعاون الأوسع قد يكون السبيل الوحيد أمام السكان للتصدّي إلى التحديات الهائلة التي سيواجهونها لا محالة خلال العقود المقبلة. أو قد يكون أمرًا آخر.
لا تقدّم المدن المشرقية السابقة حلولًا بقدر ما توفّر إمكانيةً لتوجيهنا نحو مسارات انطباعية على نحو مفيد. إذا كانت مجتمعات متنوعة قد تمكّنت من العيش معًا وجني ثمار ذلك طيلة قرون، أليس من المنطقي التفكير في كيانات جديدة قد تستفيد من اختلاطٍ مماثل؟ يروي المؤرّخ مارك مازوير في كتابه بعنوان Salonica, City of Ghosts (سالونيك، مدينة الأشباح)، قصة يهودي من المدينة هاجر إلى فرنسا في العام 1916، ولدى وصوله سُئل عن جنسيته فأجاب قائلًا: “أنا سالونيكي”. من غير الضروري أن تكون الدولة-الأمة هي التركيبة الوحيدة التي يتماثل معها الأشخاص. وتقدّم لنا المدن المشرقية آفاقًا أخرى للتفكير.

