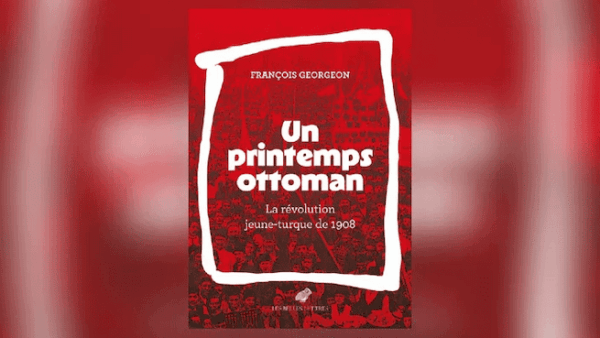ترجمة رؤوف نجم
يروي المؤرخ فرانسوا جورجون سيرة ثورة 1908 العثمانية فيقول انها بدت للحظةٍ بشارة خلاص لكن ما لبثت ان تحوّلت إلى لعنة. ويذكّرنا بأن تحويل مجتمع سُلطوي في الشرق إلى مجتمع ليبرالي، في الأمس او اليوم، ليس سهلا ، بل هو بمثابة مهمة هرقلية شاقة….
هل هي القصة نفسها التي تتكرر في الشرق الأوسط؟ طغاة يبدون ثابتين لا يُزحزحون، ثم فجأة يرحلون بهدوء حاملين بعض الأمتعة. بعد ذلك يكون فراغٌ تملأه فوضى «خلاقة»، ليظهر طاغية جديد يُقفل باب الاضطراب.
ما يجري في إيران يسير تقريبًا على هذا الخط. النهاية لم تُكتب بعد، غير أن سقوط النظام يبدو مسألة وقت: خمسة أيام أو خمس سنوات. أما ما بعد السقوط فغموض كامل… وقد لا يحمل بالضرورة ما هو أفضل، إذا حكمنا بما نعرفه من تاريخ إيران وجوارها القريب والبعيد.
تجارب المنطقة الحديثة لا تبعث على الاطمئنان. في سوريا انتهى الأمر برحيل بشار الأسد بعد اثني عشر عامًا من حرب أهلية وربع مليون قتيل. وفي تونس ومصر وليبيا والجزائر سقط بن علي ومبارك و”المُرشد” القذافي وبوتفليقة بالقتل أو الرحيل. وبين نفحات أمل متقطعة هنا وهناك، تبقى المحصلة قاتمة: تغيّرٌ في الوجوه، واستمرارٌ في الآليات. حتى إن المرء يكاد يتساءل: هل يمتلك المتحفظ المتشائم دائمًا حجة أقوى من الليبرالي الحالم؟ وهل ينبغي تصديق “نظرية المناخ” التي توحي بأن الديمقراطية نباتٌ لا ينمو إلا في الأقاليم المعتدلة؟
يأتي كتاب فرانسوا جورجون كتمرينٍ في الإضاءة الخلفية على هذه الأسئلة. فهو يعود إلى ما يسميه “الربيع العثماني” عام 1908، حين استطاعت نخبة صغيرة من “تركيا الفتاة”، شديدة التأثر بالغرب، أن تفرض إعادة العمل بدستور 1876 الذي بقي حبراً على ورق. لم يحتج الأمر إلى معركة مفتوحة؛ كان يكفي التلويح بتقدّم الجيش الثالث من مقدونيا نحو إسطنبول، حتى تنقلب دولة عاشت ستة قرون من الحكم المطلق، وثلاثة عقود من السلطة الفردية للسلطان عبد الحميد، إلى ملكية دستورية.
اندفع الناس يومها بحماس صاخب. لم تكن عبارة “الوطنية الدستورية” أدق مما كانت عليه في تلك الأيام. في شوارع إسطنبول ومدن عديدة أنشد الناس نشيد الثورة الثورة، “لا مارسييز”. وكأن المثال الفرنسي حاضرٌ في المخيلة العامة. لبرهةٍ قصيرة بدا المجتمع العثماني وكأنه تحرّر من جاذبية الأرض: حرية تعبير، صحافة متدفقة، انتخابات حرة، سجناء يخرجون من الزنازين، وجواسيس الباب العالي ومخبروه يختفون. حتى إن مشاهد المصالحة بدت مبالغًا فيها: اليونان الأرثوذكس والأرمن واليهود والمسلمون يتبادلون القبل، “والجماهير تهتف بشعارات “الحرية والمساواة والأخوّة.

اعتقد قادة تركيا الفتاة، وقد دفعهم ميلٌ علماني واضح، أنهم قادرون على جمع “العناصر المتناثرة” في أمة عثمانية واحدة. هنا بدأ سوء التقدير. كان صهر الجماعات الأرمنية (1،5 مليون نسمة) واليونانية (1،2 مليوناً) واليهودية (250 إلى 400 ألفاً) شبه مستحيل. اليونانيون العثمانيون كانوا ميالين للابتعاد عن المركز، تشدّهم القومية “الأم” القريبة جغرافياً، ويريدون المحافظة على امتيازاتهم الجماعية بدل الذوبان في قومية عثمانية جديدة. أما الأرمن واليهود فبدوا أكثر استعدادًا للمشاركة في اللعبة الجديدة، لكن الأرمن تحديدًا جمعوا بين وزن ديموغرافي معتبر ومكانة اجتماعية رآها كثير من المسلمين أرفع مما ينبغي، فتراكمت حساسيات الدين والطبقة. كانوا مسيحيين، وكثير منهم اتجه إلى الأفكار الاشتراكية، ما زاد الشبهة والعداء.
لم يتأخر الإنذار الأول: في 1909 جاءت مجزرة “أضنة”، القريبة من سوريا، لتكشف اتجاه الريح. ويلمح المؤلف إلى أن الإلهام الفرنسي الذي غذّى خيال قادة “تركيا الفتاة” ربما أوقعهم في مأزق بدل أن يفتح لهم مخرجًا. فقد أعجب قادة الثورة في باريس بالجمهورية اليعقوبية القادرة على تسخير “الأوطان الصغيرة” لصالح “الوطن الكبير”. غير أن مثل هذا التوحيد الصلب لا يصلح لإمبراطورية شديدة التعدد. ومع أول احتكاكٍ بواقع الميدان، كشف “العثمانيون” الجدد عن قومية تركية-إسلامية تضع الآخرين في خانة الأقليات. ثم جاءت الإبادة التي طالت أكثر من 800 ألف أرمني بعد سبع سنوات لتؤكد أن الخطاب المنفتح على التنوع لم يكن متينًا منذ البداية. فالإمبراطوريات قد تتزين بصورة التعدد، لكنها كثيرًا ما تعجز عن إدارة هذا التعدد في العمق.
لم يدم السحر طويلًا. الفوضى الاقتصادية صنعت أزمات وندرة سلع ، والإمبراطورية واصلت التفكك تحت ضغط الأوروبيين. سارعت النمسا إلى وضع يدها على البوسنة والهرسك. وتحت وطأة الخيبات، انفجرت في 1909 ثورة مضادة. لكنها لم تُنقذ السلطان؛ بل إن البرلمان الجديد أبلغه بعزله وألزمه المنفى. وبعد ثلاث سنوات اندفعت “تركيا الفتاة” إلى خيار مصيري: التحالف مع ألمانيا ضد روسيا، العدو التاريخي. كان الرهان أن انتصار ألمانيا سينقذ الإمبراطورية، لكن النتيجة جاءت معاكسة فقد تسارع السقوط، وسقطت معها إمبراطوريات أخرى.
يقول جورجون إن صورة “تركيا الفتاة” انقلبت رأسًا على عقب مع خيار التحالف الألماني، ثم مع انكشاف الإبادة الأرمنية، فانتقل العقد كله – بما فيه ثورة 1908 – من خانة الأمل إلى خانة الفضيحة. وهو يحاول في الوقت نفسه أن يعيد لتلك اللحظة التحررية الأولى جمالها الهش، وأن يوضح كيف تحولت إلى استبداد جديد يستند إلى الجيش.
بعد 1918 أعادت تركيا تشكيل نفسها مع مصطفى كمال، لكن الحكم السلطوي بقي القاعدة، تتخلله انقلابات أعوام 1960 و1971 و1980 و1997. حتى عهد أردوغان، في بدايته، أوحى باستعادة شيء من نفَس 1908: حديث عن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وانفتاح محسوب. ثم تعثرت المغامرة، وتقدّم نموذج “الديمقراطية السلطوية” من جديد. دائرة تعود إلى نقطة البداية.
كان مشروع تركيا الفتاة إنقاذ إمبراطورية وُصفت منذ منتصف القرن التاسع عشر بـ“رجل أوروبا المريض”. إمبراطورية قليلة السكان نسبيًا، لا يزيد عدد سكانها على 26 مليون نسمة، ضعيفة أمام القوى الأوروبية، وخصوصًا روسيا الأكثر كثافة (126 مليون نسمة) وقوة.
ومع ذلك يطرح النص سؤالًا مزعجًا: هل كان إسقاط تلك الإمبراطورية (التي كانت، رغم كل شيء، تضبط السلام في مساحات شاسعة ) قرارًا يفتح بابًا أفضل؟ وإذا أُسقطت… فما البديل؟
انتهت الإمبراطورية في 1918، وبقي السؤال حيًا حتى اليوم. ومن خلال هذا التاريخ المنسي نسبيًا، يذكّرنا الكتاب براهنيّة “المسألة الشرقية”: كانت مشكلة الغرب، وما زالت كذلك.
القوى الغربية تنافست هناك سابقًا، وهي تتنافس اليوم أيضًا، وإن جرى ذلك تحت سقف الهيمنة الأميركية. وفي هذا المشهد لا تبرز ديمقراطية راسخة. الذي تغيّر هو تعريف “أوروبا” نفسها: روسيا كانت يومًا تُعد جزءًا من “الجوقة الأوروبية”، لا سيما بعد ثورة 1905 التي ألهمت تركيا الفتاة، وهي فكرة تبدو غريبة وفق معايير اليوم. أما تركيا فكانت ترى لنفسها مكانًا داخل ذلك الفضاء بحكم ممتلكاتها في البلقان، وثورة 1908 بدت خطوة إضافية في هذا الاتجاه… لكنها ضاعت.
وفي 2026؟ يختم النص بنبرة متشائمة: التحولات المنتظرة في تركيا والدول المجاورة لا توحي بقدوم شيء مختلف جذريًا، بل، بالأحرى، صيغة حديثة أكثر تهذيباً للفكرة القديمة نفسها: “الاستبداد الشرقي” كما تخيله مونتسكيو.