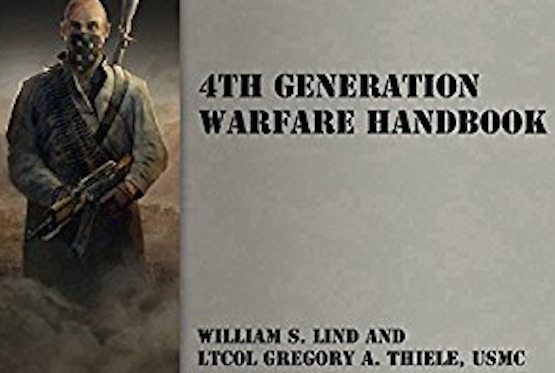يُزّودنا الأدب بمجازات سياسية تُغني عن مرافعات كثيرة. المُحزن أن أغلب المختصّين في علوم السياسة لا يقيمون وزناً للأدب، عموماً، أو يعتبرونه “معرفة” أدنى في سلّم المعرفة. لذا، لن تحظى تحفة من نوع “سيد الذباب” لوليام غولدنغ بمكان ومكانة وسيلة الإيضاح فيما نحن فيه وعليه، وحقيقة أن الاستيهامات الصبيانية تمارس دوراً لا يقل مركزية عن الحسابات العقلانية، التي يفلسفها أشخاص جديون تماماً.
ولذا، أيضاً، لن تكون مدخلاً محتملاً للتفكير في علاقة صنّاع القرار الأميركيين، وفي “العالم الحر”، في اليوم التالي لنهاية الحرب الباردة بعالم أصبح لهم، بعد السقوط المفاجئ لغريم أصبحت قراءة العالم بعد غيابه أكثر صعوبة مما كانت عليه في زمن حضوره. ولا أعتقد أنهم كانوا أوسع خيالاً، وأقل حماقة، من صبيان غولدنغ المحاربين في تلك الجزيرة النائية.
ولعل في اعتقاد كهذا ما يضفي دلالة إضافية على معنى “صدام الحضارات”، الذي لا يتناسى أحد من المُعلّقين ضرورة الكلام عنه للتدليل على سعة اطلاعه، والنيل من هنتنغتون، وفي طليعة هؤلاء عرب غاضبون. ولا يخرج ما يردده هؤلاء، عادة، عن نقد مثقفين لامعين من وزن إدوارد سعيد، وتزفتان تودوروف، للكتاب وصاحبه، بعد تحوير وتدوير النقد، ودون إعادة الفضل لأصحابه.
ولكن ما لا يسترعي النظر يتمثل في أن فرضية الصدام مع “الإسلام”، وآخرين، لم تكن مجرّد رياضة ذهنية في فلسفة السياسة والعلاقات الدولية، بل كانت اختزالاً وترجمة لأفكار، واستيهامات، واحتمالات، تداولها صبيحة اليوم التالي لنهاية الحرب الباردة، أشخاص في مركز صنع القرار، أو أشخاص يؤثرون عليهم كبرنارد لويس، مثلاً.
في مجرد التداول ما يبرر استثناء الرياضة الذهنية أولاً، ويعزز فرضية أن ما يبدأ رياضة في الذهن يتجلى كمشروع على الأرض ثانياً، وأن المشروع، ثالثاً، كما كل مشروع آخر، مفتوح على اللايقين، والتجربة والخطأ، والاستيهامات بما فيها الصبياني والعُصابي. وهذا كله محكوم بحقيقة أن هندسة العالم ليست علماً بل مجرّد اجتهادات تخيب بقدر ما تصيب.
هذا ما كان. وهذا ما يمكن تسميته بلغة مغايرة صعود مدرسة المحافظين الجدد الأميركية. بمعنى آخر “شتيمة” هنتنغتون لا تكفي لوضع “صدام الحضارات” على الرف، ولا تعفي من مسؤولية البحث عن ترجمات محتملة للإصرار على الصدام، وإدارته، من جانب المؤمنين بصحته، أو راكبي موجته.
وفي سياق كهذا، ومع ضرورة اعترافي بعدم الاختصاص في علوم الحرب، وتاريخها، ونظرياتها، إلا أن إطلالة على كتابات مختصين (في الذهن “كرّاسة حروب الجيل الرابع” لوليام ليند وغريغوري تيلي 2016، وكلاهما ضابط رفيع في مشاة البحرية الأميركية) تضفي قدراً من الصدقية على القول إن نظرية حروب الجيل الرابع تبلورت في المقام الأوّل، لقتال وهزيمة كينونة اسمها “بلدان إسلامية”. أضع هذه الكينونة بين مزدوجين لكي لا يسارع المتأسلمون لترديد مقولة مستهلكة، وغير صحيحة، ولكنها ذات طاقة تحريضية عالية، عنوانها حرب الغرب على الإسلام. فمفردة الإسلام، كما مفردة المسلمين، إشكالية في تعددية معانيها.
ولا يكتمل المعنى، هنا، ما لم نتوقف طويلاً أمام كلام منظري هذه الحرب عن كونها تُخاض على جبهات مختلفة لا يمثل ميدان القتال بالبارود جبهتها الرئيسة، ولا بالضرورة أهم جبهاتها. فهناك جبهات اقتصادية، وسياسية، وثقافية، واجتماعية، ونفسية. وعلاوة على هذا كله، لا ترتبط الحرب بمسرح عمليات بعينه، ولا تخضع لتوقيت محدد، ولا تتجلى نتائجها دافعة واحدة، وتُخاض بالتعاون مع “مسلمين”. المفارقة، وهي عنصرية بامتياز، أن مسرح العمليات المثالي في الكتاب المذكور، والذي يُراد له أن يكون رداً على إدارة خاطئة لمسرح العمليات في العراق، يقع في بلاد مُتخيّلة أطلق عليها الكاتبان: دولة “انشالله”. بالمناسبة، ينبغي القول إن مجابهة الإسرائيليين للانتفاضة الثانية كانت تجربتهم الأولى في هذا النوع من الحروب، لا نعرف طبيعة الدروس التي استخلصوها، ومن غير المُرجّح أن تكون قد انتهت، في نظرهم.
مهما يكن من أمر، يمكن العثور على الحاضنة الفكرية والسياسية التي وُلدت فيها نظرية حروب الجيل الرابع، في زمن إدارة كارتر، ومستشاره بريجنسكي، الذي رسم خارطة من آسيا الوسطى إلى الشرق الأوسط، واعتبر الأخير منطقة القلب في “قوس الأزمات”. ولسنا بصدد التذكير بالنفط، والتجارة الدولية، وإسرائيل، في منطقة كهذه، بل القول إن الثورة الإيرانية، معطوفة على زعزعة استقرار الاتحاد السوفياتي، كانت من التوابل الرئيسة في طبخة قوس الأزمات.
أما المُخرجات النهائية، التي تبدلت من حين إلى آخر، ولم تكن، ولا تزال، واضحة المعالم، فخلاصتها تفكيك وبلقنة الشرق الأوسط بالحروب البينية، والأهلية، وإلحاق هزيمة نهائية بالقوميات العربية والتركية والإيرانية، ومَنْ أكثر كفاءة من الإسلاموية المعولمة، بحمولتها الطائفية، وعدائها للقومية؟ صمد الأتراك والإيرانيون، حتى الآن، وسقط العرب.
هذا لا يعني أن أشخاصاً جلسوا ذات يوم، في غرفة مكيّفة، وقالوا سنفعل كذا وكذا، فالتاريخ لا يُفسّر هكذا، بل يعني أن للتصوّرات والاستيهامات، والطموحات، في زمن ما، خاصة إذا راودت أقوياء، حياةً وديناميات مستقلة، يصعب التحكم بها، والسيطرة عليها، ويستحيل في الوقت نفسه استبعادها من كل تحليل محتمل للتحوّلات الكبرى. في سياق كهذا، جاء انخراط القطريين، كمقاول محلي متطوّع، ومموّل ميليشيات متطرفة و”معتدلة”، في مسرح عمليات “انشالله”، بعد السعوديين، ومصر الساداتية والمباركية، وسودان الترابي والبشير. والمفارقة أن هؤلاء كانوا يدافعون عن مصالح واقعية، بصرف النظر عن موقفنا منها، في حين تبدو قطر، التي تريد فقط أن تكون مهمة، وكأنها حصان طروادة الخارج من أساطير الإغريق ليعيد تذكيرنا بوليام غولدنغ، وكوميديا سوداء تسكن في صميم كل تراجيديا إنسانية صافية.
khaderhas1@hotmail.com