إسرائيل بصدد إغلاق “الجزيرة”، وهذه سياسة حمقاء طالما أن فيها ما يجعل القناة المعنية ضحيّة، ويضفي عليها صدقية لا تستحقها. فمن تعاديه إسرائيل تروج بضاعته في سوق الشعبوية العربية. ليس من قبيل المجازفة، طبعاً، القول إن إسرائيل تحاول استرضاء السعوديين، والصيد في ماء عكر بعدما تفاقمت مشكلة قطر مع عرب آخرين. وإذا كان الأمر كذلك، فهذا يعني أن الإسرائيليين أصبحوا أقل ذكاءً، ويجب الترحيب بهم في نادي الشرق الأوسط كأعضاء مؤهلين وطبيعيين. فهذا يفتح طاقة لنا إذا أصبحوا مثلنا.
وإذا لم يكن كذلك، فهذا يعني نقلة إضافية في استراتيجية معقّدة على رقعة شطرنج الشرق الأوسط للحيلولة دون استقراره في وقت قريب، “فالجزيرة” (وكل الظاهرة القطرية) من عوامل الفوضى وخلط الأوراق. وفي الخطوة الإسرائيلية ما يمنحها حقنة مصل في الوريد، وورقة توت إضافية، بعدما شارفت على الإفلاس الأخلاقي والمهني والسياسي.
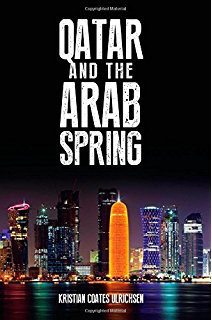
ولكي لا يجهلن أحد على أحد، فلنقل إن الفوضى وخلط الأوراق أبعد بكثير من نقد الأنظمة القائمة، وتمكين المعارضات العربية من إسماع صوتها، بل ما نجم، وينجم، (وراء أقنعة كهذه) عن محاولة حكّام قطر اختطاف الوهابية من السعوديين، وتحويل “الإخوان إلى ميليشيا قطرية عابرة للحدود، وتكريس الإسلاموية بوصفها المرجعية السياسية والأخلاقية والوجودية للعالم العربي.

لم يحدث هذا دفعة واحدة، ولا في سياق استراتيجية واضحة، بل عن طريق التجربة والخطأ، في ظروف مواتية (بدأت مع الهزات الارتدادية لزلزال اجتياح الكويت) لتمكين قطر، في أكثر الاستيهامات طموحاً، من الجلوس على الطاولة مع الكبار، وفي أكثرها جموحاً، من زعامة العالم العربي. وفرضيتي الرئيسة في هذا الشأن أن خصوصية الظاهرة القطرية هي التي أملت الانخراط في استراتيجية تعميم الفوضى، وخلط الأوراق.
المقصود بالخصوصية أننا إزاء دولة لا يزيد عدد مواطنيها الأصليين من الذكور عن 150 ألف نسمة، إذا شطبنا منهم 15 ألفاً من العائلة الحاكمة، ومثلهم 15 ألفاً من العائلات الحليفة بالزواج والمصاهرة والبزنس، وشطبنا منهم 50 ألفاً من الأطفال أقل من 18 عاماً، لا يبقى لدينا سوى قرابة 70 ألف نفر، بما فيهم من تجاوزوا الستين، والمرضى، وأصحاب الاحتياجات الخاصة. وفي الظاهرة القطرية نتوء غريب، إذ تبلغ نسبة الإناث مقارنة بالعدد الإجمالي للذكور أقل من ثلاثين بالمائة.
والمقصود، أيضاً، أننا إزاء ظاهرة دولة/مدينة، الآن وهنا، في القرن الواحد والعشرين، كتلك التي عرفها العالم في قرون مضت، تتمركز فيها الغالبية العظمى من المواطنين والسكّان، بلا طبقات اجتماعية تشكّلت تاريخياً، وبلا فلاّحين وأرياف، وطبقة وسطى، وكل المواطنين من أصول قبلية، كما بنية الحكم، وهذا، في ذاته، يفرض أسئلة على علوم السياسة والاجتماع لم يحاول أحد من الأكاديميين “المحترفين” في الجامعات الأميركية، التي افتتحت فروعاً في الدوحة، حتى مجرّد التفكير فيها.
فالأخ مهران كيرمافا في “قطر دولة صغيرة، سياسة كبيرة” (2015) يجازف بالقول إن المتداول في علوم السياسة عن القوّة الناعمة، والصلبة، لا يقدم إجابات جاهزة بشأن الظاهرة القطرية (أنا أستخدم تعبير الظاهرة لا هو) ويميل في الكلام عنها إلى نحت مصطلح “القوّة الذكية”. المذكور يشتغل في الدوحة وعندها طبعاً. أما الأخ كريستيان أولركسن، الذي يشتغل أيضاً في الدوحة وعندها، فيرى فيها ترجمة بديعة لمفهوم القوّة الناعمة، ويتعامل في “قطر والربيع العربي” (2014) مع أفكار عالم السياسة الأميركي جوزيف ناي بطريقة رياضية تثير حسد أكثر الحواة في عالم أكاديميا للإيجار مهارة. ثمة أسئلة تتعلّق بدلالة الشعب، والسلطة، والسياسة، والمجتمع، في كينونة سمتها الرئيسة الخلل البنيوي، وعبثية الهدف، وتجلياته الدموية على جثث ضحاياه، ولكنها لا تستوقف “الإخوة” الأكاديميين، فمشاغلهم النظرية، على طريقة “المفكر العربي”، أعلى منها بكثير.

على أي حال، في موضوع خصوصية الظاهرة، وفرضية أن الخصوصية هي التي فرضت استراتيجية تعميم الفوضى وخلط الأوراق، فلنقل إن طموح الجلوس على الطاولة مع الكبار، وجنوح الرهان على زعامة العالم العربي، لا يمكن أن يتحققا بسبعين ألف نسمة، حتى وإن عاد زمن المعجزات، أو كان لديك مال قارون. وثمة ما يبرر القول إن الطموح، والجنوح، لم يولدا دفعة واحدة، بل بدأ كلاهما برهانات صغيرة من نوع شراء لاعبين أجانب وتغيير أسماءهم للإيهام أنهم بضاعة محلية، أو تقليب خارطة العالم العربي، وأفريقيا، للبحث عن أطراف متناحرة ورشوتها لتمكين الدوحة من امتياز وفخامة القيام بدور الوسيط.
ومع ذلك، كانت ورقة الإسلام السياسي الأكثر غواية. الإسلام التركي والإيراني وثيق الصلة بتاريخ البلدين، ومسكون بالنزعة القومية الإمبراطورية، لذا لا يمكن اللعب به وعليه، بينما الإسلام السياسي السني “اليتيم” المولود على فراش زواج سابق في السعودية بين الوهابية والإخوان، مرشح طبيعي وجاهز للتبني، خاصة بعدما أغضب موقف الإخوان المسلمين من الاجتياح الصدامي للكويت، وما تلاه، السعوديين.
ولن نفهم غواية التبني بالنسبة للحكّام القطريين ما لم نضع في الاعتبار حقيقة أن هذا الإسلام مسكون بنزعة العداء للقومية العربية، وعابر للحدود، ومعادٍ للدولة الحديثة، وبالتالي لا يحتاج الصاعد على كتفيه إلى طاولة الكبار، أو الساعي للزعامة، مؤهلات تاريخية أو حضارية، أو دولة مركز تتباهى بتاريخها وسكّانها وملوكها على مدار قرون مضت. لذا، أصبحت الإسلاموية بشقيها “المعتدل” والداعشي فرس الرهان.
تلك كانت القفزة الكبرى، وترافقت مع أمرين: ثورة الجماهير، كما عرّفها لوبون، وغاسيت، وكانيتي، ولكن في العالم العربي هذه المرّة، ومع خارطة صدام الحضارات، كما رسمها وعرّفها هنتنغتون. وفي مخاض هذه وتلك ولدت نظريات حروب الجيل الرابع. هذا ما نسعى لتفسيره في مقالة لاحقة، فهناك ما هو أبعد من مشكلة إسرائيل مع “الجزيرة”.
khaderhas1@hotmail.com
- كاتب فلسطيني

